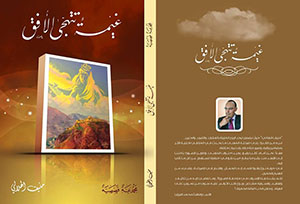- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- بالتزامن مع عودة الحكومة اليمنية.. انفجار يهز جولة السفينة في عدن
- وزراء الحكومة اليمنية يعودون إلى عدن في ظل بيئة أمنية معقدة
- السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
- تهديدات الحوثيين تُعيد البحر الأحمر إلى دائرة الخطر وتُعرقل عودة الملاحة الدولية
- صحيفة: قوات الطوارئ اليمنية تتحرك نحو البيضاء لفك حصار الحوثيين الدامي!
- سامي الهلالي: فهد آل سيف خير خلف لخير سلف.. ونثمّن دعم خالد الفالح لمسيرة الاستثمار والطاقة
- خبراء: المجتمع الدولي يتعامل بمعايير مزدوجة مع الحوثي.. والحل العسكري ضرورة لا مفر منها
- تونس: نشطاء يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح سياسيين معارضين
- بدء تحضيرات فيلم أحمد السقا «مافيا 2»
- «رامز ليفيل الوحش».. أجور خرافية ومخاوف من الإصابات قبل الانطلاق

اليوم حضرتُ أول محاضرة لي في الجامعة. كنت ناجحاً في الاستيعاب إلى درجة أنني فكرتُ بالاكتفاء من الدراسة وانتظار قدوم الامتحان. بدخولي الجامعة، وهو إنجاز بالغ العظمة، أدركتُ أنني صرت إنساناً مختلفاً، فما عدتُ ذلك الفتى الأرعن الفسل، بل صرتُ مثقفاً أنتمي إلى الصفوة. لا أحد يستطيع أن يجادلني في هذا، لأنني سمعتُ من المذياع أن طلاب الجامعة هم المثقفون، وأنا قد صرتُ منهم بفضل الله.
وما كان ينقصني للشعور بأنني “مثقف” إلا ثلاثة أمور: إرجاع شعري للخلف، نظارة طبية، قراءة الصحف. الأمر الأول أنجزته بسهولة إلى حد ما وأنا أتطلع في مرآة بحجم ظفر الإبهام. والأمر الثاني تدبرته باستعارة نظارة ذات عوينات عادية شفافة، الذي يراها يحسبها نظارة طبية وهي ليست كذلك، ولكنها تمنحني مظهر الأستاذ. ولكي أحصل على لقب “مثقف” بين أقراني كان عليّ تأبط جريدة ما عند ذهابي للجامعة. لقد شاهدتُ الكثير من الأفلام السينمائية، ولاحظتُ – وأنا ثاقب الملاحظة كما تعرفون- أن البطل الشرير لا يقرأ الجرائد، بينما البطل الخرير يحرص على قراءتها.
في كل بلدان العالم المتحضر تجد المرء يستيقظ صباحاً ليبدأ يومه بلعن الإمساك الذي يعاني منه، وقراءة صحيفته المفضلة مع كوب من الشاي أو القهوة. وبما أنني متحضر بطريقة تثير الإعجاب ومولع بتقليد نمط الحياة الراقي إلى درجة الهوس، فقد فكرتُ أن أبدأ كل يوم من حياتي بقراءة جريدتي المفضلة في غرفة نومي. ولكن وصول موزع الصحف إلى داري متعسر، لأنني أعيش في حارة أزقتها ضيقة وملتوية كمصارين البقرة، ويحتاج الأمر من موزع الصحف أن يقفز من طائرة مستعيناً بمظلة ليهبط على السطح المتداعي ومن ثم يناولني الجريدة! كما أن أقرب كشك للصحف يقع على مسافة خمسة كيلومترات من بيتي. لذلك رضختُ للأمر الواقع، وقررتُ التخلي عن طموحي في تثقيف نفسي على الطريقة البرجوازية. جانب آخر مهم في الموضوع هو أنني عندما أقرأ الجريدة في البيت أكون قد استوعبتُ ما فيها، وبالتالي عند ذهابي للجامعة أستطيع أن أتفاخر على زملائي بمعرفتي لآخر الأخبار. لو كنتُ أستطيع ارتداء بذل لائقة لما ركزتُ كثيراً على تكوين انطباع لدى الآخرين بأنني مثقف، إذا كنتم تفهمون قصدي.. فمن خلال تجربتي المتواضعة اكتشفت أن هذه الحيلة نافعة. لأنني عندما أتأبط جريدة فإن الطالبات والطلاب لا يُركزون على ملابسي المُشتراة من الحراج، ولا على حذائي المتصدع، ولكنهم يركزون أنظارهم على الجريدة التي أحملها.
كنت أقرأ جريدتي المفضلة في فناء الجامعة المشجر بعشب ميت وأشجار ذاوية. وأختار مقعداً خالياً في الزاوية الأقرب للبوابة، وأضع رجلاً على رجل، وأفرد الجريدة وقد بلغ بي الزهو عنان السماء. صدقوا أو لا تصدقوا، لقد كنت الوحيد تقريباً الذي يظهر قارئاً للصحف في الجامعة. وهكذا نلتُ لقب “المثقف” بيسر من الكافة، ولم يسع أحد لمنازعتي على هذا اللقب.
هذا الامتياز منحني شعوراً بالتفوق على الآخرين، وأنني أعلى منهم ثقافياً. عندما كنت أقلب صفحات الجريدة وتصدر عن الورق تلك الخشخشة اللطيفة وألاحظ الأحداق التي تكاد تلتهمني، أبدو في نظر نفسي علاّمة، الرجل الذي يشي بأنه سيكون مفكراً في المستقبل. حينئذ لم أكن أهتم بما أقرؤه، بل بالأثر الذي أتركه في النفوس، ونفوس الفتيات تحديداً.
في العام التالي كان عليّ أن أضيف انحناءة معقولة لظهري، لأبدو أكثر شبهاً بالمفكرين. صحيح أنني رسبت في أربع مواد واضطررت إلى إعادة السنة، ولكن هذه الكبوة لم تؤثر على سمعتي كمثقف عتيد.
حاولت الحفاظ على خصوصيتي إثناء قراءتي لجريدتي المفضلة ولكن الأمور لم تسر على ما يرام.. لأنني ما إن أجلس في ركني الشهير حتى تتلبّث خلفي طوابير من طالبات وطلاب الجامعة، وكلهم يسعى إلى التلصص عليّ ونهب ما تطاله أبصارهم من المعلومات والأخبار والقصص والأشعار التي تحفل بها جريدتي المفضلة. تفاقم الأمر، وتزايدت حدة الاضطرابات، وحوادث التحرش، فهب جنود الحرس الجامعي لإنقاذ الموقف، ومنع الاختلاط، ونظموا نوبات للقراء المتزاحمين خلفي، فكان هناك طابور نسائي ثم طابور رجالي بالتناوب، حرصاً على الآداب العامة. إلا أن الجو سرعان ما تلوث برائحة الفساد، وراح الجنود يستلمون الرشاوى خلسة من الطالبات والطلاب للسماح لهم بالاقتراب أكثر من قفاي لقراءة جريدتي المفضلة. بائع بطيخ اتخذ موقعه قريباً مني وحقق أرباحاً ضخمة، ولم أستطع طرده بعيداً رغم انزعاجي من رداءة صوته عندما يُروج لبطيخاته، وتضرري من عصير البطيخ الذي كان يسيل من بين أصابع الطلاب والطالبات على ياقة قميصي وسترتي. وبعد مدة بسيطة افترشت الأرض بمحاذاتي شحاذة عجوز، ثم تلاها نشال عمره سبع سنوات، ومخمور حليق الحواجب يعمل في الأمن السري، وزمّار أعور، وفرقة مطبلين سود البشرة، واختصاصية اجتماعية تكتب بحثاً عن التجمعات الحضرية، ثم دون أن أنتبه صرت مركزاً لسوق بيع وشراء الكتب المستعملة، وأتى الطلاب القدامى إلى زاويتي التي أقرأ فيها جريدتي المفضلة لبيع كتبهم الخالية من الكتابة للطلاب الجدد الذين يفكرون منذ الآن في التقاعد المبكر من الوظائف التي سيشغلونها مستقبلاً.
شيء سخيف أن أضطر إلى تفويت محاضراتي بسبب تنامي شعبيتي كمرجع للجامعة كلها، إلا أن هذا هو ما حدث فعلاً.. فكلما أردت الذهاب إلى هذه القاعة أو تلك أجد العشرات يستوقفونني لطرح الأسئلة عليّ، أحدهم مثلاً يسألني عن نتيجة مباراة في كرة القدم، وآخر عن كاريكاتير الصفحة الأخيرة وهل يقصد الرسام وزير الزواحف أو يقصدني أو يقصد أمه؟! وأخرى تطلب مني أن أقرأ لها حظها، وهي التي كانت تنطحني في صدري لتذكرني ببرجها، فكنت أغيظها وأقول لها إن الفلكيين الأنذال قد تخلصوا من الثور وجلبوا حراثة عتيقة مصنوعة من النكات البذيئة! طالبة ثانية أزعجتني بسؤالها عن بختها وهي من برج العذراء، ثم تبين أنها لا صلة لها إطلاقاً بهذا البرج العفيف.. وقد كلفني الأمر مجهوداً شاقاً لا يلائم أمثالي من برج الجدي!
حتى مالك البوفيه كان يعترض طريقي كلما لقيني متوسلاً أن أهبه الجريدة بعد أن أفرغ من قراءتها ليلف بها الشطائر، لأن العميد يؤنبه على وضع الشطائر في يد الطلاب والطالبات هكذا رأساً دون أن يغلفها بشيء.
أسوأ من قابلتهم أولئك الذين يطلبون مني أن أعطيهم مزقاً من جريدتي المفضلة ليجلسوا عليها. بمرور السنوات كان عدد الكراسي يتناقص، وعدد الطلاب يتزايد، فصارت الحاجة ماسة لجريدتي المفضلة لأغراض غير لائقة! لم أكن سعيداً بهذا الدور الوطني الحافل بالأمجاد في رعاية العلم الذي تقوم به جريدتي المفضلة، لأن حماية مؤخرات الطالبات والطلاب من التراب ليس من واجبي، بل هو من واجب الدولة.
ومع كل هذه المشاق التي أواجهها، لم أعدم أيضاً السرقة بالإكراه لجريدتي المفضلة من قِبَلِ أساتذة الجامعة الذين يتأبطونها بدلال العجائز المتصابيات، ثم يهدونها لأجمل طالبة يصادفونها، مرددين اللازمة السمجة ذاتها مع كل واحدة: “في بلادنا لا أحد يزرع الورود، ولم يكن من المعقول أن أقطف لكِ الحشائش، فمعاذ الله أن تكوني أتاناً، لذلك أهديكِ هذه الجريدة بدلاً عن الورود”.
بدأت صحتي في الانحطاط، بسبب إفراطي في الانبساط، فبجانب الشابة المسترجلة من برج الحراثة التي حدثتكم عنها، كانت لي خليلات أخريات، كلهن استلقين على فراشي بحجة قراءة جريدتي المفضلة! شخصياً اختلطت عليّ أسماؤهن من كثرتهن، فكنت أفهرسهن من خلال الأبواب التي يطلبنها من جريدتي المفضلة. فهناك فتاة “طبق اليوم” الغنية الشهية التي التهمتها في المقعد الخلفي لسيارتها المهيبة. وسيدة “درجة الحرارة” السمراء الحلوة التي تسأل عن درجة الحرارة في مدينة مأرب حيث يعمل زوجها الذي يعاني من حساسية مفرطة تجاه الأشياء الساخنة! وأما أشدهن شبقاً فهي آنسة “حدث في مثل هذا اليوم” وهي بالفعل لم تكن تفوت يوماً واحداً!
هربت إلى الأسطح لقراءة جريدتي المفضلة، فإذا بهذا الجيش من قطاع الطرق والعاهرات يتبعني كظلي، ويُسوّد عيشتي. ثم اكتشفتُ قبواً مهجوراً يقع تحت مبنى كلية التجارة بالأعضاء، فرحت أتردد عليه خلسة، وأتحرى أن لا يتبعني أحد عند دخولي إليه. لكن استمتاعي بقراءة جريدتي المفضلة في الساعات المبكرة من الصباح لم يدم طويلاً، إذ أن دخولي وخروجي من ذلك القبو متنكراً في أزياء غريبة وتلفتي يميناً ويساراً كهارب من العدالة قد أثار ريبة المخبرين، فأبلغوا عني السلطات، وتم إلقاء القبض عليّ متلبساً بقراءة جريدتي المفضلة وحيداً.
قال لي ضابط الأمن ذو الثلاثة أرجل وسبع خصيات مُلوحاً بالجريدة في وجهي: “ما هذا يا عدو الشعب؟! تقرأ الجريدة لوحدك يا حقير!”.
أحيلت قضيتي لخطورتها على أمن الوطن إلى وزير الداخلية شخصياً، ونشرت الصحف – بما فيها جريدتي المفضلة- أخبار وتفاصيل التحقيق معي في الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها، باعتبارها فضيحة أخلاقية لم يسبق لها مثيل. ثم سارت المظاهرات الاحتجاجية التي تندد بأنانيتي ولؤمي، وأحرقتْ دمية ترمز لشخصي في أحد الميادين العامة.
صدر ضدي حكم بالسجن المؤبد بتهمة “احتكار الثقافة والمنع المتعمد لوصولها إلى المستهلكين مع سبق الإصرار والترصد”. وعندما نطق القاضي بالحكم سجدتُ لله شكراً، لأن المحكمة لم ترضخ للضغوط الشعبية التي كانت تطالب بإعدامي. علمتُ وأنا وراء جدران السجن، أن مجلس الوزراء قد استغلني في المحافل الدولية، لطلب المزيد من القروض والمساعدات، مُدللاً بقضيتي على النقص الفادح في الورق الذي تعاني منه البلاد.
نظرتُ إلى وجهي في مرآة صغيرة بحجم ظفر الإبهام، وتيقنتُ أنني كنت ضحية لمؤامرة لا تخطر ببال الشيطان، وقلت مواسياً نفسي: “اللعنة! حتى الحكومة كانت تبحث عن مكاسب دنيئة من وراء ظهري وأنا أقرأ جريدتي المفضلة”.
منقولة من مجلة قريش...
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر