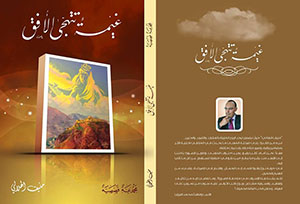- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
الثلاثاء 17 فبراير 2026 آخر تحديث: الاثنين 16 فبراير 2026

- بالتزامن مع عودة الحكومة اليمنية.. انفجار يهز جولة السفينة في عدن
- وزراء الحكومة اليمنية يعودون إلى عدن في ظل بيئة أمنية معقدة
- السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
- تهديدات الحوثيين تُعيد البحر الأحمر إلى دائرة الخطر وتُعرقل عودة الملاحة الدولية
- صحيفة: قوات الطوارئ اليمنية تتحرك نحو البيضاء لفك حصار الحوثيين الدامي!
- سامي الهلالي: فهد آل سيف خير خلف لخير سلف.. ونثمّن دعم خالد الفالح لمسيرة الاستثمار والطاقة
- خبراء: المجتمع الدولي يتعامل بمعايير مزدوجة مع الحوثي.. والحل العسكري ضرورة لا مفر منها
- تونس: نشطاء يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح سياسيين معارضين
- بدء تحضيرات فيلم أحمد السقا «مافيا 2»
- «رامز ليفيل الوحش».. أجور خرافية ومخاوف من الإصابات قبل الانطلاق
قصة قصيرة
حديث الفُستق - أحمد السري

2019/11/26
الساعة 11:21
(الرأي برس (خاص) - أدب وثقافة)
لا أحد يذكر اللقب الذي خرج به من بيت أبيه، صار اسمه الأيوبي، حسن الأيوبي، هكذا كانوا ينادونه، وقد أهملوا لقبه الأصلي ونسوه تماما. ولم يأبه لهذا أبداً، بل واصل زفيره وتأوهه وإطلاق عبارته الشهيرة " ياصبر أيوب" "ياصبر أيوب" . ومنها اشتق المحيطون به لقب الأيوبي ليشير إلى عذاباته، وإلى ما يزال يعانيه إلى اليوم. شاب دمث الأخلاق، محب لعمله حبا جما، كان يعمل فَرَّاشا في دار الضيافة الملحق بكلية التربية في " المحويت" . بعد الظهر يقضيه الأيوبي في الديوان الكبير ببيت الضيافة ماضغاً للقات، أو معدا للشاي وملبيا لطلبات الحضور بمودة وسرور مشرقين.
كنت قد سمعت طرفاً من صفات الأيوبي ومفاكهاته من صديقي الدكتور (رأفت زيدان) القادم من أرض الكنانة، الذي اعتاد السفر إلى هذه الكلية منذ أكثر من سنتين، وتمكن من الولوج إلى قلب الأيوبي ، تلك الضفة الرائعة المنسية من ناس هذا الزمان كما وصف.
حين وصلت أول مرة إلى الكلية، وكان ذلك بعد حرب الوحدة الأخيرة في اليمن صيف 94، ألفيت الفتى حسن الأيوبي يشتم الحرب وآفاتها ويحصي أنواعا من الخراب والدمار بتأوه وزفير، ويصرخ "ياصبر أيوب"، وبدا كما لو أنه اكتشف فجأة آفات الحرب، ويريد أن يحذر العالم أجمع منها، لكي لا تكون هناك حرب أخرى على الإطلاق.
انتزع الفتى الأيوبي مني إعجابا صرَّحت به، لكن بسمة صديقي الغامزة حيرتني، ثم دنا ليهمس في أذني : "لا تتعجل الإعجاب ، المسألة غير ما اعتقدت تماما، وقد تضحك أو تحزن إن استمعت إلى القصة".
خرجت بعدئذ مع رأفت زيدان إلى المساحة القريبة من الدار، ليسمعني قصة هذا الفتى. قال رأفت زيدان : إن حرب الوحدة الأخيرة قتلت فيما قتلت قصة حب منكسرة بين الفتى حسن الأيوبي وأمريكية كانت تدرس اللغة الإنجليزية في الكلية اسمها هايدى. عليَّ أن أذكر أن تلك الليلة وحدها لم تكف لسماع كل القصة، فقد كنا نقاطع أنفسنا بالتعليق والتحليل ونجد فيما نقول ونستعرض غراما، جعلنا نعيد ونكرر سماع أحداثها. كنا كذلك نضحك أحيانا ونحن نستمع إلى القصة، وهو ضحك يشير إلى غرورنا غير المعلن، ذلك الغرور الذي يلهمنا الحكم بالمعايير المنطقية، مع علمنا أن أجمل ما في قصص الحب هو غياب المنطق واندحار الحسابات العقلية القاسية. سأشكر لكم مقدما حسن المتابعة حتى وإن لم تجدوا في هذه القصة ما وجدت أنا من غرابة لذيذة دفعتني إلى تسجيلها.
قال رأفت زيدان: إن الأمريكية هايدي اتسمت باللطف والمودة مع كل من تقابل، وأبدت اهتماما بتعلم العربية. كانت تأتي إلى دار الضيافة حيث يقوم الأيوبي باستقبالها، فيقدم لها الماء والشاي، ويهيئ لها مكانا لتستريح فيه حتى يأتي موعد محاضرتها القادمة، تماما كما يفعل مع باقي المدرسين، وإن خصّها بشيء من الاعتناء. كانت تقيم في المدينة في حي شعبي أحبته، وأقامت صلاتٍ طيبةٍ مع كل نساء المدينة تقريبا.
كانت هايدي تلاطف الأيوبي وتجد في نظراته ونبرات صوته وفي ضحكه براءة نقيه لم تعد تألفها في بلادها كما ذكرت. وقد تفردت بمظهرها الأنيق وسلوكها المحتشم جداً، وهي فوق ذلك جميلة على نحو هادئ، يثير التوقير والغبطة، أكثر من الرغبة والاشتهاء. كانت تكرر دائما أنها مخطوبة وأنها ستتزوج بعد عام. لكن هذا الإعلان - وقد فهم أنه تكتيكي فقط، وأثرٌ من تحذيرات أهل الخبرة قبلها- لم يمنع من اشتعال الهوى في محاريب أفئدة كثيرة في هذه المدينة المعلقة بتوحد بين السحاب.
لندع الجانب الجدي في صلات الأمريكية بغيرها من زملائها، ولنركز حديثنا على الأيوبي الذي كان قانعا ببسماتها البريئة وملاطفاتها المُسَلِّية ، حتى أوحى إليه أحد جلسائه بأن الأمريكية تحبه، وبأن الأدب وإكرام الضيف يقتضيان مبادلتها الحب بالحب، وقيل له إن عليه أن يظهر لها ذلك، مثلما تفعل هي وإلا فما معنى لطفها وبسماتها وثيابها الأنيقة .
والأيوبي آتٍ من ثقافة لا تعرف للحب تقاليد وطقوس سوى الإعلان عن الرغبة في الزواج، أما قصص الحب وتعرجاتها الجميلة، فللكتاب ومخرجي الأفلام السينمائيه، ولأهل أوربا بوجه خاص. الحق أن هذه الأفكار كانت تتولد أثناء الحديث كتعليقات شارحة وتعبر عن موقفنا نحن الاثنين الراوي والمستمع من تلك العلاقة الغريبة والمنكسرة بين الأيوبي والأمريكية هايدى .
بعد أن عبثت فكرة الحب برأسه، شرع الأيوبي يفقد قليلا من براءة سلوكه التقليدي وأخذ يبالغ في إكرام ضيفته ، فيطيل بسمته قليلا لتصبح عند نهايتها بلهاء، ويأتي لها بأكواب الشاي دون أن تطلب.
وعندما أخذ الحب - موقدا من نار الغيرة والحزن- يكبر في ضلوع الأيوبي، وبدأ يغمه بصورة واضحة، أخذ الإشفاق عليه يعلن عن نفسه في عبارات النُصّاح، وكنت ـ يقول الراوي ـ أشفق عليه بصورة خاصة لأنه كان قد اتخذني نَجِيَّا. وكنت أنا أقف على تطورات الأسبوع كاملة بمجرد وصولي إلى دار الضيافة.
كم رغبت -يقول الراوي- أن أقول له إن عليه أن يدرك أنه لن يكون في أية لحظة حبيبها، " ولست وحدك تحب"، وآية ذلك أن الأيوبي لم يكمل حتى الإعدادية، وقدرته على القراءة والكتابة بالعربية محدودة جدا. صحيح أن عشرته مع أساتذة العلم قد هذبته بصورة واضحة، وظهر أكثر اهتماما بمظهره، وأخذ يستخدم ألفاظا جديدة، و يجيد تقليد ما يستحسن من عبارات، ويطلب أن يكتب له هذا البيت أو ذاك من الشعر الغزلي. وصحيح أنه قد تأثر بمحيط عمله إلى درجة أنه أخذ يعلق على الأفكار والآراء المتنوعة، يستحسن هذه الفكرة وصاحبها، ويستهجن تلك، لكن الأمر مع ذلك لم يكن ليجاوز أثر السماع والمشاركة، ولم يُلْحظ عليه أنه يعاني هما فكريا حقيقيا من أي نوع. أمَّا في وقت حزنه أو غضبه فيخرج كلاماً فيه من الفلسفة والحكمة ما يدهش، وهو كلام يخصه وحده وله رائحة الأيوبي وذوقه. وكانت طبيعته الأولى الهادئة والأثيرة تعود إليه كلما ابتعد موضوع الحديث عن العلم والشرع والشعر، فيعود للضحك وللرقص وللسفر البعيد عبر وريقات القات التي لا تنضب عنده .
لم يجد رأفت زيدان مدخلاً مناسباً لإفهامه صعوبة الحصول على هايدي، وأخذ يشفق على مشاعره من آفات الحب، خاصة وأن الأيوبي - بمصطلحات هذا الزمان- يفعل كل شيء بتطرف، وهو الآن يحب بتطرف ولا يسمح لأية فكرة بأن تخدش عليه صفاء اندفاعه إلى رحاب الحب. ورغم كل هذا التطرف، كان الواقع العملي يكشف عن شخص مؤدب خجول عند لقائه بها، فيقول كلاماً عادياً، ويعتقد أنه قد باح بالأسرار، فيخجل من ذلك، كأن يقول مثلا: "تفضلي، إجلسي هنا، فأنت منهكة، سآتيك بالشاي حالاً". وفيما هي تكبر هذا الأدب الجميل من رجل تعتقد أنه يقوم بواجبه خير قيام، يعتقد الأيوبي أنه قد نثر نصف مكنون قلبه، فيداري وجهه بيديه، ويلتفت يمنة ويسرة، تماما كما تفعل الصبايا العاشقات عند سماع أول اعتراف بحبهن.
وقد كشف الأيوبي لمستشاره رأفت زيدان ذات مساء رغبته في إهدائها شيئا ما، وأنه بهذه الهدية يريد أن يصرح نهائيا بعواطفه تجاهها. قاطعه رأفت زيدان، وهو يسرف في تصور المشهد الآتي عند تسليم الهدية، قاطعه قائلا : "وافرض يا أيوبي أنها بادلتك الهوى.. وأنها وافقت على الزواج منك، ماذا ستفعل ؟" فانبهر الأيوبي من السؤال، لا بل إنه استنكره بشدة، فهذه العيون التي جحظت، والأفكار المتسائلة التي تسلقت قسمات وجهه، تعبر عن استنكاره للسؤال. ولم تطل الحيرة، يقول رأفت زيدان، إذ أجاب بعد فاصل قصير من الصمت: "سأتزوجها .. نعم سأتزوجها، ولم كل هذا الحب إذن إن لم يكن من اجل الزواج"؟
الآن جاء دوري أنا لاندهش يقول الراوي، ولعله رأى في وجهي ما رأيت أنا في وجهه قبل قليل.
لم أستطع مع ذلك إلا طرح السؤال المتعلق بحاجز اللغة وكيفية التفاهم. ازدادت دهشتي عندما جاء جوابه جاهزا، ليشير إلى أنه قد فكر في هذه المسألة، قال : "إنها تتعلم العربية وتحرز تقدما". ولم أطرح بقية التساؤلات الأخرى فربما كان قد فكر بكل شيء، ونحن ـ استسلاما لمشاعرنا المتكبرة ـ نعتقد أن تلقائيته وبراءته وقلة حظه من العلم، يمنعه من التفكير المنظم المتصل بالأسباب والنتائج.
لم أجد بعد هذا بدا من مناقشة موضوع الهدية معه، وفيما نحن ننتقل من خيار لآخر، قلت له : "الأوروبيون والأمريكيون يقبلون هدايا بسيطة ومتواضعة ، المهم في الهدية أن تكون مغلفة تغليفا جميلا وبورق أنيق يدل على ذوق المهدي، وأن هذه الشكلية الخارجية تحدث أثرا أجمل بكثيرمن الهدية نفسها". لم يهتم الأيوبي بهذه المعلومة، فالتغليف أمر لا يخطر له على بال، المهم ما هي الهدية يا صاحبي وكفى. قلت له: "الورود يا أيوبي ، الورود هي أفصح تصريح عن الحب ، وهو أمر متعارف عليه دوليا ، فاهد لها وروداً تعرف فوراً ما تريد". لكن الأيوبي رفض الفكرة وأشار إلى أنه لا يعرف الورود، ولم يسمع هذه المفردة في حياته، ثم قال: "وما معنى أن تهدي وروداً تذبل كما تقول بعد قليل ، لا، لا، شيئا آخر غير الورود".
استقر الرأي بعد طول بحث أن يقدم لها كيلوغراما من الفستق، وكان هذا اقتراح الأيوبي نفسه، وقد دافع عنه وأصر عليه حتى النهاية ، قال: " إنه هو شخصيا لم يأكل فستقا في حياته، بل إنه ما رآه عيانا قط ، إلاّ في التلفزيون، في المسلسلات أو الإعلانات، وهو معجب بالاسم "فستق" وبشكله"، ثم أضاف في نهاية الحديث إنه أيضا سمع من فلان، وسماه باسمه، أنه كان وقت فراغه يخرج مع خطيبته فيمران على عطارة ويشتريان الفستق الإيراني، فيأكلانه وهما يتمشيان في الشارع، أو جالسان على أريكة في حديقة عامة، أوعلى الجسور المعلقة فوق نهر النيل بالقاهرة".
يدرك رأفت زيدان أنه قد استقر في وجدان الأيوبي أن الفستق سفير حميم بين القلوب، وأنه لهذا أصر على أن تكون الهدية فستقاً، وكلف رأفت زيدان بإحضار الكيلوغرام منه من صنعاء، وعليه أن يختار النوع الجيد لتهنأ به الحبيبة، ويقر به قلب العاشق.
وتم له ما أراد، ففي الأسبوع التالي أُتي بالفستق، مغَلَّفا بورق هدايا جميل، لكن الأيوبي مزق الغلاف ساعة تسلمه للفستق ورماه في سلة المهملات، وأخذ يتفحص الفستق ويقول:" هذا هو الفستق إذن، هذه أول مرة أرى فيها الفستق أمامي".
جاءته هايدي في اليوم التالي على عادتها، وبعد أن قدم لها الماء والشاي وحادثها قليلا وحادثته باليوميات المألوفة عن اللغة الإنجليزية والعربية وجمال المدينة المتزايد بسقوط الأمطار، همت بالانصراف فوقفت، فاستوقفها الأيوبي بأدب رقيق للحظه، ودخل المطبخ وأخرج من درج في الدولاب الهدية الأثيرة، وجاء بها حاملا إياها على راحتي كفيه، ورافعا إياها حتى قرب ذقن الحبيبة. نظرت هايدي إليه دهشة وضاحكة ، ثم أرجعت إليه البصر كَرَّتَيْن، وأدركت أنه لا بد من أخذ الهدية. وحتى هذه اللحظه لم تشأ هايدي أن تفهم شيئا أكثر من المودة والأدب. التقطت الهدية بيد وأخفتها في حقيبتها، ثم أمسكت بكفيها ساعدي الأيوبي وضمتهما لبعضهما وهي تقول: "شكرا.. شكرا حسن..". وقد وصف الأيوبي بعدئذ هذه اللحظة بكثير من الخيال والنشوة، وهو يكاد في كل مرة يكون ثملاً من الذكرى، ورأى أنها كانت تود أن تضمه إلى صدرها، وأن تقبله، لكن يديها ارتختا عن ساعديه، فاستأذنته شاكرة إياه وانصرفت.
كانت حالة الإشفاق قد وصلت بصديقنا الراوي درجة مؤثرة، فهذا الفتى الذي يبني لنفسه أحلاما من الوهم، يجهل ثقافة هؤلاء القوم، ولايدري أن الاحتضان أو حتى قبلة الجبين والوجنات، تشبه بشكل ما مصافحة الأيدي عندنا، وأنها تعبير عن الشكر والامتنان، لا عن الحب والهوى. لكن صديقنا الراوي كان يضطر لمجاراته، وبالأخص حين يصف الفستق الذي كان يتمنى لو ذاق القليل منه ليعرف سره.
شاعت همسا قصة الإهداء، وقصة الضم للساعدين، وتضخمت عشرات المرات، فتجاوزت الضم إلى العناق والتقبيل، وإلى كشف للعورات، ووصف لكل ما يثير ويغري. كانت تلك المبالغات مطراً يسقط على أخيلة قاحلة فتتعهدها بالنماء والإنعاش، لتتحول إلى شاهد إثبات على بؤس الحال في الواقع والخيال معا. ولبعض الأيام كان تداول حكاية الإهداء والضم يريح الأيوبي كثيراً، فهو يريد على نحو ما أن تبلغ مسامع الزميل الفلسطيني، الذي يستأثر بمعظم وقت فراغها، يريد أن يريه أنه بلا لغة ولا هندام، بلا حذلقة ولا التواءات، قد تمكن حتى الآن من أن يحظى ولو بنصف ضمة قد تكتمل في الإهداء القادم.
ولم يدر الأيوبي يقيناً إن كان المنافس العربي قد علم بالأمر أم لا، لكنه ذات يوم رأى هايدي تخرج من جيبها حبات فستق وتهبهن لزميلها الفلسطيني، المنافس اللدود للأيوبي، فأخذ في مخبئه البعيد يزفر وينفخ ويعبث بشعر رأسه، وهو يرى فستقه يهدى للمنافس اللدود. وبعد قليل اندفع إلى الساحة هائماً، وهو يريد أن ينكشف لها بكل مصابه. وفي التفاتة من هايدي لمحته وحيته بابتسامة رآها أجمل وأنقى من كل ما شاهد حتى الأن. أشاعت هذه البسمة في روحه سكينة أعادت إلى شَعرِه انتظامه، وإلى لُهاثه الهدوء، وعزَّى نفسه بيقين: "لو كانت تبادله مشاعر من أي نوع لما جرأت على تحيتي بمثل ذلك الحبور أمام غريمه" .
والواقع إن هذا الذي حدث اليوم، كان يحدث غالبا،ً قبل أن تعربد جمرة الحب في فؤاد الأيوبي وتحرق سكينته المألوفة. هذا الحادث الذي فُهِم من الأيوبي ومن مجلس مستشاريه الذين كانوا يشاركونه تحليل ما يحدث، بأن هايدي قد أسلمت قلبها للأيوبي، فهي مغرمة بالبساطة والبراءة كمعظم الأوربيين والأمريكيين الذين فقدوا تلك المزايا. أما ما يربط بينها وبين الفلسطيني فزمالة فقط، تلعب فيها اللغة دوراً أساسياً. ولعل مأساة فلسطين هو موضوع الحوار أصلا، لتكون رسولا لفلسطين عند أهلها حين تعود.
وقد نُسي هذا الحادث بعدئذ وكأن لم يكن، لقد ذكر فقط في سياق المقارنة بينه وبين حادث آخر، لا يزال الأيوبي يتوجع له إلى اليوم، وتثور فيه في اللحظة ذاتها، مشاعر جامحة لرغبة إنتقام مقهورة. يظهر ذلك من نفخه في فمه ليحدث تلك النغمات الراقصة، فيمتشق جنبيته ( خنجره) ويرقص برشاقة بديعة، موشاة بجد مهيب، يصيرها رقصة للانتقام والموت. ثم يتوقف، ويحدق بعيون تنز شرراً ، ثم يرفع خنجره استعداداً للطعن......، لطعن ميمون الأزرق اللعين . آه.. لو كان الأزرق هنا لمزقته إربا، وسيأتي يوم لا ريب أنتقم فيه لكل لحظات الإذلال التي أشربني إياها الخبيث ميمون الأزرق، ونافسني فيها حب هايدي.
ميمون الأزرق هذا كان صاحب علاقات عامة، وله نفوذ مكشوف ومعترف به من كثيرين، لم يكن له عمل محدد، لكنه يتصرف بوعي لمركزه الاجتماعي، في بيئة دُرِّبت على القهر والخضوع، ويستطيع إصدار أوامر من أي مكان يتواجد فيه. وقد سرت شائعات كثيرة عن محاولاته المتكررة كسب ود هايدي دون فائدة، لاسيما عندما كان يوصلها بسيارته ويمر بها على " شرفة الريادي"، لتطل من هناك على بديع صنع الله في الجبال والهضاب والوديان المبسوطة في كل اتجاه. كما أن بعض العجب كان يطفو فوق تلك الشائعات عندما يتصل الحديث بسبحة الأزرق الأنيقة التي لا تفارق يده، أو عندما يُسمع أن الأزرق صعد المنبر خطيباً في الجمعة الفائتة أو أقام حلقة وعظ ليلية في المسجد.
بعد أن وصل الأزرق همس الفستق ومبالغات الضم والتقبيل، صمم أن ينال من هايدي ثأرا لكرامته المهانة، إذ لا يعقل أن يكون وهو من هو مرفوضاً، وتفضل عليه هذه الغربية الأنيقة رجلا من "غوغاء الناس وأسافلهم". والأزرق هو الآخر لم يهده التفكير إلى أكثر من الفستق طريقا يجلب به ود هايدي، ولعله بهذا الاختيار أراد الإلماح إلى ما وقع قبلا، فيكون الطريق إلى المراد أقصر.
وتشاء الصدف أن يرى الأيوبي الأزرقَ نازلا من السيارة وبيده علبة أنيقة شفافة تكشف ما بداخلها، لقد كان فستق منضدٌ بطريقة جميلة، وتتخلل حباته ورود حمراء، ورأى الأيوبي كذلك، كيف أخفى الأزرق هذه العلبة تحت معطفه، وكيف ذهب إلى حيث تجلس هايدي هناك، على أريكة حجرية، تحدق في جمال جبال "حُفاش" البعيدة، المغشية بالتدريج بالضباب الصاعد من الأعماق. رأى الأيوبي، كيف أدى الأزرق التحية محنيا هامته، ومبتسما بخبث مفضوح، لا بل إنه ـ كما قال ـ سمع فحيح بسمته كأفعىً بري.
يا الله كيف يخلق الأيوبي هذه التعابير حين يدهمه الغيض! لم يسمع محاورتهما، لكنه رآها تبتسم وتهز رأسها موافقة، ورآها تعيد خصلات شعرها المتدلية على وجهها إلى الخلف، فيظهر جمالها فاتنا بلا حدود، ومحرضا على الإثم، وقد حملها الخيالُ، كلمسة فنٍ أخيرة، إلى تلك الذُّرى المقابلة التي ستغيبها بعد برهة سحائب الوادي السحيق.
صمم الأيوبي على معرفة سر الموافقة تلك، وحاذر أن يصادف الأزرق في الطريق، لكي يتجنب أوامر فجائيه أو يتعرض لتهزئة مكشوفة أمامها. لم يكن الأيوبي يجرؤ على مقاومة الأزرق، كان خوفه منه كان واضحاً جداً، وهو دليل اضطهاد سابق طويل، يجاهد الأيوبي منذ فترة للبرء منه لكنه يتمهل ويحذر.
مضت ساعة من الزمان، كان الأزرق أثناءها يطوف بين مكاتب الكلية، وهايدي في فصلها، وقد لاحظ الأيوبي بعد ذلك أن أحد الموظفين وثيق الصلة بالأزرق، ترك مكتبه وترك فيه الأزرق الذي أغلقه من الداخل، ورأى الذين أتوا إلى لمكتب يعودون بعد محاولة فتح الباب والدخول دون جدوى.
كان الوقت ظهرا، حرارة الشمس تفرش لهيبها وتلفح الوجوه، ومعظم الطلاب قد غادروا ساحة الكلية. بعد قليل رأى الأيوبي من مكمنه هايدي تخرج باتجاه المكتب الذي يبعد قليلا عن قاعات الدرس، وقريبا من دار الضيافة، ثم لا حظ كيف أن باب المكتب هذه المرة انفتح بمجرد تحريك مقبض القفل إلى أسفل والدفع إلى الداخل، ثم انغلق الباب ثانية. وخيل للأيوبي أنه سمع طرقة إحكام الإغلاق من الداخل، فانقبض بشدة وعصفت بأحشائه براكين الغيرة والحقد هذه المرة. أطرق صامتا يفكر ونفسه تحدثه بالذهاب إلى المكتب متظاهرا بحاجته لشيء ما، لا بل يذهب إلى هناك ويدفع الباب بقوة وينهال على الأزرق ضربا ولكما. لكن شيئا من هذا لم يحدث. كانت تلك توثبات أحلام يقظه، تكشف رغبته الدفينه في التحرر من ذل الاعتقاد بواجب الاحترام والخضوع للأزرق وأمثاله. بعد ربع الساعة تقريبا، سمع طرقة الباب وانفتاحه بغضب ظاهر، ورآها تخرج عابسة الوجه، الوجه الذي يمكن أن يقرأ فيه كل شيء من خلجات فؤادها، وها هي الآن غضبى حزينة ومكدرة، حتى أن مشيتها فقدت دلالها، وهاهي تخطو كالرجال خطوات واسعة قوية وسريعة باتجاه الطريق الرئيسي حيث تمر كل يوم في طريقها إلى البيت.
قدر الأيوبي ما حدث بالداخل، واطمأن إلى موقفها الرافض لمحاولة الأزرق الدنيئة، ولعله الآن في الداخل يأكل الفستق وحيداً، ويلعن الدنيا الغرور التي أنسته وعظه وتقواه. بعد عشر دقائق أخرى خرج الأزرق وأغلق المكتب وراءه ومضى. كان الإنكسار وكثير من الغم يغشيان هامته، لكنه غادر الكلية بهدوء، وقد اطمأن إلى خلو المكان من الطلاب، أما العمال فهم رهن بنانه ولا يؤبه لهم.
الأيوبي الذي كان يتنفس الصعداء لنتائج اللقاء، أخذ يوجس خيفة من الآتي ، فالأزرق سيبدأ الآن عقابا قاسيا، إنه لا يسامح أبدا، وسيصب نار وعظه على بنات أوروبا هذه الليلة، وعلى الأمريكيات بوجه خاص، ومن يدري فلعله يذكرها بالاسم في بيت الله وسَيُذَكِّر كالعادة بكل أدب رفيع هو منه براء.
في تلك الليلة لم ينم الأيوبي، كما أن مقيله قد شط بعيدا في سماوات الحلم والخلاص، فرأى نفسه ماسحا لدموع لم تنزل في خدود هايدي، ورأى نفسه متحدثا الإنجليزية بطلاقة يعتذر عن خلق الأزرق، وأن الناس هنا أسوياء ومؤدبون ومؤمنون بالله بصدق وأن الشاذ لا حكم له. رأى نفسه يدافع عن الإسلام ويبرئه من كل سلوك شائن حقير، وابتسم وهو يصل في اعتذاره إلى القول: " إن هناك نوعا من البشر يتعايشون ببداهة مذهلة مع ادعاءاتهم الفاضلة وسلوكهم الشائن، والأزرق زعيم هذا النوع على الإطلاق ".
غابت هايدي عن الكلية ثلاثة أيام، تركت فيها الأيوبي، وربما آخرين بمن فيهم زميلها الفلسطيني، في تساؤل مضنٍ، وقلق صامت جليل، ترى أين هي ؟ ولئن كان الأيوبي قد قدَّر سبب الغياب، إلا أنه مع ذلك يتحرق شوقا للقياها، إذ بغيابها فقد كل شيء طعمه ورائحته، إعداد الشاي ، طهي الطعام، تنظيف الدار، حتى الاستمتاع بالقات لم يعد الذي يعرفه. وقد أكد للأيوبي مجلس مستشاريه أنها إن جاءت غدا وأظهرت لوعة ولهفة، فذلك يقينك النهائي بأنها تحبك أنت وحدك. والأيوبي لم يرو لأحد ما رأى، وأنَّى له أن يفعل ذلك، فهو يخشى أن يعرف كمصدر للخبر ويخاف من عقاب الأزرق الذي لا يرحم.
جاءت هايدي في اليوم الرابع، أتت كما كانت تأتي كل يوم ، فلا لهفة لهذا ولا شوق لذاك ، بل التحية والسلام وبمألوف العادة في الدرس والراحة. عندما أتت لتشرب شايا عند الأيوبي لم تظهر لهفة ولا لوعة، بل بشاشة وجه وأدب كسالف الأيام.
تذكر الأيوبي قول مستشاريه فانكسرت فرحته قليلا، لكنه تناسى الأمر بالسؤال المرح المشتاق عن غيابها وسببه؟ فذكرت له بنبرة عادية مذهلة، كما قال الأيوبي، أنها كانت متوعكة فقط، فدعى لها بالسلامة. وبعد أن جلست وشربت الشاي المُنكَّه بورق النعناع المنعش، ارتخت أساريرها بالأمان والسعادة، ونظرت إلى الأيوبي قائلة : "حسن.. أنت رجل طيب" ( الكلام يدور بعربية مكسرة وإشارات كالعاده)، فخجل من هذا الإطراء الذي لم يكن يتوقعه، وهم بسؤالها عما حدث في المكتب، فارتد في اللحظة الأخيرة، وبدل السؤال برد متأخر بعض الشيء .. "وأنت كذلك .. امرأة طيبة". وانبهر من نفسه وهو يتذكر لأول مرة من خارج السور القصار المقروءات في الصلاة قوله تعالى: " الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيباتُ للطيبين والطيبون للطيبات"، ودون منا سبة، وجد نفسه يقول لها: " إن الإسلام ...... (جيد)"، وقد قالها بضم أصابع الكف ورفع السبابة إلى أعلى مع حركة الكف كله إلى الأسفل. ولعله بهذا التعليق الفجائي، قد أيقظ لديها شكا بعلمه بما حدث، ورأت أنه ربما أراد اختبار مشاعرها، لكنها لم تتجاوب مع شكها، بل أظهرت بدلا من ذلك احترامها للأيوبي، وحاولت إفهامه أنها ترى فيه شابا دمث الأخلاق، وأنها ربما احترمته بصدق في ذاتها، لكنها ـ وهي تتذكر ثانية مدحه للإسلام ـ لا ترى أنه في وضع يمكنه من مناقشة قضايا مجردة تتعلق بجمال الإسلام أو بأية مواضيع أخرى، فإلى جانب عائق اللغة، فإنها بلا شك قد أدركت أنه قليل الزاد من المعرفة المقروءة. ومع ذلك فقد اشتاقت لأن تقول ما تحس به وتود إعلانه بحرية وتلقائية، وهو أمر ممكن أمام شخص كالأيوبي لن يدخلها في جدل عقيم تجنبته حتى اليوم .
ابتسمت في وجه الأيوبي وقالت ما معناه: " أنت يا أيوبي تجعل الإسلام جميلا، إن الإسلام يتجمل بك وبخلقك وأنا لا اعرف منه إلا تجلياته فيكم، ولا دخل لي بالباقي، لقد قيل لي في أمريكا الكثير عن الإسلام معظمه سيئ ، لكني ولحسن عشرة الناس لي نسيت كل شيء وأنا أشاهدكم بشرا وسلوكا، أنا مسيحية، ولي أيضا خلق وآداب". وكانت عند هذه النقطة ـ يقول الراوي ـ قد جمدت ابتسامتها، وطافت فوق وجهها مسحة حزن وقورة، زادتها سحرا وفتنة.
ومما يدل على أن هايدي قد اعتبرت حادثة المكتب حادثا عارضا، عدم انتشار شائعة من أي نوع حول الموضوع، ولعلها قالت ذلك للأزرق وهي تغادر المكتب، فالأزرق لم يظهر قلقا، ولا مضطربا، لكنه منذ ذلك اليوم أخذ يعاملها بجد مخلوط بمشاعر غريبة، هي مزيج من انهزام وحقد. فلم يعد يوصلها بسيارته ولا حاول استرضاءها بجميل السلوك، بل أخذ وبهدوء خبيث يجاهد ضد ما اعتبره حملة صليبية من طراز فريد . وجد الأزرق في جهاز الهاتف أقصر طريق لإيذائها، والانتقام لكرامته (المهانة). لقد تعودت هايدي أن تتلقى مكالمات هاتفيه من أمريكا، فتدعى إلى مكتب سكرتارية العميد وهناك تسمع أخبار أهلها وتُسْمِعهم أخبارها. كانت هذه المكالمات تؤنسها وهي المنقطعة بين جمال الطبيعة ووحشة الاغتراب، وتهبها طاقة جديدة وتمنح روحها سلاما وسكينة، شأن كل بعيد يتعهده أهلوه وأحباؤه بالتذكر والحنين.
استطاع ميمون الأزرق أن يقنع موظف السكرتارية بإنكار وجودها في الكلية عند حصول اتصال من أمريكا ، وقد جرى كلام كثير حول سر استجابة الموظف لطلب الأزرق، ليس أقله أن الأزرق استخدم سلطته الخفية ومكانته الاجتماعية البارزة، بل إن البعض اكتشف فجأة قرابة أسريه بين عامل السكرتارية والأزرق. وأيا كان الأمر ترغيبا أو ترهيبا، فان الذي حدث فعلا، وشوهد من الجميع هو تواجد ميمون الأزرق لساعات طوالا في مكتب عامل السكرتارية وخاصة في الأيام التي يتوقع فيها عامل السكرتارية اتصالا هاتفيا من أمريكا. أخذ الموظف ينكر وجودها في الكلية، في كل مرة يتم فيها الاتصال بها من أمريكا. كانت تأتي وتسأل قلقة عن المكالمات فتجاب بنظرات الاستخفاف وقلة الاحترام، وبان أحدا لم يتصل بها، فاضطرت هي أن تتصل من مبنى البريد والاتصالات، لتعلم أنهم في أمريكا قد استبد بهم القلق من أجلها، وأنهم قد حاولوا مرات عدة وعند من تعرف في صنعاء أيضا. ففهمت الأمر خاصة وأنها تتذكر أنها في كل مرة ذهبت فيه إلى مكتب السكرتارية، كان الأزرق يجلس هناك، وغلبتها طبيعتها الهادئة والمؤدبة فلم تصرخ ولم تستنكر. كان الأيوبي قد لاحظ تصرفات الأزرق، لكنه لم يجرؤ على تبليغها بالأمر خيفة أن يُظَن به فيؤذى؟
وقد سعد جدا عندما علم منها أنها أدركت الأمر، إذ جاءته ذات صباح لتأخذ منه رقم هاتف دار الضيافة، وقالت للأيوبي إنها ستتلقى من الآن فصاعدا مكالماتها الهاتفية عنده، في أوقات فراغها، وهي الأوقات التي كانت فيها هايدي تأتي إلى دار الضيافة لتستريح وتشرب الشاي وحيدة تارة وأخرى مع بقية المدرسين.
أخذت المكالمات تصل إليها هناك، ولم يكن ميمون الأزرق قد علم باكتشافها الأمر، وإن حيَّره انعدام الهواتف من أمريكا في المكتب حيث يقيم. لم يكن يشك بذهابها إلى استراحة دار الضيافة، فهذا سلوك يومي مألوف منها ومن باقي المدرسين، لكنه ذات يوم رآها وهو يتمشى في الفناء القريب من دار الضيافة تتحدث في الهاتف، فأدرك أن لعبته قد انكشفت، وأن لا مجال لتمثيل دور البراءة بعد الآن، فانفجر الغضب في أعماقه، ونادى الأيوبي بعصبية واضحة النبرات. ولما مثل الأيوبي بين يديه قال له الأزرق: "إن كنت تريد أن تستمر في عملك هذا فعليك تنفيذ ما آمرك به". ارتعد الأيوبي من تلك النبرة التي يعرف أبعادها ، وأعلن عن استعداده لتنفيذ ما يطلب منه. ويروي الأيوبي بعد ذلك : "في ثانية واحدة دارت بخلدي مئات المطالب ولم أتوقع أن يأمرني بما أمر، لقد أمرني أن أذهب توا إلى الاستراحة وانزع قابس الهاتف لتنقطع المكالمة".
لم تتوفر للأيوبي شجاعة العشاق ليراجع هذا الأمر، بل صمت ووقف برهة كالمشلول، فهو يعرف نغمة الحقد التي يطلقها الأزرق الآن، وأنه حتما سوف ينفذ وعيده لو لم يفعل.. صاح به الأزرق ثانية.. "اذهب الآن أمامي وإلا أذهبت عقلك".
ووجد الأيوبي نفسه ذليلا صاغرا لا سلطان لعشقه على هذا الجبار البشري. هبط الدرج المؤدي إلى مدخل الاستراحة ورأى سرورها الكبير وهي تتحدث، فالتفت ثانية إلى الأزرق ورأى الإشارة بالتنفيذ، فدخل إلى حيث تجلس وأقترب ببطء من القابس، متمنيا من الله بكل إخلاص وتضرع وابتهال أن تنهي المكالمة قبل نزع القابس. وانتظر لحظة وهو يقترب من القابس أكثر، فرأى الأزرق من النافذة يهدد بالإشارة ويتوعد.
مد يده أخيرا إلى القابس وهي تنظر إليه فزعةً، فانقطعت المكالمة... بُهتت هايدي مما رأت، وامتلأ وجهها بذهول حول قلب الأيوبي إلى مزق وأشلاء. رآها تنظر بسرعة إلى الخارج، فلا ترى أحدا هناك، وتعيد النظر إلى الأيوبي بالذهول العظيم ذاته. فقد الأيوبي القدرة على الكلام ، أصابه بكم وهو ينسل خارجا إلى المطبخ، وهناك انفجر باكيا، شفقة على نفسه وعلى مشاعره المداسة. واسى نفسه وسط الدموع بنجوى خاصة عن الانتقام وتمنى يقظة وحش كاسر في داخله ليدمر ويدمر، اقترب بحذر من باب الاستراحة، فرآها تبكي هي الأخرى بنشيج خفيض حزين، كان رأسها ملقى بين كفيها المسنودتين من ركبتيها ، وبين الفينة والأخرى تمسح دمعها الغزير بمناديل وردية، وقد ألقت منها كومة بارزة أمامها. إنسل الأيوبي الذي لم يجرؤ على البوح باسم آمره وذهب بعيدا.. بعيدا.. يهيم على وجهه ليشهد الجبال ، الأشجار والأحجار، الحصى والصبية والأغنام، على عجزه وجبنه، ويشتكي قلة حيلته في مواجهة الجبار البشري ميمون الأزرق. فهو لا يريد أن يطرد من الكلية لأنها كل دنياه المتواضعة، أما بيت والديه فقد جرَّعه طفلا وصبيا ألوانا من المرارات ، وهو لا يُستقبل هناك إلا ضيفا لإفراغ ما لديه من مال، أما الحياة العادية كباقي الناس، فلم يعرفها أبدا في بيت أبيه، الذي سحق طفولته وصباه وشبابه بالضرب المبرح والشتم المقذع والحط الدائم من قدره وقدرته.
عاد الأيوبي مساء ذلك اليوم، وقد أفرغ شحنات بؤسه في أعمال عبثية ضد الطبيعة الصامتة الصبورة، وقد رويت أخبار كثيرة حول تجواله الشرود بعد ظهر ذلك اليوم تكفي لملء صفحات. من تلك الروايات ، أنه وقف أمام صخرة ملساء ثم أخذ يلتقط أحجارا مختلفة الأحجام ويرمي بها بقوة عجيبة سطح الصخرة الأملس حتى شوهه. وقالوا كذلك إنهم رأوه يمسك بصخرة كبيره ويتمكن ، رغم ثقلها الواضح من رفعها في الهواء ثم يتقدم إلى طرف هاوية، فيرمي الصخرة من الشاهق وهو يصاحب الارتطام المهشم للصخرة بقهقهات عالية، فيكرر ذلك مراراً لتتحد قهقهاته مع الرجع الصادر من الكهوف والوديان، ثم يهدأ قليلاً ويبتسم، ثم يبتسم ويبتسم. عاد مساء ذلك اليوم غيرمنهك ولا حزين، بدا جميلا... جميلا جدا يقول الرواة، ولو أن هايدي تراه الآن لشغفت به حبا، وهي ترى أيوبيا آخر بروح وثابة ناطقة على محياه. هاهي أيضا ملامح جرأة جديدة يظهر بها الأيوبي، ويطلق بلهجة حازمة أيمانا مغلظة ليخبرنها غدا بكل شيء.. من حادثة المكتب حتى نزع قابس الهاتف، وأنه بعدها سيواجه الأزرق، وهو الآن على استعداد أن يكون شهيداً للحب، إنه يبدو حقا مستعدا لمواجهة الأزرق وتحديه، إذ بأي ذنب تستحق هذه الفتاة كل هذه القسوة والطغيان.
غدا، غدا وليس بعد غد، سأخبرها بكل شيء لأريح واستريح، غدا هو يوم المواجهة، نعم لا بد من المواجهة. لم يشك أحدٌ من جلسائه ومستشاريه السابقين أن الأيوبي الآن في حالة جد لم يعهدوها فيه ، وأنهم حتى لا يجرؤون على نصحه بأي شيء، بل اخذوا يستمعون لترديداته غدا.. غدا ..غدا .
غير أن قروح قلب الأيوبي لا تزال إلى اليوم نازفةً مُدْمَاة، لأن الغد الذي انتظره لم يأت أبدا. فقد انفجرت حرب الوحدة اليمنية في تلك الليلة، وغادرت هايدي المدينة صباحا إلى صنعاء، ومن هناك مع باقي الأمريكيين حُمِلت إلى بلادها، دون أن تسمع الحقيقة من الأيوبي، ودون أن يتمكن من تبرئة نفسه أمامها. لقد تركته وحيدا يسامر ذهولها العظيم لحظة نزع القابس، ويعصره الألم كلما تصورها تتذكر تلك اللحظة.
ووفاءً لذكراها ومداراة لآلامه، يحتفظ الأيوبي في دولابه إلى اليوم بما وجد من بقايا في شقتها بالمدينة.. قطعة صابون ، وفرشاة أسنان، ...وحبات فـــســــتـــق.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
أدب وثقافة
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
اختيارات القراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر