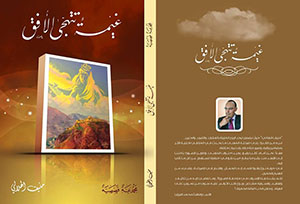- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

حين كتب محمد علي لقمان روايته «سعيد» في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، أرادها أن تكون خطاباً روائياً مواز لخطابه التنويري في كتابه «بماذا تقدم الغربيون» سؤال في النهضة، صاغه في كثير من كتاباته، ثم صاغه في شكل روائي، ذلك أن الرواية أكثر الفنون الأدبية تعبيراً عن المجتمعات.
تحدث عن عدن في بدايات القرن وعشرينياته، عن واقع المدينة وأهلها وشبابها، واتخذ شاباً عدنياً من الطبقة المتوسطة اسمه «سعيد» مسباراً لوصف ذلك الواقع الغارق في مظاهر التخلف، فأطلق رسالته المبكرة، وهو يرى الشباب قد انصرف عن المشاركة الحقيقية في شؤون الحياة، فيما الأجانب الذين جاء بهم المستعمر البريطاني يحوزون كل شي. كان لقمان معلماً بكل معنى الكلمة، يرى الناس تسير نحو عنق الزجاجة، ولن يخرجهم منها إلا التعليم والوعي بالواقع، والعمل على تغييره. حاول أن يلامس أسماعهم بكل الأشكال والصيغ المتاحة، «لا يصلح الأبناء إلا المدارس الراقية والأساتذة المثقفون والبيئة الصالحة والرفاق الطيبون، والمحيط الطاهر من أردان الفساد الخلقي. أما إذا كانت المدارس متأخرة والمعلمون أغبياء والمحيط فاسد، فلا غرابة أن يضرب الجهل أطنابه على ربوع البلاد، فإن الأمهات الجاهلات طالما أفسدن أبناءهن بالحنان الزائد والنقود الكثيرة وستر فضائحهم. حتى أننا لنرى الجهل قد عم شره واستفحل بين ظهرانينا أمره، لما وجد المرعى خصيبا، فأين تركات الآباء، وأين الثروات والغنى، ونحن لا نشاهد إلا تدهوراً في الأخلاق ومروقا عن الدين وبيعاً للذمم والضمائر. مات الوجدان وضعف الإيمان والشباب منصرف عن أبواب الخير مقبلاً على الرذائل، وقد انتقلت التجارة والجاه والشرف من العرب والمسلمين، سكان البلاد، إلى غيرهم من الشعوب الأجنبية التي أصبحت تتحكم في مصائرنا، ونحن لا نفكر حتى في تعليم أبنائنا بعض الصنائع أو الحرف اليدوية. وهكذا أصبحنا ونحن لا ديناً ولا آخرة تؤمل...». وكأن لقمان يُشخِّص مشكلاتنا إلى يومنا هذا... منذ أكثر من قرن من الزمان في المكان نفسه.
محنة المواطن المنفي
وعبَّر الطيب أرسلان في الأربعينيات في «يوميات مبرشت» عن محنة المواطن المنفي عن المشاركة الحقيقية في مدينته، والتي تحولت للجاليات الأجنبية التي جاء بها المستعمر البريطاني، ليصنع منها أنموذجاً مدينياً تعددياً، لكن هذا النموذج الذي يحلو للكثير الحديث عنه اليوم، وربما بالكثير من الحنين إليه، لم يكن طوباوياً، فالمحنة الاقتصادية والفقر أضرت بسكان المدينة الأصليين، ودفعت بهم إلى البطالة.
يكتب الطيب أرسلان عن الموظفين المقهورين من أبناء المدينة الواقعة تحت الاستبعاد الاقتصادي، وما أصابها عقب الحرب العالمية الثانية من أزمة اقتصادية طاحنة، دفعت ببعض الموظفين إلى العمل في التهريب لتأمين احتياجاتهم المادية. وصف واقعاً اجتماعياً واقتصادياً يُرى فيه الأجانب يمارسون النشاطات التجارية، في حين كان أهالي المدينة يعانون من البطالة أو الاكتفاء بالوظائف الحكومية التي لا تؤمن لأسرهم احتياجاتهم المادية، كالراوي الذي لجأ إلى الاشتغال بتهريب البضائع والمخاطرة بحياته حتى يتسنى له مواجهة متطلبات المعيشة. «...لأني وطني والوطني دائماً مغضوب عليه وغير محظوظ! فإن توظف عاش فقيراً منكوداً غريباً في وطنه يتمنى لو كان أجنبياً فيعيش ناعماً لم يبقِ لنا شئ، فالوظائف العالية للأجنبي، والتجارة الواسعة كذلك. خذي رئيسي: أتى من بلاده البعيدة لا يستر جسمه سوى بدلة مهلهلة، ولا تعرف بطنه سوى الطعام البسيط، فأصبح بين عشية وضحاها يلبس أحسن الثياب ويأكل أطيب الطعام، وهو فوق هذا وذاك يشغل مركزاً ممتازاً ذا نفوذ واسع، وكل ما يملك من المؤهلات هو … شخصيته الأجنبية! وهذا آخر أتى من بلد آخر وليس معه شئ، فتلقفته عدن كغيره ممن قذفت بهم بلادهم، فوجد فيها النعيم الذي لم يحلم به، ولم يمض عليه زمن يسير حتى أصبح سيتاً أو خواجة، يطلب الحصص Quotas فيُعطى، لأن من حقه كأجنبي أن يتحصل على الامتياز! أما أنا... أنا ابن الوطن فلا شيء من كل هذا… لماذا؟ لأني Native (محلي/ابن البلد) أعز الله السامعين».
عدن النبوءة
لقمان وأرسلان من أبناء عدن، وكانا يرويان عن وقائع المدينة من داخلها، من عمقها الاجتماعي وأدق تفاصيلها الحياتية الواقعية اليومية، لم تكن عدن ـ وقئذ ـ غير عنق زجاجة، ولحظة حرجة في تحولات المكان، ونبوءة سردية مفتوحة على المزيد من مروي الألم والمحنة... وسينقطع خيط المروي المديني بعد لقمان وأرسلان إلى مرحلة الرواية والواقعية، في مطلع السبعينيات، وحينئذ ستروى من خارجها، بعيني عامل قروي يفد إليها طلبا للرزق أو سائح مغامر أو مهاجر لحظة مرور عابرة، والمدينة هنا لم تكن غير المستعمرة في ظل الاحتلال البريطاني، تشد هذا العابر مظاهرها المدينية والعمرانية، حيث الخواجة الأجنبي والميناء الذي يعج بالبواخر الإنجليزية والإيطالية، التي يأمل المهاجرون ركوبها لتحملهم بعيداً عن قراهم وواقعهم البائس، ولأن المدينة عدن ظلت في منظور الشخصية القروية القادمة إليها من الريف، عتبة للمرور والاتصال بالعالم الخارجي، فقد ظلت علاقة الشخصية بها في إطار الفضاءات الهامشية، المقهى، الفندق الشعبي أو بيوت البغاء، الساحات والمعامل... مثل محمد عبدالولي في «صنعاء مدينة مفتوحة»، ومحمد حنيبر في «قرية البتول»، وعلي محمد زيد في «زهرة البن»، ومحمد عبدالوكيل جازم في «نهايات قمحية»، ومعظم الروايات اليمنية المكتوب أكثرها شمالاً.
سيتصل بعدئذ خيط السرد الداخلي للمدينة في نهاية التسعينيات عند كتاب من أهل شعابها، مثل سعيد عولقي في «السمار الثلاثة»، الذي سيقف بالسرد من منظور ثلاث شخصيات مدينية، هم (صحافي ومسرحي وموسيقي)، ترصد الأزمة التي عاشتها عدن في ظل الأجواء القمعية الكابوسية التي تلت أحداث يناير 1986، «كان غول الماضي المفزع وإرهابه وأهواله المرعبة قد تجسدت في مخيلتهم كمنظر بانورامي مجسم تحت الأضواء الكاشفة... وكانت غرف الموت ووسائل التعذيب موزعة على الأركان والزوايا وطوابير الأبرياء تنتظر مصيرها المجهول، كان الموت السريع وسط ذلك البلاء الرهيب أمنية عسيرة المنال…».
مدينة يسكنها الخوف
لم تكن المدينة التي في «عنق زجاجة» أخرى إلا مدينة محاصرة يسكنها الخوف والألم «قابعة وسط سلسلة من الجبال العالية الجرداء»، وقد أدارت ظهرها للبحر وأفقه المفتوح، ولم يجد الكُتَّاب فيها غير الإنكفاء على أنفسهم في جلسات معزولة، فقد «كان النادي هو الملجأ والملاذ يلوذ به أعضاؤه ورواده من عناء العمل، ومتاعب الحياة ومصاعب العيش... وخلال السويعات التي كانوا يقضونها بداخله كانوا ينسون اللعنة التي حلت بهم، وينسون أن الربيع لا يأتي مدينتهم وأن المطر لا يروي حقول قراهم... وأن البن لا يباع في مقاهيهم... وأن الحرمان لا يبارح ديارهم... وأن الرحمة لا تعرف طريقها إلى قلوب حكامهم».
وسيكشف حبيب سروري في «الملكة المغدروة» إلى «حفيد سندباد»، عن واقع عدن السبيعينية من الداخل، في لحظة ولادة النظام الثوري الماركسي في جنوب اليمن، وترصد التحولات التي تشهدها المدينة، من خلال عينَي شاب تفتح على الحياة لكنه بات محاصراً في مدينته، في أكبر أحياء المدينة، حي الشيخ عثمان، ليمارس هوايته في لعبة الذكاء على رقعة شطرنج، بعيداً عن ذلك الحزن المقيم من حوله، «من يعرف الشيخ عثمان يعرف تماماً أن الحزن يعيش فيها مسروراً بين أهله وذويه، في معقله المثالي، في مسقطه العمودي على كوكبنا، وسيستنتج من ذلك أنه إذا كان للحزن شكل هندسي فإنه سيكون مستطيلاً تماماً… إن الحزن والشيخ عثمان يشكلان ثنائياً مثالياً مختوماً إلى الأبد بحب عميق مستطيل…».
هذا الحي هو عتبة اتصال عدن بباقي مناطق الجنوب واليمن، حيث الأفواج الكبيرة من أبناء القرى تأتي إليها مع ولادة النظام السياسي الجديد، وكيف كانت تعج المدينة بهم وبالمسيرات والمليشيات والهتافات المؤيدة للخط السياسي الجديد، وكيف كان يستولي على هؤلاء «حالة من الهستيريا والفرح الثوري» تصل إلى حد المطالبة بتخفيض الرواتب. هي لحظة تاريخية مفارقة في تاريخ اليمن الحديث شهدتها السبعينيات، عندما أخرج الموظفون للمطالبة بخفض رواتبهم دعماً وحفاظاً على الدولة الناشئة، وعبر سلسلة من المشاهد الحافلة بالمفارقات بين المتظاهرين ومسيراتهم التي تطوف الشوارع، وتقلق هدوء المدينة وحيها الكبير، وصورة شباب المدينة المنهمك في ممارسة الألعاب والجلوس في المقاهي غير مكترث بما يجري حوله من تحولات، وهو بذلك إنما يرصد تاريخاً حافلاً وحاسماً من تاريخ المدينة، «عبث ينخر المدينة ويجوس خلال شوارعها ويحاصرها من كل الجهات، ويتحكم بكل شئ فيها، وينتشر في كل مكان».
رواية لم تُكتب بعد
وحين يضيق «عنق الزجاجة» أكثر، سيلوذ السرد إلى مروي يتناول المدينة من خلال رؤية رومانسية لحياة طبقة من الأجانب كانوا يعيشون فيها، علي المقري في «بخور عدني»، أحمد زين في «ستيمر بوينت»، وتكاد تقدم إلمامة بجوانب من حياة الآخر الغربي في المدينة، ويحاول التأكيد على الطابع المديني لعدن. وعلى الرغم من التركيز على حياة تلك الطبقة، تحاول أن ترسم صورة مفارقة إلى واقع المدينة الآن، وواقعها قبل أكثر من نصف قرن، لكنها على الرغم من ذلك تروي لحظات حرجة أخرى من تاريخ المدينة، عشية مغادرة المدينة «عنق الزجاجة» البريطانية للدخول في عنق زجاجية أخرى، من صناعه وطنية محلية.
وتصل الرؤية المأساوية للمدينة إلى مدى أبعد مع الروائي العربي صبري هاشم، الذي كان قد أقام فيها زمناً، ولم يطل عليها من عيني سائح أو مهاجر عابر، وإنما من خلال عيني محب عاشق لها، ومشفق عليها، فكتب رواية «خليج الفيل»، وخليج الفيل هو أحد أجمل خلجان المدينة الساحلية التي لم تغادر لعنتها، «هذه أرض أدركت جحيمها قبل سواها، فسعت للبحث عن فردوسها من دون جدوى... هذه أرض تسلحت بأفران القيامة على امتداد الفصول، فابتلعتها تلك الأفران في غضبة من غضباتها... هذه أرض أريد لها أن تخرج من قانون الوجود وتغوص في الأعماق، أو تُتحف ببرق إلهي يحيلها خراباً... هذه عدن قضمة البحار المقاتلة»... فكانت بعد كل دورات من الخراب ورطة على الجميع... «عدن هي عنق الزجاجة... من يدخلها مات منفياً... من يسكنها بات محاصراً... عدن لعنة على أهلها وأعدائها على حد سواء... لقد علمتنا قراءة الغيب كما علمتنا تلمس اﻷشياء... عدن حالة نادرة بين المدن حيث يصبح الاحتفاظ بها ضرباً من خيال مهما طال الزمن، ومهما بلغت درجة التخريب أو البناء... وبين أهلها وأعدائها حالة دائمة من الفر والكر...».
عدن مدينة مشرَّعة على المزيد من الحكي راوية ومروية... ولم تُجِد بكثير من أسرارها لهؤلاء الرواة... ولم تكبها الرواية بعد.
منقولة من موقع العربي...
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر