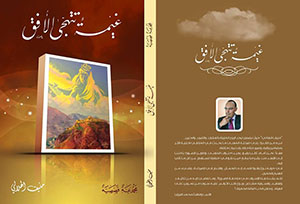- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

تضعنا علاقة المقدسات بالإبداعِ في مواجهةٍ مع سؤال حول صلةِ الديني بالأدبي ومدى استفادة الكتابة الأدبية من المنجز الحكائي في الأساطير والملاحم التي حفلت بها النصوص الميثولوجية القديمة، بداية من ألواح العهد السومري (3000 سنة ق.م.) وحتى التعاليم البوذية (600 ق.م.) إضافة إلى نصوص الكتب السماوية الثلاثة.
ولا شك في أن هذا السؤال محيلٌ إلى آخر وصورتُه: ماذا يبقى من النص الأدبي لو حذفنا منه كل مراجِعِه الدينيةِ المقدسةِ؟ ويمكن أن نسترسل في السؤال لنقول: هل يمكن أن يحافظ النص الديني على قدرته الإقناعية والاتعاظية لو لم يكن مُجهزا بعتادٍ قَصَصي من أخبار الأولين وأفانين قولهم؟
أسطورةُ الأدبِ
لا يمكن في أي حال من أحوال التعاطي النقدي مع النصوص الأدبية أن ننفي استفادةَ أغلبِها مما يرشح به المخزون الأسطوري الديني من أنماطِ حَكْيٍ وفنونِ تخييلٍ. وهي استفادة يُبررُها نزوعُ الأدب والدين، باعتبارهما فعاليتيْن تتبادلان التأثرَ بواقع الإنسان والتأثيرَ فيه، إلى نشر الثابت من القِيم الإنسانية كالخير والعدل والحرية، واشتراكهما في توظيف الأسطورة لتحقيق ذاك النزوع. ومن ثَم وجبت إضاءة دور الأدب في عضد منجزات الفكر من جهة كونه يمثل فضاءً يستطيع أن يستوعب المقدسَ في إطلاقيته وسبيلاً إلى البحث فيه بحثا حرا وذاتيا.
ولا شك في أن ما يمكن أن يُميز تلك المعرفة هو «أدبيتها»، ما يعني أنها ليست إلا تمثلاً ذاتيا للواقع الإنساني، خاضعا لطبيعة رؤيةِ المبدع له وما يحكمها من تصوراتٍ عما فيه من مقدسات. ولعل في هذا ما يجعل الأدب مسرحًا لحركة المقدس، وهو يخترق مجالات المعيش البشري، منتظِمًا إيقاعاتِها، ملونًا فيها مراغبَ الإنسان في أن يوجد في الكون وجودًا مريحًا ومرحا وخاليًا من القلقِ الفكري، على اعتبار أن الكتابة الأدبية تمثل شكلاً من أشكال التفكير والإقامة السعيدة في الكون. وتحقيقًا لبعض تلك المراغب، وجدت الإبداعاتُ الأدبيةُ في النصوص الدينية، في جل الحضارات تقريبًا، سبيلَها إلى مراودة آفاق التخييل السردي، بدون إكراهات المكان أو الزمان، عبر ما في تلك النصوص من عوالم الغرابةِ والتعجيب التي ظلت لأحقابٍ طويلةٍ موجهةً لخدمة قضايا العقيدة واللاهوت. غير أن الأدب حولها إلى تقنياتٍ فنيةٍ مشبعةٍ بكل ما يدخل في حقل اللامعقول، بوصفه مجالا يمكن الكاتبَ من توظيف كل ما يرى من هيئاتٍ أو أحداث غامضة ومستغلقة على معناها في نصه الأدبي، خاصة ما كان منها يسعى إلى محاكاة ظواهر الواقع، بدون أن يتطابق معها، لأن الأدب لا يُعبر عن شيءٍ حقيقي منها، وإنما يظل دومًا مخالِفا في تشكله لمنطق الطبيعة كالمُعْجِزةِ والكرامةِ والتصوف ومناخات المردة والأطياف. لا، بل إن جانبَ المُتخيل في فضاء اللامعقول يخترق واقعَ الأشياء والكائنات ويُعيد تشكيل هيئاتها تشكيلاً جديدًا. وهل الأسطورة، وهي تدخل النص الأدبي وتستشري فيه بمنظومتها الرمزية، إلا تحقيقٌ لتلك الطاقات الإيحائية بما يُغنى التخييلَ الأدبي ويُصفي أمواهَه الجماليةَ؟
من الديني إلى السردي
لقد انتبه الأدباء والنقاد منذ القدم إلى ثراءِ المدونات النصية الدينية بعناصر التخييل المشكلة للملاحم فيها، فعادوا إليها يبحثون عن رَواءٍ دافقٍ لكتاباتهم عبر قراءتها قراءةً لا تحفل بالعقائدي فيها احتفالَها بالفني. ويُعد كتاب «القانون الأكبر ـ الكتاب المقدس والأدب» لنورثروب فراي (1991 ـ 1912) محاولةً جريئة لقراءةِ التوراة قراءةً أدبيةً من جهة سعيِها إلى التركيز على مكونات النص الديني الفنية بعيدًا عن كل فهم له لاهوتي. تدخل قراءة فراي في إطار مشروعٍ فكري وُسِمَ بالحداثة ورفع لواءَه منذ بدايات القرن العشرين بعضُ الكتاب والباحثين الغربيين، خاصة في فرنسا، وعمدوا من ورائه إلى تخليص المقدس من المفاهيم التقليدية الشائعة، خاصة ما كان منتميا منها إلى الدراسات اللاهوتية، وتقديم بدائل له مفهومية جديدة تتجاوز في مقاربته ارتباطَه الوثيق بالإلهي في سموه وتعاليه، لتؤسسَ له بنيانًا دَلاليا لا يقوم على ما يتجاوز الخبرة المعرفية الإنسانية، بل يتمثل واقعَ الإنسان في قوته وفي ضعفه، وفي وحدته، وكذا في وجوده العام المشترَكِ.
وعلى هديٍ من ذلك أمكن للنص الأدبي أن يصنع قداساتِه بنفسه ضمن حركة اشتغالِ بُناه الفنيةِ والدلاليةِ، وأن يُنافحَ عن أسطورتِه الإبداعيةِ في ظل الأساطير الدينية؛ حيث استغل في نسيجه التكويني الأدواتِ التي ساهمت في إشعاع المقدس ـ خاصة منها الإشباع التخييلي ـ في إطار سعيه إلى حيازةِ وحدةٍ لغويةٍ لها أساليبُها الفنية ولها أسرارُها الخطابية ولها قوانينُ تجليها وتخفيها ولها رموزُها التي ترتقي بها إلى مراقي المقدسِ.
ولكن قراءة فراي تذهب في أمر علاقة الأدب بالمقدسِ مذهبا آخر، إذْ يُقر هذا الباحث بأن الكتاب المقدس مثّل مخزونا ثرا من الصور والاستعارات التي غرفت منه أغلبُ النتاجاتِ الأدبية الغربية ماءَها الفني، حيث يؤكد في كتابه «القانون الأكبر ـ الكتاب المقدس والأدب» أن تلك الاستعارات التي تحفل بها التوراة ما زالت فاعلةً في المنجز الأدبي الغربي حتى اليوم، ويُسمي فراي مُجملَ تلك الصور بـ«الكون الأسطوري» للنص الأدبي، ويوضح ذلك في قوله إنه «أمكن لعناصر الكتاب المقدس أن تُكَونَ إطارا تخييليا، وهو ما أسميه هنا الكون الأسطوري، اشتغلَ ضمنه الأدب الغربي منذ القرن الثامن عشر وحتى اليوم».
ولما كان فراي يرى في الأسفار الخمسة المكونة لمدونة التوراة النصية وحدةً أدبيةً ذات اتساق فني داخلي خاص، اعتبر أن نموذج الكتاب المقدس ليس مجرد وسيلة للقراءة، بل هو وسيلة للكتابة أيضا، وهو أمرٌ أكده بقوله: «إن النموذج التوراتي هو شكل من أشكال البلاغة، ويمكن للمرء دراسته مثل أي شكل آخر من الأشكال البلاغية».
وبالنظر إلى كون النص التوراتي يتوفر على بنيةٍ متماثلةِ العناصر، تتعاضد فيها الاستعارات مع حشد الصور التخييلية والمحسوسة لتنهض دليلاً على طابعه الأدبي وعلى كونه ذاتي المرجع، عمد هذا الباحث إلى جردِ تلك الاستعارات والصور وتبويبها في شكل جداول منها ما هو متعلق بأنواع الاستعمالات اللغوية، ومنها ما هو خاص بالصور الفنية، إضافة إلى ما كان منها متعلقا بالرسوم التوضيحية. وعلى هديٍ من تلك الجداول، خلص إلى الإقرار بوجود نوع من التماسك الأدبي داخل هذا النص لم تنتبه إليه الدراسات التاريخية، حيث لاحظ أن «هناك مدونة من الصور الحسية (المدينة، النهر، الجبل الشجرة، الزيت، العين، إلخ…) التي تتكرر في كثير من الأحيان داخل الكتاب المقدس ما يُشير بوضوح إلى أن فيه نمطًا من التصور الموحد عن الأشياء».
لعبةُ المحاكاة
وبعد تحديده البُنى الأسطوريةَ في الكتاب المقدس، وهي البنى السردية التي تتوفر على حبكة (ويُسميها ميتوس، أي: خرافة) ولها متوالية لفظية معلومة، بحث فراي عن مظاهر حضورها في النصوص الأدبية الغربية بقديمها وحديثها مثل، أعمال كل من فيرجيل (ت 70 ق.م.) ودانتي (ت1321م) ووليام بتلر (ت 1939)، وكشف في بعض مؤلفات هؤلاء الكتاب عن حضورٍ كثيفٍ لأساطير لها اتصالٌ بأخرى واردةٍ في الكتاب المقدس، لا، بل هي تُحاكيها مضمونًا وأساليبَ لغويةً. وفي رأي فراي أن من أسباب عودة الكُتاب إلى الأساطير والملاحم المذكورة بالكتاب المقدس والاشتغال عليها واستيعابها في نصوصهم، وعيُهم بقيمة تلك الأساطير التي تُكّون في مجملها إرثًا ثقافيا إنسانيا ساهم في توطين حركةِ المجتمعات في تربتِها الحضارية؛ ذلك أن «الأساطير المتجذرة في مجتمع معين تعمل على نقل إرْثٍ من الإشارات اللفظية والتجارب المشتركة السابقة، وبهذه الكيفية تساهم في خلق التاريخ الثقافي لذلك المجتمع».
وإن خلق التاريخ الثقافي للمجتمعات يمثل بعضًا من الوظيفة الأيديولوجية للأساطير، باعتبارها تكون نظامًا من التصورات موحدًا يتمثله الإنسان في صناعةِ علاقاته بمجموعته البشرية، ويحتكم إليه في كثير من نشاطه الأخلاقي والقِيَمي، وهو ما يجوز معه القولُ إن «الوظيفة الحقيقية للأسطورة هي رسم محيط حول المجتمع البشري والنظر إليه من الداخل، وليس التكفل بالتحقيق في عمليات الطبيعة… الأساطير ليست ردا مباشرا على البيئة الطبيعية، هي جزء من الطبقة التخييلية العازلة التي تفصل بيننا وبين تلك البيئة»، وذلك من جهة كون تلك الأساطير تمثل أسلوبًا في التفكير ابتدعه الإنسان لتفسير ثقلِ الظواهر التي تنصب عليه، وقد يرقى، في بعض دَلالاته الفكرية، إلى مرقى الأنموذج التفسيري الذي يلخص تجارب السابقين.
ومهما تنوعت زوايا نظر الباحثين في تأصيل الفكر الأسطوري، و«سواء انطلقوا من الفرد واعتبروا الأساطير تجلياتٍ لعوالم النفس والفكر أو للنماذج الأولى الأصلية، أو انطلقوا من المجتمع فنظروا إليها بصفتها قصصًا فيها سَردٌ لواقعةٍ يَعتقد أصحابُها أنها حقيقية ويُحْيونها من خلال الممارسات الطقوسية، أو باعتبارها أنظمةً من الصور نجد فيها النزعاتِ الدفينةَ التي تتجاذب شعبًا من الشعوب فتُمثل نداءً أو دعوةً إلى الفعل، وهو ما يصدق أساسًا على الأساطير السياسيةِ، أو انطلقوا من موقع آخر فنظروا إليها نظرةً تنزلُها ضمن ظواهر الوعي البشري عامة أي ضمن الكليات البشرية وما يُسمى بالوعي الأسطوري أو الفكر الأسطوري، فجميعهم يُنزل الأساطير منزلةً فكريةً مرموقةً لا تقل عن سائر أشكال التفكير بواسطة المفاهيم المجردة أو عن سائر الأشكال الرمزية».
البناء على الأنقاض
ولعل من أهم ما وقف عليه فراي في قراءته لعلاقة المقدس بالأدب هو أن المقدس الديني، في جانبه التخييلي، يعيشُ حركةً دائبة من التحولات، إذْ هو لا يستقر على مضمونٍ حكائي واحدٍ، بل يطورُ فيه باستمرارٍ ما يُلبي حاجات الواقع البشري في تعدده وفي اختلاف وقائعه. وهو الأمر الذي سماه كلود ليفي شتراوس (1908 ـ 2009)، وهو يدرس مسيرةَ الأساطير ضمن سياقات الفكر البشري، بـ»الترقيع، حيث يذكر في هذا الشأن أن «الفكر الأسطوري يتوفر على ثروة من الصور المتراكمة جراءَ مشاهدة العالَم الطبيعي بما فيه من حيوانات، ونباتات، وبيئاتها المناسبة، وسماتها المميزة، ووظائفها في إطار ثقافة معينة. ويجمع هذا الفكر كل تلك الصور لبناء معنى جديدٍ، تماما مثلما يفعل الحرفي الماهر عندما يتكفل بإنجاز عمل فني معين، حيث يتخير له من المواد أنسبَها ليعطيه معنى مُخالِفًا للمعاني الأولى التي كانت لتلك المواد». ذلك أن الفكر الأسطوري، وهو يعيش تلك التحولات، تتفتتُ فيه محمولاتُه السردية تاركةً أثرَها في شكل رُقَعٍ متناثرةٍ تسجلُها الثقافات الإنسانية في سجلاتها التاريخية. ويتدخل الأدب، على رأي فراي، ليكون المرآة التي تعكس آثارَ تحولات المقدس وهي تتماسك مع بعضِها بعضًا لتُعيد التشكلَ في إهاباتٍ حكائية أسطورية جديدةٍ ما يسمح لذاك الفكر بإعادة بناء صروحه عبر ترقيع أنقاض خطاباته القديمة.
ومن ثَم يجوز القول بأن الأدب مثّل ويمثّل، الفضاءَ الخاص الذي تهاجر إليه الأفكار المخالفةُ للمألوف العام، وهو أمرٌ يمنح الكتابةَ الأدبيةَ أهليةَ احتضان الأفكار التي تناقش المقدس وتُسائلُ وظيفة المؤسسات التقليدية الحاضنة له، سواء أكانت دينيةً أم سياسيةً، وتكشف عما فيها من أوهام، بل وتُدينها أحيانًا، وذلك من أجل استنبات معنى أصيلٍ للوجود البشري في إطار مواجهة بين الوعيِ الذاتي بالعالَم والوعي المجموعي المنجَزِ له في التاريخ. ويبدو أن الجرأةَ التي وَصَفْنا بها قراءةَ نورثروب فراي لعلاقة الأدب بالمقدس أثارت ردودَ أفعالٍ كثيرةً وحَفَزَت بعضَ دارسي الأدب الغربي على التصدي لها بالنقد؛ من ذلك أن تعريفَه للأدب على كونه «بنية لفظية لا توجد إلا لنفسِها»، وسعيَه إلى إسقاط هذا التعريف على طبيعة الكتاب المقدس باعتباره يمثل بنيةً متجانسةً تدل فيها سيادةُ الاستعارات وغيرها من الصور الخيالية على طبيعته الأدبية ذات المرجعية الذاتية، وَجَدَا معارضةً حادةً من قِبَل روبير ألتر الذي قال: «هذه النظرية التي تمثل مركز تفكير فراي ضعيفةٌ من وجهة نظر نظرية الأدب، وكذلك بالنسبة إلى وصف طبيعة الكتاب المقدس، بل هي مشكوك فيها لكونها نهضت على قاعدة مجموعة مختلفة من التفسيرات الخاطئة للنصوص التوراتية».
والأظهرُ من جُهد فراي البحثي هو أنه اعتمد في قراءته على نمطٍ كتابي معينٍ من النص التوراتي، بما يخدم أهداف بحثه، وتغاضى عن باقي أنماط المكتوب الأخرى، و«لئن تركز اهتمامُه في كتابه على الإشادة بالحضور الكثيف للاستعارة داخل النصوص الشعرية المُضمنة في الكتاب المقدس، فإن الواضحَ هو أن نسبةَ حضور الشعر في التوراة قليلة جدا مقارنة بنسبة حضور بقية الأجناس السردية الأخرى، فقد اقتصر الشعر على الحضور في المزامير وسِفْرِ الأمثال ونشيد الأناشيد، وفي بعض مقاطع كتب الأنبياء إضافة إلى إدراجات منه مُوجَزَةٍ في الحكايات المسرودة. إلا أن فراي أغفل التنبه إلى الحضورِ الكثيفِ للسجْعِ المُرْسَل الذي مثل أساسَ القص في الكتاب المقدس وأحدَ أعظم ابتكارات كُتاب التوراة».
فكيف يمكن أن نطمئن إلى نظرية فراي كل الاطمئنان وهو يجمع فيها بين رأيَيْن متضاديْن: أولهما قوله إن اللغة المجازية للتوراة هي في الواقع لا تزيد عن كونها ظاهرة لغوية ذاتيةَ المرجع، حيث هي تصف لنا حقائق يمكن التثبت من صدقيتها بالنظر إلى مدونات التاريخ لأنها تمتح صُورَها من العالَم المادي وتنقلها إلى داخل النص. وصورة ثاني الرأيَيْن هي إصرارُه على القول بمجازية النص التوراتي؟ وفي هذا الشأن، يمكن أن نضيف سؤالَنا حول عدم التفاته إلى ما قد ينجم عن تحويل «الكون الأسطوري» للنصوص الدينية إلى فضاء للتخييل الكتابي الأدبي من إمكانات انتهاك المقدس فيها سواء على مستوى المضمون أو على مستوى الشكل التعبيري؟
منقولة من القدس العربي ...
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر