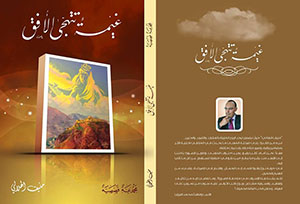- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

فبراير 2011
مساء الجمعة الخامس والعشرين من فبراير حسمت أمري أخيراً وقررت الانضمام إلى صفوف الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
أنهيت شرب كأس الشاي بالحليب، ثم غادرت المقهى وشارع المطاعم وسرت راجلاً صوب (ساحة التغيير). قبل وصولي إلى هناك بعشر دقائق سمعت جلبة فالتفتُ ورأيت رتلاً من سيارات الأمن المركزي على متنها العشرات من الجنود المدججين بالسلاح تعبر الشارع بسرعة، بتلك الطريقة المميزة في القيادة المتهورة وتخطي سيارات المواطنين بعنجهية واستخفاف. قلت في نفسي أن هناك مواجهات وشيكة الحدوث. أسرعت في السير، وقرابة الساعة الثامنة ليلاً وصلت إلى خطوط التماس. كان الجنود قد أقاموا حائطاً بدروعهم يفصل بيننا وبين المتظاهرين وأقفلوا الطريق - المدخل الجنوبي- المؤدي إليهم. كنا على الجهة الأخرى مع العشرات من المواطنين نقف على رؤوس أصابعنا لنراقب الاحتكاكات بين الطرفين. شكل المتظاهرون موجة بشرية أخذت تزحف بالتدريج صوب الجنود. كانوا يهتفون بسقوط النظام، واضطربت حركة المرور في المكان الذي كنا نقف فيه، شعر سائقوا السيارات بالتوتر وأرادوا المغادرة فوراً ضاربين عرض الحائط بإشارة المرور، فأدى ذلك إلى تعارض بين السيارات القادمة من الجهات الثلاث المفتوحة، فعمت الفوضى، وفقد بعضهم السيطرة على أعصابه وراح يشتم.
لم يكن هناك وجود لأنصار النظام، لذا بقينا في أماكننا دون خوف. وفي الجهة الأخرى كان التوتر يتصاعد بين المحتجين والأمن، ولم نكن نعرف سبب المواجهة.. أحد الواقفين بجواري قال إن المحتجين يريدون السيطرة على "جولة القادسية" حيث كنا نقف، وأن الأمن منعهم من ذلك. ارتبت في هذه المعلومة، لأنني لا أظن أن من مصلحة المحتجين التمدد والسيطرة على مساحة أكبر من الشارع.. فكرتُ أن العكس هو الصحيح، وأن الشرطة ربما أرادت تقليص المساحة التي استطاعوا انتزاعها من سيطرة النظام. لعل الشرطة ظنت أن جزءاً كبيراً من المحتجين قد عادوا إلى منازلهم فرأوها فرصة مواتية لدفع أنصار المعارضة للتقهقر إلى الخلف، وحصرهم في محيط (ساحة التغيير) فقط. قبل ساعات أدى أكثر من خمسين ألف متظاهر صلاة الجمعة في الساحة، وعقب الصلاة رددوا الهتافات المطالبة برحيل الرئيس.
رأيت أحد الجنود ينسحب إلى الخلف، سارع إليه أحد الضباط ووقفا يتكلمان. بعدها بقليل تلاه جندي آخر، ثم آخر. بدا أن صيحات المحتجين المزلزلة قد أدخلت الرعب في قلوبهم، وأدخلت الخذلان في نفوسهم. ترنح صف الجنود وتراجعوا للوراء، وكأنهم جدار يوشك على السقوط. ظل المحتجون يزحفون ببطء شديد ولكن بثبات.
صدرت الأوامر بالانسحاب، هرع الجنود إلى سياراتهم وقد فقدوا هيبتهم، حتى سيارات المواطنين لم تفسح لهم المجال كالعادة، فعلقوا في زحمة السير الخانقة، وبعد عنت شديد تمكنوا من مبارحة المكان.
لاحظت أعداداً من الشبان يتجهون صوب زقاق خلفي فتبعتهم، وبالفعل كان هذا الزقاق ممراً يعج بالحركة، وعدد كبير من الناس كانوا يدخلون، وعدد أقل كانوا يخرجون. في نهاية الزقاق كانت هناك ثلاثة صفوف من الشباب تقوم بالتفتيش، كانوا يبتسمون ويرحبون بنا، فتشوني ثلاث مرات. بعد خطوات قليلة وصلتُ إلى شارع (الدائري) الذي تحول مع ميدان الجامعة إلى مقر الاحتجاجات. ومع كل خطوة كنتُ أشعر بنور يشرق في داخلي، وبلحن حلو مرح تترنم به كل خلية من خلاياي العصبية. اختفى التعب ونسيت من أنا، كنت أشعر بأنني شخص مختلف يولد من جديد.
نظرتُ يميناً فرأيتُ المئات من الشبان يقفون كالبنيان المرصوص في آخر الشارع يرددون الشعارات وهم منتشون بانتصارهم في تلك المواجهة التي استمرت قرابة الساعة تقريباً، وانجلت عن انكسار العسكر وعودتهم خائبين.
نظرتُ يساراً فرأيت عدداً لا يُحصى من البشر يموجون في بعضهم، فبدا أنني دخلت مهرجاناً للفرح والسعادة، وأحسستُ وكأنما انتقلتُ إلى عالم آخر يشبه حلماً وردياً، إلى عالم جميل تأنس فيه الروح وتطمئن. أعداد ضخمة من البشر - قدرتُ عددهم بعشرين ألف على الأقل- غالبيتهم شبان في عمر الورد، منهم من كان يرقص رقصة (البرع) والجنابي تختال في أياديهم، ومنهم من كان يستمع إلى مطرب يغني الأغاني الثورية عند منصة مرتفعة تزينها صورة كبيرة ملونة للمناضل الأممي (تشي غيفارا). جماعات من الشباب تتحاور، وآخرون يلقون القصائد الفصحى والحمينية والنبطية. المطاعم مزدحمة بالشباب، والخيام المنصوبة على الأرصفة وإسفلت الشارع مفتوحة، ويظهر بداخلها شبان يراجعون دروسهم أو يقرؤون الكتب، وآخرون كانوا يلعبون الداما أو الشطرنج.
شاهدت سيارتين متوقفتين، إحداهما مرسيدس بيضاء والأخرى تاكسي بيجو، استخدمهما أنصار النظام لتخويف المتظاهرين ومحاولة دهسهم، ولكن المتظاهرين تمكنوا من احتجاز السيارتين، وهم يطالبون الآن بتحقيق مستقل لمعرفة هوية مالكي السيارتين. في الناحية الأخرى من الشارع كانت هناك سيارة دفع رباعي صالون (سانتافي) محروقة ومقلوبة على ظهرها كصرصار ميت، علق المتظاهرون لوحة ورقية تشرح أن السيارة المحترقة قد اندفعت بهمجية نحوهم وسائقها يُميل بها يميناً ويساراً مُلاحقاً الشباب إلى أن تمكنوا من السيطرة عليه وإيقافه. وذكروا أنه كان يحمل معه في السيارة أسلحة نارية وبيضاء وعصي كهربائية وجهاز اتصال لاسلكي، وقام الأشخاص الذين كانوا معه وفي غفلة من المتظاهرين بإحراق السيارة وما فيها.. ويقال إن السيارة تتبع جهة ما في الجيش.
علق الشباب على القضبان الحديدية لمعرض سيارات مهجور صوراً كاريكاتورية للحاكم، أغلبها صور مُركبة بواسطة الكومبيوتر مع تعليقات ساخرة، فلم أتمالك نفسي من الضحك. كان هذا فناً جديداً يُساهم مساهمة رهيبة في الثورة. في قلب الميدان تجمع الألوف من الناس جالسين على الأرض يتابعون من بروجكتر يرسل بثاً مباشراً لقناة سهيل اليمنية على شاشة من مشمع أبيض سميك معلقة على لافتة إعلانية حديدية ضخمة فوق سطح مبنى من طبقتين.
في الطرف الآخر من الميدان - باتجاه الشمال- كان الحشد الأضخم من المحتجين يستمعون واقفين إلى المنشدين الدينيين الذين وعطفاً على المناسبة كانوا ينشدون بأصواتهم الرخيمة أناشيد سياسية نارية، فألهبت الحماس في النفوس، وأججت نيران الثورة.
بالكاد كنت أستطيع السير وإيجاد موطئ لقدمي، الازدحام يفوق التصور. بوابة الجامعة ومدخلها الواسع غرق في صفوف من المخيمات وكأننا في معسكر أحد الجيوش الإسلامية أيام الفتوحات.. وعلى رأس كل خيمة لافتة تشير إلى أصحابها: خيمة أساتذة الجامعة، خيمة المحامين، وخيام تذكر أسماء المناطق اليمنية.. لقد جاء شبيبة القبائل من كافة المحافظات والتحقوا بالمعتصمين لمؤازرة إخوانهم في العاصمة.
كانت أعداد المحتجين تتزايد، والمزيد منهم يتوافدون من مداخل الميدان المختلفة، يبدو أن تلك المواجهة مع الأمن التي لم تصل إلى حد الاشتباك، قد جعلتهم يتحسبون لأية احتمالات، فقاموا بإجراء الاتصالات والرسائل النصية لطلب التعزيزات.. كانوا يتوجسون من أن يباغتهم الأمن بهجوم في ساعة متأخرة من الليل. الشباب كانوا منظمين، وموزعين على لجان، وكل لجنة تقوم بعملها على أفضل صورة، وكأنما لدينا حكومة ذاتية في دويلة مصغرة تحررت تواً من قبضة الطغاة.
كنا في أجواء مهرجانية حقيقية، الجميع يشعر بسعادة غامرة لا توصف، والمعنويات مرتفعة إلى عنان السماء، والعيون ينطلق منها بريق رائع، بريق التفاؤل والأمل، وهما الشيئان اللذان افتقدهما الإنسان اليمني بشدة منذ ثلاثين عاماً خلت. عدوى البهجة انتقلت إليّ وتمشت في روحي، وشعرت لأول مرة في حياتي بأنني أقف على أرض يمنية "حرة".
***
فبراير 2012
لقد أقسمت ألا أخرج من ساحة التغيير إلا عندما يسقط النظام. اليوم هو الخامس والعشرين من فبراير، اليوم الذي استلم فيه رئيس جديد حكم اليمن. وبما أنني قد أوفيت بقسمي، فقد غادرت ساحة التغيير، وكان أول مكان اتجه إليه هو (شارع المطاعم) الذي اشتقت إليه بعد غيبتي عنه عاماً كاملاً. يُقال إنه في سبعينات وثمانينات القرن الماضي كان الرجل الحديدي للمخابرات (محمد خميس) إذا أراد أن يوجه ضربة لليسار، فإنه كان يرسل جلاديه إلى شارع المطاعم حيث يجدهم متجمعين، ومن هناك يسوقهم للمعتقلات. وذكر لي مالك أقدم مقهى في هذا الشارع أن الرئيس الحالي كان يتردد لشرب الشاي بالحليب يومياً في الثمانينيات، قال إنه كان يظهر مرتدياً زياً شعبياً أنيقاً، ويجلس صامتاً لا يُواسيه أحد في وحدته.
وصلتُ قرب المغرب، وكنت أشتهي البيض بالطماطم المطبوخ بالطريقة العدنية الذي لا مثيل له في أي مكان آخر من المدينة، ولأن نفسي تكاد تخرج على هذه الأكلة، فقد توسلت للطباخ أن يُعد لي هذا الطبق، رغم أن وقت عمله لم يبدأ بعد، تذكرني الطباخ العجوز ولبى طلبي عن طيبة خاطر.
نجوت من الموت ثلاث مرات. المرة الأولى حوصرت بين قوات الحرس الجمهوري الموالية للنظام وبين قوات الجيش الموالي للثورة في جولة (كنتاكي). عندما بدأ الضرب بالرصاص تناثر المتظاهرون واختفوا كأنما تبخروا في الهواء. اقتحم جنود الحرس الزقاق الذي لجأت إليه، ومن حسن حظي وجدت كيسين ثقيلين فيهما طماطم وبطاطس وخضار مُنوعة مطروحين على مصطبة، فحملتهما وتظاهرت بأنني من سكان ذلك الزقاق، ورحت أطرق باب أحد البيوت. اقتربوا مني وصوب أحدهم البندقية إلى رأسي، بعد أخذ ورد، قال واحد يبدو أنه قائد المجموعة: "اتركوه هذا من سكان الحارة وليس منهم". تركوني وذهبوا لتمشيط الأزقة الأخرى. لا ريب أنني ولدت من جديد في تلك الليلة. حتى أنني صرت أقول لمن يسألني عن مسقط رأسي بأنني من مواليد جولة كنتاكي! المرة الثانية سقطت قذيفة على بوابة منزل مُغلق منذ بداية الثورة، كنت قبل دقيقة واحدة من سقوطها واقفاً عند الباب أتكلم مع أحد أصدقائي. قتل شخص واحد، وأصيب آخرون بجروح من الشظايا، الباب الحديدي ظل مدة ربع ساعة يشتعل ويتصاعد منه اللهب، وبعد انطفاء النار، استمر الباب أزيد من ساعة يُدخّن أدخنة سوداء كثيفة. المرة الثالثة سأحكيها ولو لم يصدقني أحد. في ذلك اليوم انطلقنا في مسيرة طويلة، ومشينا من شارع (الستين) وعندما اقتربنا من جولة (عصر) أخذ القناصة يضربون علينا. كنا نتقدم بشجاعة ولا نأبه للرصاص. عن يميني، كان يمشي رجل شيبة ظل طوال المسيرة يُمسك بيدي ويُبدي عطفاً كبيراً عليّ. ولما أخذ الرصاص يُلعلع قال لي: "عندما تسمع صوت الرصاص أخفض رأسك يا بُني". حصل اضطراب في صفوفنا، وسمعنا زعيقاً وصيحات تطلب النجدة. أدركنا أن الضرب لم يعد تخويفاً وإنما مُوجّه للّحم. بلغت القلوب الحناجر وتابعنا تقدمنا ونحن نردد كلمة "ارحل". سمعنا صليلاً متتابعاً، أمسك الشيبة برأسي وأخفضه وهو يقول لي: "قلت لك أخفض رأسك ع.." أزّت رصاصة خلف أذني واستقرت في صدغ الشيبة الذي لقي مصرعه على الفور. رحمه الله لقد أنقذ حياتي، ولو تأخر ثانية واحدة في تنكيسي لما طالت حياتي لأرى هذا اليوم المشهود في تاريخ بلادي. وفرت لي حكومة الثورة درجة وظيفية، وتم توزيعي على وزارة الإعلام، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أي أن أمنيتي قد تحققت أخيراً وصرت أعمل في مجال تخصصي، فأنا خريج كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون. تخرجت عام 2006 وظللت عاطلاً عن العمل طوال خمس سنوات، وكنت أُدبّر بالكاد مصاريفي من العمل في صحف صغيرة تتبع أحزاباً معارضة للنظام وقتذاك. أسست موقعاً إليكترونياً للدفاع عن المستضعفين الذين استولى العسكر والشيوخ على أراضيهم وهجّروهم منها، وبسبب هذا الموقع الذي كشفت فيه أسماء مغتصبي الأراضي بالاسم، وُضعتُ في القائمة السوداء، وأصبحت شخصاً غير مرغوب فيه، وتعرضت جميع جهودي للعرقلة، وسدّوا في وجهي أبواب الرزق والعمل الشريف. عمّموا اسمي على جميع الصحف الرسمية والمؤسسات الحكومية، وجعلوا التعامل معي محظوراً. عندما أذهب إلى أي مكان أو أحاول التواصل مع أية جهة أجد قناعاً من اللطف والابتسامات الزائفة، ولكن ما إن أُدير ظهري حتى يضعون أوراقي ومشاريعي وأحلامي في سلة القمامة. الشيء الوحيد الذي تمكنت من عمله في العهد البائد هو إصدار كتاب جمعت فيه مقالاتي عن السينما وفن الصورة عبر ناشر مستقل، وإنشاء ذاك الموقع الإليكتروني.
***
فبراير 2013
أخرجت أول برنامج لي في التلفزيون. وهو برنامج ثقافي أسبوعي مدته نصف ساعة. سنحت الفرصة لأن معظم المُخرجين المُخضرمين في مؤسسة التلفزيون يتهربون من إخراج البرامج الثقافية، والسبب أنه من النادر جداً أن تجد رعاة "رجال أعمال" يمولون برنامجاً ثقافياً. وا أسفاه، نجحت الثورة ولكن الثقافة لم تنجح.
***
فبراير 2014
هنئوني هنئوني لقد تزوجت من فتاة أحلامي. ملكة جمال هي، قرص عسل عدني، نعم هي عدنية، ولكن إياكم أن تضحكوا وتظنوا أنني تزوجتها لأجل أن تطبخ لي أكلتي المفضلة "البيض مع الطماطم بالطريقة العدنية"! ما جرى أننا تعارفنا عبر الفيسبوك، وتسامرنا تحت عُرُشه الظليلة. قبل الفيسبوك كنت أقرأ مقالاتها المنشورة في الصفحات الثقافية، وهي بالمثل كانت تتابع مقالاتي وتثير اهتمامها. بعد عامين من الانجذاب الفيسبوكي، حددنا موعداً والتقينا وجهاً لوجه في مقهى مودرن تؤمه الطبقة الراقية – لا يشبه في شيء مقاهي شارع المطاعم الذكورية الفظة التي تفزع حتى القطة من الاقتراب منها- حيث من المسموح للإناث الحضور واللقاء بالرجال. أهديتها عطراً غالياً، وأهدتني كتاباً يُعد مرجعاً مهماً عن السينما المصرية. وبعد هذا اللقاء بأشهر تزوجنا وقضينا ثلاثة أسابيع في عروس البحار عدن.
***
فبراير 2015
باركوا لي لقد رزقت بمولود وسيم، سميته (عبد الإله) تيمناً باسم أعز أصدقائي. زوجتي (سالي) بخير، وقد عادت إلى مزاولة عملها في الصحافة.
***
فبراير 2016
بفضل التحسن في دخلي ودخل (سالي) قمنا بأهم خطوة في الحياة: اشترينا شقة بالتقسيط. الشقة مساحتها واسعة وتتكون من ثلاث غرف مع منافعها، ولها إطلالة رائعة على أكبر حديقة في صنعاء. من حسن حظنا أن حكومة الثورة انتهت من تجهيزها أواخر العام الماضي. يقع عشنا الدافئ في الدور السابع.
***
فبراير 2017
أخرجتُ أول فيلم سينمائي، مدته ساعة، عنوانه "ثورة الريحان". وهو فيلم روائي عن ثورة التغيير المباركة التي أطاحت بالنظام السابق. الفيلم حصد جائزة دولية من مهرجان للأفلام السينمائية في هولندا.
***
فبراير 2018
من كان يُصدّق أن نهايته ستكون شنيعة هكذا.
***
فبراير 2019
حصلتُ على ترقية، لقد صرتُ مديراً عاماً لإدارة المُخرجين بالمؤسسة. زوجتي (سالي) تشغل حالياً منصب رئيس تحرير صحيفة متخصصة بالدفاع عن حقوق المرأة. ابننا (عبدالإله) المُلقب بالزعيم، صار يخرج معنا كل صباح، ويتجه حضرته إلى حضانة الأطفال ليدردش مع معلمته الحسناء.
***
فبراير 2020
لقد قلت لكم ولم تصدقوني، هذه (المرأة) ستحكم اليمن.
أحكام تاريخية للقضاء اليمني، أعادت الأراضي المأخوذة غصبا لأصحابها الشرعيين.
***
فبراير2021
الحكومة الجديدة قامت مشكورة بطبع مجلد تذكاري عن شهداء الثورة. حصلتُ على نسخة من أحد أصدقائي. عندما قمتُ بتقليب صفحات الكتاب، عثرتُ على صورة قديمة لي وأنا أرتدي قميصاً أبيض وربطة عنق فضية تشبه بدن سمكة من بحرنا. تحت الصورة كتبوا اسمي ونبذة مختصرة عني، ذكروا فيها أنني قد وافاني الأجل في (ساحة التغيير) بعد صراع مرير مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الثانية والثلاثين عاماً، وذلك في ديسمبر 2011. صفقتُ دفتي الكتاب ورميته بعيداً. حقيقة لا أتذكر أن شيئاً من هذا القبيل قد حدث.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر