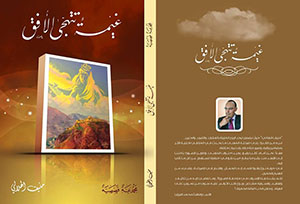- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
الجمعة 07 نوفمبر 2025 آخر تحديث: الخميس 6 نوفمبر 2025

- مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
- الحوثيون يحولون البيئة اليمنية إلى ضحية بالألغام والاستنزاف المائي
- الجبايات الحوثية تدفع 20 فندقاً للإغلاق في مدينة الحديدة اليمنية
- «حكومة الوحدة» الليبية تعلن إطلاق هانيبال القذافي
- مجلس حقوق الإنسان يعتزم عقد جلسة طارئة بشأن السودان
- الجيش الأميركي يعتزم تأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق
- عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»
- صمت غامض من كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني حول شائعات عودة علاقتهما
- الحوثيون يهاجمون «الصحة العالمية» و«اليونيسف» بعد تعليق أنشطتهما في اليمن
- الإعلامية الكويتية فجر السعيد تخضع لعملية جراحية عاجلة في ألمانيا
فرصة تعارف - وجدي الأهدل

2017/08/25
الساعة 16:05
(الرأي برس (خاص) - أدب وثقافة)
كنا وحدنا نحن الثلاثة على سطح القمر. صمت القمر الجليل أدخل الرهبة في قلوبنا، وجعلنا ندرك كيف تحيى الأشجار في عالمنا.
من شرفة محطة الأبحاث المهجورة رحت أتطلع إلى بيداء القمر القاحلة، بينما انشغلت المرأة والطفل بالتفرج على معالم الأرض من خلال التلسكوب، وهي التسلية الوحيدة المتاحة على سطح القمر.
ثبّتُ بصري على الوطن الأم الذي بدا لي كقرص خبز مأكول أكثر من نصفه، وأنا آمل أن أرى أية دلائل تشير إلى وجود حياة على سطحه. كنت أحدق بتركيز شديد غير مُصدق أن مليارات من البشر بسياراتهم وطائراتهم ومصانعهم وناطحات سحابهم يقبعون هناك ولا يمكن ملاحظتهم من موقعنا هذا على الإطلاق.
بدت لي الأرض نفسها مقلوبة، جنوب إفريقيا في الأعلى، وأوروبا في الأسفل، ولونها بنفسجي غامق مائل للزرقة وبقع فضية لامعة تتموج.
نظرت إلى قدميّ وانتابني شعور بالحرج، لأنني لم أكن ألبس حذائي.. تقدمت المرأة مني وهي تحمل فردتي الحذاء، وقفت أمامي مبتسمة، جرى الطفل الذي يناهز عمره الستة أعوام وأخذ منها فردتي الحذاء وانحنى وأدخلهما في قدميّ. أخجلني الطفل بتصرفه حتى أنني نسيت أن أشكره.
دون أن نتبادل أية كلمات خرجنا من محطة الأبحاث ورحنا نتجول في سهل قمري منبسط وننتقي بعض الأحجار وندسها في جيوبنا. فتق الطفل حجراً بيضاوي الشكل بأسنانه، ووضع بين فلقتيه شيئاً بحجم قطرة الماء، ثم أعاد رتق الحجر بلعابه ورماه بعيداً جداً حتى غاب عن أنظارنا. قال:
- أسرارنا نحن الثلاثة ستبقى محفوظة هنا للأبد.
عدنا أدراجنا إلى محطة الأبحاث، والطفل في المقدمة، بدا واضحاً أنه هو الذي يقودنا. ناولني فص عقيق أحمر بلون الشاي في داخله شكل لمخلوق غريب أكبر ما فيه عيناه! وأعطى المرأة فص عقيق أكبر حجماً لونه أبيض مائل للزرقة، وراح يحدثها عن أسراره، لكنني لم أُكلف نفسي عناء الإنصات لتلك الترهات.
حين وصلنا إلى الشرفة حدث شيء غريب.. التلسكوب لم يعد موجوداً، وحلت محله أرجوحة تشبه النبلة، لم أجرؤ على الاقتراب منها، بينما انشغل الطفل والمرأة باللعب، وتعالت ضحكاتهما تفرقع كالألعاب النارية. سمعتُ هسيساً ينبعثُ من الداخل فأصغيتُ بكل حواسي.. راودتني رغبة بالهرب، بالانسحاب، وتساءلت كيف يمكننا العودة بأقصى سرعة إلى الأرض. أمسك بي الطفل وأنا ساهٍ ضائع في خواطري فارتعشتُ من المباغتة. كركرت المرأة بضحكة شقية، وغطت وجهها بيديها، ربما لنجاحهما في إخافتي.
لعق الطفل خط الحياة في كفي بشفتيه، تذوّق جلدي كطباخ يختبر مقدار الملح في طبخته:
- جلدك يقول إنك ستحب هذا الطريق.
بعدما أتم الصغير كلامه الذي لم أفهم مغزاه، اختفى عن ناظري ولم أعرف إلى أين ذهب. لقد أثار فضولي، وفكرت أن أبحث عنه في المكاتب الأنبوبية لمحطة الأبحاث، ولكن وخزة خوف جعلتني أتراجع عن اللحاق به.. يعلم الله أية كائنات فضائية مرعبة قد استوطنت المحطة في غياب البشر!
دنت المرأة مني حتى كاد وجهها يلتصق بوجهي، استنشقتْ أنفاسي، ثم تنفستْ بارتياح:
- الحب في حياتنا مثل فصوص العقيق اليماني التي تحوي في داخلها شكلاً غامضاً، تأوله العين بما ينهمك به الفؤاد.
انفرجت شفتي قليلاً، أردت التعليق على كلامها، ولكن لم يخطر ببالي أيّ شيء.
كانت المرأة تحدق فيّ بفضول. وأما أنا فقد شغلت نفسي بتأمل جدران الشرفة المُرصّعة بملايين لا تحصى من أحجار العقيق الملونة بألوان شتى. كنت أسترق النظر إليها بين الحين والحين من طرف عيني، والتوتر يكاد يقضي على أعصابي، لأنه في حقيقة الأمر لم يكن هناك شيء آخر نفعله.
بعد مرور وقت لا سبيل لتقديره، عاد الطفل الحلو التقاطيع ومعه كرسي، طلب مني القعود ففعلت، ودون استئذان جلس على ركبتي وأسند رأسه على صدري مؤرجحاً رجليه بسعادة بالغة.
استرقت نظرات طويلة إلى وجه المرأة الفاتنة متشجعاً بحضور الطفل الذي رفع الكلفة بيني وبينه. بعد قليل، سألني ببراءة طفولية نعدها نحن الكبار وقاحة:
- هاه.. ما رأيك فيها.. هل تعجبك؟
تنحنحتُ وأرسلتُ ابتسامة خفيفة عبّرت عن إحراجي وفركتُ وجنته بلطف.
تابع كلامه:
- اسمها (آزال) تعمل معلمة في مدرسة للبنات، وتسكن في عمارة شوقي بحي الصافية.
هذا الطفل الذي لا أدري من أين جاء، أحس وكأنه يمارس مهنة (الخاطبة) بيننا.
تجرأت وسمحت لنفسي بتفحصها من رأسها إلى قدميها تفحص الصائغ للحجر الكريم، مع الفارق طبعاً بين تفحص حجر وتفحص أنثى!
رحت أكلم نفسي: "جميلة؟ نعم جميلة.. ليست طويلة، ولكنها أيضاً ليست قصيرة، إنها مرنة، أشبه بسلم يمكن فتحه وطيّه حسب الحاجة هاها.. بشرتها بلون البابايا الناضج، من وجهها ينبعث دفء لذيذ يُذكرني بالخبز لحظة إخراجه من التنور.. لا مكتنزة ولا نحيلة، ولكنها فضفاضة وذات جسد رحب كأروع ما يمكنني اتخاذه لراحتي في السرير".
انتبهت إلى القشعريرة المُريعة المُرتسمة على سحنة الطفل الذي هالني منه أنه قادر على قراءة أفكاري اللزجة عن تضاريس تلك المرأة.
التفتَ إليها وتكلم بلهجة ساخرة:
- قحطان موظف في وزارة الزراعة، ولكنه يفكر فيكِ كما يفكر عامل طلاء يشتغل باليومية!
صدمني جوابه الذي سبر دخيلة نفسي، وبزغت تكشيرة الهلال المقلوب على وجهي، واتخذ شاربي الكث ملمح رف طويل من الملفات المهترئة من شدة القدم.
ضحكت الشابة ضحكاً متقطعاً له جمال خاص، يجعلك تتمنى بمكر لو يُتاح لك دغدغتها كل ساعة لتمتع أذنيك بضحكاتها الروحية الآسرة.
قالت ببطء موزون يُوحي لكَ بأنها تطبخ الكلمات في فمها قبل أن تنطقها:
- هذا تفكّر مبهج، أنا أحب مهنة الطلاء، ولكن مجتمعنا مع الأسف لا يسمح بوجود عاملات طلاء!
ضحكنا من أمنيتها الشاطحة التي لا تخطر ببال امرأة.
وضع الطفل رجلاً على رجل - وهو فوق ركبتيّ- وقال مشيراً إليّ بإبهامه:
- الرسام الفاشل يفكر دائماً في احتراف مهنة الطلاء (ضحك جماعي) والشاب الذي ترينه أمامك تحول إلى ممارستها بالفعل، لذلك عليكِ أن تحرصي على منع دخول علب الألوان الزيتية إلى بيت الزوجية، وإلا أصبحتِ لبانة في أفواه الجيران.
تابع الطفل:
- هو كما ترينه.. أسمر، متوسط القامة، له بنية شجرة ناضجة لا تفتّ فيها المعاول. نصف شابات (باب السبح) يُرسلن إليه قبلاتهن من وراء شبابيكهن عندما يمر من الشارع، وكل بائعات (الملوج واللحوح) يتمنين لو يدنو ويشتري منهن ليُسرّين عن أنفسهن بمس أنامله.
أطرقتُ برأسي خجلاً، وتساءلت في نفسي هل يعقل أن هذا الكلام الذي يُقال عني صحيح؟ ربما أن انهماكي في عملي وقراءة الكتب جعلاني لا ألاحظ افتتان البنات بشخصي.. هن في عصب ولحم الواقع اليومي، وأنا أهيم بخيالي وفكري في عالم مثالي لا وجود له.
نهض الطفل من فوق ركبتيّ، وأحاط الشابة بذراعيه الصغيرتين، وألصق أذنه ببطنها وكأنه يُنصت لحركة جنين في رحمها. وجّه كلامه إليّ وقد أشرق محياه:
- سأخبرك بمفاجأة.. إنها تحب كتابة القصص! لديها الآن دفتر مذكرات أشبه ما يكون بحديقة خلفية تضم أندر النباتات، نسخت فيه بخط جميل الأشعار العاطفية التي نظمتها، وقصة حياتها على نحو مُجزأ تصلح للنشر في حوالي عشرين قصة قصيرة، أيضاً ذلك الدفتر مليء بمقتطفات غزيرة من الأشعار التي تروق لها، وبالأقوال الحكيمة لكبار أدباء العالم، جنباً إلى جنب مع أشعار وقصص مختارة بذوق فني مُرهف لبعض محاولات تلميذاتها، وأغلب أولئك التلميذات لا يدور بخلدهن أبداً أن كلماتهن مخلدة في دفتر معلمتهن، ذلك أن معظمهن وإن بدت مواهبهن الأدبية مُبشرة قد انتهى بهن الحال إلى بيت الزوجية.
نظرت في عينيها كما هي تنظر في عيني: بتمعن، بانتشاء، بدوخة خفيفة جراء ارتعاش أطرافنا وتعرّقها، بوجدٍ واستلاب خالص، بدقات قلبينا التي تُسمع كدوي سيل يلجُ السهل من قمم الجبال.
نقّل الطفل بصره بيننا:
- والآن ماذا ستفعلان؟
أجبت أنا وهي بصوت واحد تشيعه بريق بسماتنا:
- سنتزوج.
ابتعد الطفل عن الشابة ووقف بعيداً، بدا مهموماً:
- إنكما لا تستطيعان الزواج.. أقصد أنكما لم تتعارفا بعد.
ردت الشابة وفي كل كلمة من كلماتها رنة رضا ممتعة:
- لا.. لقد تعارفنا بصراحة وعمق، ليس الزمن شرطاً للتوافق الروحي.
رد الطفل بحذر وعيناه تضيقان:
- التوافق الروحي دائماً يسبق الزمن بأكثر مما نتصور.. ما أقصده أنكما الآن في حلم.. وأنني قد بذلت جهداً خارقاً لكي أجعلكما تحلمان حلماً مشتركاً.
طفرت دمعة من عينيّ الشابة وانخسف وجهها.
قلتُ بوجل وهمس خشية أن نستيقظ من حلمنا:
- ألا يمكن إذا ما استيقظنا أن نتذكر هذا الحلم ونسعى لتحقيقه.. أيّ أن نتعارف في عالم الحس؟
تطلع الطفل إلى كوكب الأرض المقلوب رأساً على عقب وأطلق زفرة طويلة:
- لا أظن.. فضجيج الحياة القوي للغاية يُهشم كل أحلامنا الشفافة.. ولكن لربما تذكرتما ومضات خاطفة من هذا الحلم.. ساعتها لن تفكرا في الحلم إلا على نحو ساخر وستلقيان باللوم على وجبة العشاء الثقيلة!
قالت الشابة بصوت باكٍ أليم هز قلبي وصدّعه:
- إذاً فلماذا جمعتنا؟
قال الطفل وقد احمرّ أنفه خجلاً:
- كان عليّ أن أهيئكما روحياً لما يُسميه الشعراء "الحب من أول نظرة".
قلتُ ووجهي يتسع من الفرح كما تتسع كرة العجين في يد الخباز:
- رائع.. ومتى ستتاح لنا فرصة التعارف الحسية؟
تلكأ الطفل في الجواب.. بدا هو نفسه مُتحيراً:
- لست أدري.. ربما بعد أيام أو أشهر.. ربما بعد سنوات.. لكنني واثق من لقائكما برغم كل الظروف المعاكسة.
صمتنا برهة من الزمن نفكر في المصائر العجيبة التي يحملها الإنسان بداخل بذرة أحلامه. رأيت الشابة تمسح دموعها، أنا أيضاً كنت أبكي دون أن أنتبه.
الأرجوحة التي لم يكن عندها أحد بدأت تتأرجح من تلقاء نفسها وكأنها تريد أن تنطق بشيء ما.
قالت الشابة وقد أدركت حقيقة ما يحدث:
- لقد استطعنا بوضوح رؤية محتوى فص العقيق الخاص بكل واحد منا من بين ملايين فصوص العقيق الأخرى المُستغلقة على الفهم.
أردتُ أن أقول لها إننا قد عرفنا طرفاً من حقائق مستقبلية، وشذرات من قدرنا الذي سيكون.. ولكنني حين التفت لأقول لها هذا الكلام لم أرها..
أحسست أنني أبتعد عن تربة القمر الطُحْلَة الهشة الناعمة، وأنني أفقد تكويني الجسماني وأتحول إلى ذرات تسبح في الفضاء. أخذت الأرض بالاقتراب وأصبحت أكبر من حجمها السابق بثلاثين مرة وملأت الأفق.
كان وعيي يحضر ويغيب، وكأنني أتأرجح بين الغفوة واليقظة، وكان آخر شيء أدركه هو سماعي لصوت ذاك الطفل وهو ينادي علينا مُتحشرجاً ببكاء ناعم:
- إلى اللقاء يا ماما.. إلى اللقاء يا بابا.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
أدب وثقافة
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
اختيارات القراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر