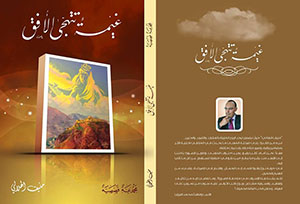- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

لقد كثر مؤخرا الحديث عن ضعف التعليم الجامعي ومخرجاته في بلادنا وبلدان العالم الثالث بشكل عام. ولا شك أن ضعفَ التعليم الجامعي ظاهرةٌ معقدة وذات أبعاد متعددة، ولن يكون من السهل اختزالها في سبب واحد أو وجهة نظر شخص واحد؛ لهذا أدعو زملائي إلى المشاركة الجادة في مناقشة هذه الظاهرة بهدف الإسهام في الارتقاء بالتعليم الجامعي بشكل عام وجامعة عدن بشكل خاص. وفيما يخصني، سأكتفي هنا بتقديم موجز لأربعة من مسببات ضعف التعليم الجامعي: المدخلات، وغياب التوجيه وسياسة التوظيف، وضعف التدريب والتطبيق العملي، وشح الموارد المالية.
في اعتقادي أن سوء مخرجات التعليم الأساسي والثانوي مرتبطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلادنا، إذ أن هذه الظروف تحتوي على عوائق فعليّة أمام التعليم بشكل عام. ففي كثير من المناطق، من أجل تشجيع الأسر على إلحاق بناتهم وأبنائهم بالمدارس وعدم سحبهم منها مبكرا وبالتالي رفع معدلات الأمية، تضطر إدارات التربية إلى تبني سياسة الانتقال السلس في الصفوف الأولى من المرحلة الأساسية، وذلك في الوقت الذي لم تنجح فيه تلك الإدارات من رفد تلك الصفوف بكفاءات بشرية مؤهلة بشكل صحيح. لذلك ليس من النادر أن نجد تلاميذ أنهوا الصف الرابع ابتدائي ولا يعرفون القراءة والكتابة. وبسبب سياسة القبول في الجامعات، ولاسيما في الكليات الجاذبة، ولأسبابٍ أخرى، أصبح الغش ظاهرة متفشية في امتحانات الثانوية العامة. لهذا من المتوقع أن تظل الجامعة تشتكي طويلا من ضعف المدخلات.
ومن أسباب تفاقم مشاكل التعليم الجامعي: غياب التوجيه والإرشاد واختزال الهدف من الالتحاق بالجامعة في الحصول على الشهادة، وليس اكتساب المهارات والمعرفة. فمن المؤكد أن بلادنا قد شهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الجامعات الحكومية والأهلية. واقترن ذلك بارتفاع أعداد الطلبة والموظفين والعسكريين - وبينهم وأميون- الذين دخلوا تلك الجامعات بهدف الحصول على الشهادة منها لا غير. ففي هذه البلاد - كما هو الحال في كثير من البلدان العربية والنائمة- بات الحصول على شهادة جامعية - أي شهادة وفي أي تخصص- هو الهدف الأساس من دخول الجامعة. وهناك أسباب وجيهة لذلك؛ فكثير من الإجراءات الحكومية والعادات الاجتماعية تدفع إلى ترسيخ هذه الظاهرة. فمثلا: بالرغم من أن بلادنا تشجّع التعليم الفني وأفردت له وزارة خاصة، إلا أنها حينما أرادت أن تحد من البطالة بين الشباب قامت قبل بضع سنوات بمنح نحو سبعين ألف وظيفة دفعة واحدة لحملة الشهادات الجامعية. وبعكس ما يتم العمل به في البلدان المتقدمة التي تهتم كثيرا بالموهبة والكفاءة والتميّز، تــُعد الشهادة الجامعية هنا هي العامل الأول والأخير – + الواسطة – للحصول على الترقي الوظيفي وزيادة الرتبة والراتب. لذا نجد أن نسبة كبيرة من المسجلين في الجامعات اليمنية – وهم ليسوا بالضرورة من مرتاديها- هم أصلا من الموظفين والعسكريين الذين اضطروا بفعل تلك الأسباب الوجيهة إلى الالتحاق بالجامعة للحصول على الشهادة، المرادفة لجواز الترقية وتحسين الراتب أو الحصول على الوظيفة.
ومما يعقد الأمور: غياب آليات فعّالة للتوجيه والإرشاد في مؤسساتنا التعليمية، تمكـّن الطالب من الالتحاق بالتخصص الذي يتناسب مع ميوله ومواهبه وقدراته، وكذلك مع احتياجات -العائلة والقبيلة و- التنمية. ومن المعلوم أن التلميذ، عند الانتهاء من التعليم الإعدادين يكون على درجة كافية نسبياً من الوعي بأهمية الاستعداد للمستقبل واختيار المهنة التي يريد، وتزداد حاجته إلى التوجيه والإرشاد الذي يُعد جزءاً من البرنامج التربوي: العائلي والمؤسسي. وأعتقد أنه من الواجب خلق أو تفعيل دوائر لإرشاد التلاميذ وتوجيههم نحو التخصصات المناسبة لهم قبل الانتهاء من التعليم الأساسي والإعدادي، والتأكيد، من قبل وزارة العمل والجهات المعنية بالتوظيف، على أن الخبرة والموهبة وخرجات المعاهد الصناعية والتجارية والمهنية وليست أقل مستوى أو أهمية من الشهادة الجامعية. ومن الواضح أن مؤسساتنا التعليمية لم تستطع حتى الآن أن أو تفعّـل آليات توجيه وإرشاد صحيحة وناجعة. فاليوم كل من يحصل على معدل منخفض في المستوى الأول الثانوي عليه بـ(الأدبي)، ومن يتحصل على أقل من 80% في الثانوية العامة – علمي أو أدبي- يضطر في الجامعة إلى الالتحاق بأحد أقسام الجغرافيا أو الإدارة أو التاريخ أو الفلسفة أو علم النفس، حتى وإن كان موهوبا في هندسة السيارات أو البشر. ومن المؤسف أن علينا الاعتراف بأن كثيرا جدا من الذين يلتحقون بكليات الآداب - وربما غيرها من كليات العلوم الإنسانية- هم في الحقيقة من المغلوب على أمرهم، وأتوا إليها اضطرارا وليس وفق ميولهم ورغباتهم وقدراتهم. وهذا الأمر يعكس نفسه بشكل سلبي واضح على مستوى الأداء التعليمي في هذه الكليات التي يرتفع فيها معدل التسرب والرسوب لتلك الأسباب.
ضعف التدريب والتطبيق وتأخر الانتقال إلى المعرفة العملية
ولاشك أيضا أن إهمال كثير من كليات الجامعة للتدريب والتطبيق العملي، وعدم مبادرتها إلى تعديل خططها الدراسية - التي لا يزال يهيمن عليها الطابع النظري- بما يتناسب مع مختلف متغيرات العصر ومتطلبات سوق العمل والمجتمع والتنمية، لم يساعدا على تخفيف ضعف مستوى أدائها. ومن المعلوم أن أهم فرق بين التعليم الأساسي والثانوي وبين التعليم الجامعي يكمن في أن الأول يهدف أساسا إلى رفد الطالب بكم هائل من المعارف والمعلومات، أما الثاني - التعليم الجامعي- فيهدف إلى تأهيل الطالب في تخصص معيّن ليعده لممارسة تخصصه من خلال إكسابه المعلومات والمهــارات اللازمة لممارسته بشكل متميّز، أي أن الجانب التطبيقي والعملي في الدراسات الجامعية هو العنصر الأهم. لذا نجد أن كل كلية من كليات جامعة عدن تضم نيابة للتدريب الميداني وخدمة المجتمع. لكن من المؤسف أن الخطط الدراسية لجميع كليات العلوم الإنسانية وبعض كليات العلوم التطبيقية تهمل الجانب التطبيقي والعملي لأسباب كثيرة: عدم وجود المختبرات والمعدات والاستديوهات والمستشفيات الجامعية، وعدم قدرة الكليات على توزيع الطلبة في مجموعات صغيرة، وضعف تأهيل المدرسين. كما أن لوائح الجامعة تحسب كل ساعة عمل نظري بساعتين تدريس عملي. ولم يتم -حتى الآن- إلزام الأقسام العلمية بتحديد مساحة إجبارية للساعات العملية لكل مساق. كما أن طرق التقييم تعتمد كليا على الامتحانات التحريرية، التي لا ترصد بالضرورة مستوى إتقان الطالب للمهارات العملية التي اكتسبها خلال الفصل.
والمصيبة أن هناك اعتقادا - في كثير من دول العالم الثالث- يقرن الدراسات الجامعية بالصبغة الأكاديمية النظرية، ويبعدها عن واجب إكساب الطالب المهارات العملية التي تقرن بالتعليم الفني وليس الجامعي. ونتيجة لترسخ هذا الاعتقاد وضعف مخرجات الجامعات في العالم الثالث تشجع المنظمات العالمية دول العالم الثالث على الاهتمام بالتعليم الفني وإهمال التعليم الجامعي.
ومن العلوم أيضا أن أهم سمة للنسق التعليمي في عصر العولمة وثورة تقنيات المعلومات تكمن في الانتقال من اعتبار اكتساب المعرفة هو غاية التعليم إلى اعتبار استخدام المعرفة وتوظيفها هو الهدف الأساسي للتعليم. وهذا يعني التخلص من النزعة السلبية في التعامل مع المعرفة، والانتقال إلى إيجابية البحث والاستكشاف ومتابعة تطبيق المعرفة واقعيا من خلال التعامل مع المواقف والمشكلات الحياتية والعملية، أي تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة عملية. وتوظيف المعرفة عمليا يستدعي ربط المؤسسات التعليمية، لاسيما الجامعية، بالمؤسسات المجتمعية والإنتاجية. وفي اعتقادي أن التعليم لا يمكن إلاّ أن يستفيد من توطيد علاقته بسوق العمل. وهذه العلاقة لا تعني مطلقا أن على التعليم الجامعي أن يتنازل عن خصائصه البحثية والثقافية والتنويرية كما يزعم بعض معارضي إيجاد هذا النوع من العلاقات. فقيام علاقة وثيقة بين منظومة اكتساب المعرفة والنشاط الإنتاجي في أي مجتمع، من خلال القطاع الإنتاجي الخاص والحكومي، شرط جوهري لحيوية المنظومة، وتكريس دورها في رفع مستوى الإنتاج والدخل في المجتمع. ولا شك أن هذه الرؤية الحديثة للتعليم الأساسي والجامعي تؤدي إلى خلق التحام عضوي بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي من جهة ومواقع الإنتاج من جهة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك فهي تزيل تهمة (الاكتفاء بالطابع النظري الأكاديمي) عن التعليم الجامعي وتكسبه طابعا عملياً (تقنيا) يحميه من منافسة الأنماط الأخرى من التعليم. وهذا جعلنا نؤكد أن المعرفة تعد، في أحد أبعادها، رأسمال أو سلعة.
ومن المعلوم أن الجامعة كانت، ولا تزال، مؤسسة تسعى إلى تأهيل المنتسبين إليها من خلال إكسابهم المعرفة ومختلف المهارات اللازمة لاستخدامها وتوظيفها في خدمة المجتمع، والقيام بالبحث العلمي، النظري والتطبيقي.
أسباب اقتصادية مالية
ومن الواضح كذلك أن النظام العالمي الجديد، الذي يفرض على الحكومات، لاسيما في دول العالم الثالث، سياسة خفض الإنفاق على مؤسسات التعليم العالي، يقوم برسم ملامح جديدة لجامعة القرن الحادي والعشرين. فاليوم باتت الجامعات الحكومية تعاني كثيرا من تقليص ميزانياتها، وعليها أن تسعى إلى رفد ميزانياتها ماليا وإيجاد مصادر دخل ذاتية، وذلك ليس فقط من خلال فرض رسوم على الطلبة، بل من خلال اكتسابها سمة مؤسسة إنتاجية أو شبه الإنتاجية. واليوم على الجامعة أن تربط بشكل واضح بين المعرفة التي تقدمها والمردود الملموس لهذه المعرفة، وهذا ليس فقط في مستوى خدمة الأفراد والمجتمع، لكن أيضا من خلال دفع المؤسسة الجامعية إلى تسويق (منتوجها) أو رأسمالها العلمي- البحثي.
لذلك يبدو لنا أن مفهوم (الأداء) يأخذ دلالات مختلفة حينما نتحدث عن الجامعة. فالمستوى العالي لأداء جامعةٍ ما لا يقاس بمجرد حرص منتسبيها على تأدية واجباتهم على أكمل وجه. فاليوم صارت الحكومات والمجتمعات تحكم على الجامعة من خلال النظر إلى مدى النجاح الذي يحققه خريجو تلك الجامعة في مختلف نواحي الحياة العملية، ومدى نجاح الأساتذة في رفد المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية والثقافية والخدماتية بالأبحاث العلمية المفيدة. وكل هذه أمور تؤدي إلى إكساب الجامعة شهرة أكبر، وبالتالي إقبال أكبر للالتحاق بها عن طريق المنافسة أو عن طريق (النفقة الخاصة). وهذا يساعد الجامعات الحكومية على رفد ميزانياتها.
ومع ذلك نعود ونقول إن (ريعية) الجامعة تحتوي على بعض السلبيات؛ فربط الأساتذة/الباحثين الجامعيين بالمؤسسات الأخرى قد يكون في بعض الأحيان على حساب اهتمام هؤلاء الأساتذة بطلبتهم. وبما أن طريقة عمل الأستاذ – الباحث مع المؤسسة الإنتاجية يمكن أن يتوج ببراءة اختراع فمن الممكن أن يتحفظ الباحث في تقديم كل المعلومات لطلبته أولاً بأول. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي ربط البحث العلمي بتوظيفه مباشرة في المؤسسات الخدمية والصناعية إلى التركيز على نوع واحد من الأبحاث العلمية وهي الأبحاث التطبيقية، وهذا يؤدي بالضرورة إلى إهمال الأبحاث النظرية البحتة التي تعد الأساس الذي يُبنى عليه التطور العلمي.
ومن ناحية أخرى، ينبغي على المسئولين في الجامعات الحكومية في الأقطار العربية أن يفكروا كثيراً قبل الاتجاه إلى رفع حصة المقاعد المخصصة لطلبة النفقة الخاصة. فهذا الإجراء يمكن أن يكون على حساب الطلبة الذين لا يستطيع أهاليهم دفع حتى الرسوم الدراسية المطلوبة أصلاً من جميع الطلبة. ويمكن أن نشير هنا أن مصر، بملايينها السبعين، لا تزال تحاول توفير التعليم المجاني- حتى الجامعي منه – لجميع أبنائها وبناتها.
ولا ريب أن السنوات القادمة ستشهد اشتداد المنافسة بين الجامعات في جميع أقطار الوطن العربي. وستكون المنافسة في مجال التعليم مهمة ومفيدة؛ فهي، إن هي نحت منحى إيجابياً ستساعد على تحسين النوعية والجودة لمؤسساتنا الجامعية ومخرجاتها. وفي الحقيقة هنالك نوعان من المنافسة ينبغي لكل جامعة عربية أن تتصدى لها: منافسة بين الجامعات المحلية، ومنافسة بين هذه الجامعات المحلية من جهة والجامعات الأجنبية التي بدأ عددها يرتفع في كثير من الأقطار العربية من جهة أخرى. ومن المؤكد أن هذا الارتفاع، الذي يأتي ضمن توجه تلك الجامعات الأجنبية إلى تسويق (رأسمالها العلمي)، يمكن أن يخدم بلداننا العربية لاسيما أن معظم تلك الجامعات الأجنبية هي فروع لأكاديميات معروفة في أميركا وبريطانيا وفرنسا، وتستمد مستواها الأكاديمي من الخبرات الطويلة للجامعات الأم. وهذا يدفع الجامعات المحلية – حكومية وأهلية- إلى الارتقاء بمستوى أدائها من خلال إخضاعه للمعايير والمواصفات العالمية للجودة إن هي تريد البقاء.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر