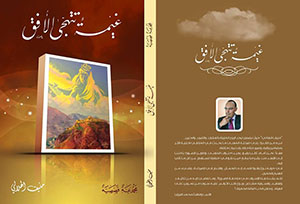- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

معاينة النصوص التسعينية بمقدار ما تؤشر على القطيعة شبه الكاملة مع مصفوفة المواضيع النمطية –خاصة المرجعيات الأيديولوجية والتجارب الجمعية أو إبداعات الوعي الجمعي- التي كانت تصبغ اشتغالات الأجيال السابقة فإنها في نفس الوقت تنفي تهماً أخرى أقلها التشابه فيما بينها، وانتساخ تجارب عربية وافدة.. فقد اتهم كتاب قصيدة النثر من التسعينيين اليمنيين بأنهم يقعون وقوعاً فجاً في تقليد نماذج منتجة عربياً، هي بدورها تقليد لنماذج منتجة غربياً... إلى جانب ذلك اتهموا بالتناسخ الصوتي والتشابهات النصية.. ولكنني أعتقد أن هذه التجارب في قصيدة النثر تظلم ظلماً فادحاً حين نطلق عليها حكماً كهذا.. إن هذا الحكم ليس جديداً إذ لم يتم سكه وإصداره لأجل تجربة التسعينيين اليمنيين في كتابة قصيدة النثر.. ولكنه سك لمجمل التجارب العربية خاصة في بلدان الريادة في كتابة هذا الشكل (الشام والعراق مثلاً) كما وجه للتجارب العربية البارزة رغم تباينها أمكنة وفترات زمنية..
إن معاينة هذه النصوص بقدر حقيقي من التجرد والحيادية والموضوعية ستثبت لنا دائماً أن أكثر تجاربها البارزة التي حققت حضوراً قوياً في الساحة الشعرية خلال السنوات الماضية هي تجارب تمتلك إلى حد كبير أساليبها الخاصة.. وتتميز بوعي يقيها مجرد التقليد الفج لتجارب انزرعت في أماكن أخرى وظروف مغايرة..
إن مقاربة نصوص التسعينيين اليمنيين من حيث مفارقتها للنماذج الناجزة عربياً.. خاصة النماذج التي تتهم هذه التجارب بالنظر إليها.. ثم مقاربتها من خلال التضمينات الثقافية الخاصة باليمن –أرجو أن أكون مصيباً في هذا التعبير- أيضاً مقاربة البصمات الشخصية لكل مبدع لنتبين ما إذا كانت هذه التجارب ذات خصوصية عامة أم لا.. ثم لنتبين ما إذا كانت هذه التجارب تتجاور أسلوبياً أم تتشابه؟ تذهب بنا دائماً إلى نتائج تدحض تلك الاتهامات التي لا تنتبه أبداً للتضمينات الثقافية وأثرها في لغة الشاعر وأسلوبه ومعجمه، وفي استراتيجية تعامله مع الكتابة الشعرية..
على سبيل المثال رصد النقاد في مجموعة محمد الشيباني الأولى ((تكييف الخطأ)) اتسام لغتها وتراكيبها بـ(اليباس والهروب من الجمل المألوفة)( )..وعنايتها بقراءة (الأماكن والأفكار قراءة حسية صادمة... أو تأملها تأملاً ظاهراتياً)..
ما لم يقله أحد أن الشيباني قارئ جيد... وأنه بلا شك يرصد تجربته ويقطرها بحزم من مجموع معارفه ووعيه.. لتكون في كل الأحوال تجربته الخاصة به.. فهي ذات تضمينات ثقافية واجتماعية يمنية واسعة تعكس وعي الشاعر وأيديولوجيته الخاصة به.. كما أنها من جهة أخرى تختلف أسلوباً وتناولات عن التجارب المجاورة لها بكل تأكيد.. ناهيك عن حضور الشاعر طفولة وشباباً ووعياً في النصوص بكل ما يمثله ذلك من إحالات مرجعية خاصة.
****
في هذا السياق فإن ما أنجزه التسعينيون في قصيدة العمود، سيبدو الأسوأ حظاً، فقد تم التعامل معها على افتراض أنها تُراِكُم خطياً ما سبقها في شكلها ولا تضيف شيئاً في مضامينها..
غير أن المعاينة.. لبعض نماذجها المنتجة إبان نهاية التسعينيات تثبت أن عموديات التسعينيين في اليمن تفارق إلى حد كبير مرجعياتها.. نقول هذا في حدود ما يتيحه لهم الشكل العمودي الموغل في الزمن، وفي اعتياد الناس على نماذجه العليا المنتجة في القرن العشرين وفي القرون السابقة.. فالمؤكد أن كتابها لم يكونوا ينظرون –دائماًَ- إلى الوراء.. إلى النماذج التي أنجزها أسلاف بعيدون أو قريبون.. وإنما كانوا ينظرون إلى الحاضر.. إلى الواقع المعاش – إن جاز القول- أعني هنا أن تلك القصيدة كانت تفيد من اللغة الجديدة التي تنكتب بها قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، وهي بذلك كانت تقدم للقارئ إضافات –بعيدة نسبياً- عما امتلأت به حافظته أو مخازنه القرائية.
أعرف أن أكثر من سؤال سيطرح نفسه... هنا...
أين هي تلك النصوص، ومن هم كتابها..؟
وهذا لا عجب فيه.. فتلك النماذج التي أصبحت الآن جزءاً من تجارب كتابها الذين تنوعت اشتغالاتهم على القصيدة بين العمود الذي تشبثوا به زمناً وهم يكتبون التفعيلة إلى جواره.. قبل أن يفارقوه/ يفارقوهما نهائياً إلى قصيدة النثر..
لم تُقرأ تلك النماذج مطلقاً من قبل كثير من النقاد الذين تتكرر مزاعمهم حول معرفتهم بكل ما كتب وما يكتب، والذين يصدرون أحكاماً قاطعة.. تؤطر كل ما يكتب في شكل معين بالتشابه والتقليد والاجترار والتراكم الخطي إلى غير ما هنالك.. مبررة لنفسها التخلي عن عناء القراءة والفحص مع ما يستلزمه كل ذلك من أمانة المعاينة بدلاً من المعايرة.. ناسين تماماً أنه كما أن قصيدة العمود اختلفت بعد الحرب العالمية الثانية كثيراً عما كانت عليه (تجلى الاختلاف أكثر في قصيدة نزار قباني) وأنها بعد نكسة 67م اختلفت أكثر فأكثر (نموذج البردوني) وأنها بعد 1990م لا بد أن تختلف بغض النظر عن وجود من لا يزال يكتبها على طريقة امرئ القيس..أو على طريقة البردوني أو غيرهما.
من المؤكد أن أحداً لم يلتفت لدراسة المنجز العمودي التسعيني لعدة أسباب.. منها: عدم دراية أغلب الناقدين المشار إليهم بتراث الشعر العربي وقطيعتهم معه.. وكانت نتيجة القطيعة شبه الكاملة معه تنعكس جهلاً بجماليات النص العمودي، وسمات تطوره التي كانت على مر العصور بطيئة التقدم قليلة الوضوح إلا للعارفين.. ولا يكاد يتبينها متوسط المعرفة إلا في اللحظات المفصلية الاستثنائية من تاريخ التطور الشعري.
بالنسبة للنص العمودي التسعيني هو نص يختلف بلا شك عن النص العمودي الذي كتبته أجيال الشعر في العقود السابقة بما فيها نص البردوني.. الذي وقع التسعينيون في غوايته بدون مماراة.. غير أن الحقيقة التي تثبتها نصوص التسعينيين العمودية هو اختلافها ومغايرتها حتى لنص البردوني.. وهذه المغايرة موجودة في بنية النص وفي صوره أيضاً.
لقد تخلت قصيدة التسعينيين العمودية عن المضامين الثورية والرؤيوية التي ميزت عموديات شعراء الأجيال السابقة –الحديث هنا عن النماذج الواعية المتقدمة لا عن عشرات بل مئات النماذج المجترة-.
قصيدة العمود التسعينية تخلت أيضاً عن الهيجانات الإيقاعية واللغوية وابتعدت كثيرا عن الضجيج والصخب.. وبرز فيها بقوة الإيقاع الشخصي لشاعرها الذي تتلامح فيه رومانسية ليست كتلك التي عرفت عند الرومانسيين اليمنيين والعرب قبل منتصف القرن العشرين من هيام بالطبيعة، وجنوح للتأمل والخيال والتشاؤم المريض، ولكنها رومانسية تستبطن الذات على نحو يذهب بالتجربة إلى التصوف، الذي أصبح مرجعاً ومتكئاً بديلاً عن الطبيعة والرموز الميثولوجية.. لذلك حلت مفردات التصوف مثل: الدهشة، المقام، السجادة، الصلاة، التهجد، المجاهدات، الروح، الخاطر، الوارد، المحراب، الدعاء، التجلي، المشاهدة، المكاشفة، الحضرة، الولي، الشهادة، الشاهد، القرب، الهيئة، المراقبة، الاصطفاء، الاستخلاص، البهاء، المعراج، الوجد، التواجد، التسبيح، التوق، الوله، الخشوع، الجهر، السر، الصحو، الركوع، الترتيل، الحيرة، اليقين، المدار، الإطراق، الفوات، الغياب، الحضور.. وغيرها محل مفردات الطبيعة وموضوعاتها التي كانت تحتفي بها رومانسية المهجريين، ثم شعراء الثلاثينيات وما امتد منهم حتى ستينيات القرن الماضي.من مفردات الطبيعة مثل: البراكين، البحار، الموج، الصخور، الضباب،السحاب و مجاوراتها كألفاظ: الأضواء، العطور، الخمور، الأطيار، الورد ، الضباب ، القيثار، الصليب وغيرها برمزيتها آنذاك؛ لأن مثل هذه الألفاظ قد ترد بلا شك في قصيدة العمود التسعينية بيد أنها ترد غالباً منفصلة عن تلك الرمزية.
لقد كانت رومانسية الثلاثينيات والأربعينيات مذهباً فنياً، وكانت في نفس الوقت حالة نفسية (تتدفق في إبداع الشاعر نغماً حزيناً وفكراً متشائماً نتيجة المرارة والخيبة، وفي أعقاب المحن والأزمات)( ).. ناهيك عن كون متكئها كان في الرومانسية الغربية بمدلولاتها الاجتماعية ومرجعياتها الفلسفية..
أما مايمكن أن نلمحه في رمانسية قصيدة العمود التسعينية فهو توسلها بالتجربة الصوفية طريقاً إلى التجربة الإنسانية المفعمة بالروح حيناً، وبالحسية المموهة أحياناً. وإذا كان شعراء الصوفية القدامى قد استفادو من مدلول الأنثى بصفته لغوياً إيحاء بتوالج العوالم والأكوان ولأوضاع والمواضيع وتناكحها قدراستفادتهم من ثيمة الغزل الحسي للوصول إلى أبعد منازل التجلي الصوفي، فإن قصيدة العمود التسعينية قد فعلت العكس من ذلك، فقد سعت من خلال الملفوظ الصوفي ومن خلال الاستفادة الواسعة من ثراء الدلالات التي يخلقها للحضور في كوامن النفس، والتعبير عن ذاتية التجربة وفرديتها والحضور كذلك في كوامن الأنثى..
إذاً فقد تخلت قصيدة العمود التسعينية عن الموضوع الوطني والقومي، والأيديولوجية السياسية والاجتماعية، كما تخلت عن الخطابية، وعن رسالتي التثوير والتنوير.. وفارقت المرجعية المألوفة للرومانسية، مجترحة لنفسها توجهاً رومانسياً جديداً ذي مرجعية ذاتية صوفية.. يبحث الشاعر من خلالها عن نفسه كمتحقق إبداعي ووجودي.. وهي بهذا تختلف عن التجارب الشعرية بأشكال استفادتها في الأجيال السابقة سواء في تجلياتها العربية أو في تجلياتها اليمنية..
إضافة إلى ذلك فإن قصيدة العمود التسعينية تؤشر على سمة من أهم سمات التعدد والتجاور في المشهد التسعيني اليمني.. فاختيارها للتصوف متكئاً تم مرتبطاً بالعودة إليه كدال بديل على الهوية.. الهوية التي لم تعد هوية جمعية اجتماعية ملزمة، بل الهوية الغير ملزمة.. ستجعل من ذلك المتكأ الصوفي.. متكأً ومرجعاً لذات الشاعر وحدها.. ولذلك فإن التعامل مع هذه الهوية.. يختلف ويتمايز من شاعر إلى آخر.. وذلك يعد مؤشراً حقيقياً على تبدلات واضحة في الاشتغالات الجمالية لهذه القصيدة، والانزياحات الغير هينة في الإحساس الجمالي عند مبدعيها، المنتمين غالباً لحواضن علم تقليدية ذهب زمانها أو بيئات ريفية قبلية، تحكمها ظروف اجتماعية وثقافية يمكن تفهمها..
لقد جمعت كتّاب هذه القصيدة جامعة صنعاء في تسعينيات القرن العشرين.. تسعينيات الحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يمنياً.. وهزيمة اليسار العربي والتيار القومي، وصعود التيارات الدينية السلفية إقليمياً.. وسقوط الأيديولوجيا وتغول العولمة عالمياً.. لذلك فإن هذه القصيدة بمقدار ما تعبر عن رغبة شعرائها في استعادة إحساسهم بذواتهم وأرواحهم.. وتوقهم إلى ما يحقق لوجودهم معناه.. تبدو إلى جانب ذلك مؤشراً إلى المدى الذي يمكن أن تلعبه المكونات الأولى..- المهد الأسري، المؤثر الاجتماعي، والأفضية المكانية - في تحديد استجابات بعض المبدعين القادمين منها لصدمات المكان الجديد والمفاهيم الجديدة، ثم المتغير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والثقافي والإبداعي بشكل عام..
ما يميز قصيدة العمود التسعينية أيضاً وجود بنية فيها تملك تشبعاً لغوياً يأتي من داخل القصيدة ومن تشابك علائقها.. فبالرغم من كونها تمثل الشكل الشعري العربي الذي يصعب عليه التخلص تماماً من الاتكاءات على إرثه الضخم إلا أن المناخ الذي كتب فيه قسم ممن لهم تجارب عمودية تسعينية، فرض عليهم تأثيث نصوصهم بتجاربهم المجاورة في كتابة النصين التفعيلي والنثري، وبتجارب زملائهم الذين اتخذوا من الشكلين الآخرين أو من أحدهما خياراً نهائياً.. وبذلك تكون قصيدة العمود التسعينية في قسم منها هو القسم الذي نعاينه –لا في مجموعها- تلتقي مع الأشكال الأخرى- جزئياً على الأقل- في النيات وفي التمثلات لكون هذه القصيدة غير منشغلة بالأغراض الموروثة أو بالنمطية المناسباتية أو الصراخ المنبري..




لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر