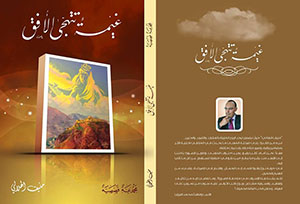- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

بصدور “ستيمر بوينت”، الرواية الرابعة للروائي أحمد زين، تدخل الرواية اليمنية انعطافة معرفية، وجمالية بالتوازي. إذ تعلي “ستيمر بوينت” (صادرة عن دار التنوير) من شأن النص الباحث عن هوية إنسانية راسخة ومتشظية معاً، بحيث يتجلى الرسوخ في المكان والزمان ويتضح التشظي في الوقائع والأحداث، التي تمارس غوايتها على المتلقي.
نعم ان يحفر النص أثرا في الذاكرة الجمعية هذا هو المفهوم الواضح لإمضاء العقل في تجليه التام. يقول محمد برادة: “كل محاولة يبذلها الإنسان هي من أجل تجميل ما في العالم من قبح”. وفي هذا السياق كان أحمد زين قد أصدر ثلاث روايات قبل هذه الرواية: “تصحيح وضع” ثم “قهوة أمريكية” و”حرب تحت الجلد”. وكل ما أود قوله بداية أن هذه الأيقونة الإبداعية لا تحتفي بالتاريخ ولا بالسياسة، قدر احتفائها بالسرد واللغة الشاعرية والتقنيات المبتكرة وتخييل التاريخ والسياسة، “فالأمم كيانات سردية”، على حد تعبير ادوارد سعيد. ولعلها محاولة معمقة لفهم الذات التي قال عنها بول ريكور “إن الهوية السردية هي البؤرة التي يقع فيها التأول والتمازج والتقاطع والتشابك بين التاريخ والخيال بواسطة السرد ”
“يموت العالم ويعرى إذا لم تقلع السفن من ميناء عدن” ص73. قد تكون هذه العبارة التي وردة في الرواية إحدى المفاتيح التي حركت مجاديف السرد، فمدينة عدن التي تقف على آخر نقطة من الوطن العربي جنوباً، هي عين النسر التي جالت في أحشاء المدن شرقاً وغرباً، وقد كانت كذلك إبّان الحكم الانجليزي بين عامي 1839م و1967 عندما استقلت عدن نهائيا. تصف الرواية اليوم الأخير لـ”التاجر الفرنسي” الذي عُرف في عدن باسم “البس” ولا يرد اسمه صراحة في الرواية؛ وإنما بصفته “التاجر الفرنسي” لأنه كما يبدو تعرى وجاع بعد أن أقلعت به الباخرة إلى بلد المنشأ، كعلامة تجارية زُرعت عن طريق الخطأ في تربة غير مناسبة. تُرى لماذا لم يورد الروائي اسم التاجر سوى بشكل غير مباشر؟
يبدو أن التاجر من الغرور الإمبراطوري بحيث انه لم يكن يرى أحداً في البلد الذي بنا فيها كل طموحاته، تلك الطموحات التي تشابهت مع طموحات الاستعمار الانجليزي لذلك افتتحت الرواية بهذا المطلع :”رآك، أخيراً.” ص7 المتحدث إلى نفسه هو الشاب والمقصود هو التاجر الذي وصُف في السطور اللاحقة بالعجوز أو التاجر العجوز، الذي سيلمحه كثيراً من خلال لعبة المرآة – التي يستخدمها الروائي كتقنية- وهو يندب حظه العاثر في آخر يوم له في عدن “28 نوفمبر 1967”. سينقل لنا الشاب عبر المرآة تفاصيل عصيبة للساعات الأخيرة من صدمة عدن. في هذه اللحظات التي تقف بين العقل والجنون، الموت والحياة، البداية والنهاية. يقول الفرنسي وهو يعيش الرعب بكل جوارحه “ما الذي يجري، أي شيء فضيع تقترفه عدن في حقي؟” إذ يترقب الثوار ينقضون عليه في أي لحظة. جاء الشاب- الذي اتضح بأنه سمير فيما بعد في حين ظل اسم التاجر مجهولاً- من مدينة الحديدة (شمال اليمن) بعد أن قطفت ثورة 26 سبتمبر 1962 والده هناك. يعمل الآن في منزل التاجر إذ يقوم على خدمته مزاوجاً بين نمطين من الحياة، حياة الأزقة والحارات التي يسكنها في منزل جدته بحيّ كريتر، وحياة العالم المخملي الأوروبي في منزل التاجر العجوز بحي “ستيمرت بوينت” التواهي لاحقاً.
يحيا هذا الشاب البسيط – الذي يبدو وكأنه الخيط الذي جذب شخوص الرواية- حياة ممزقة، فهو مغموس بطعم الحياة الشعبية وفي نفس الوقت مشدود إلى حياة الأوربي، لذلك فإننا نجده مشغول بكتابة مسرحية يتحدث فيها عن مزايا الاستعمار الانجليزي في عدن. وبالقدر الذي يحب سعاد، إحدى شخصيات الرواية، نراه منساقاً إلى الانجليزية آيريس، التي تخلت عن قومها وتعيش هائمة في عدن، مندهشة هي – أيضاً- بأناسها وعاداتها وتقاليدها وهو لا يدري أيعجبه من ملامحها الأوروبية الجسد المثير، أم شغفها بمدينته عدن.
سمير عيّنة من فئة ربما تكون حزبية رأت بأن المقاومة المسلحة ليست حلاً لإنهاء الاحتلال، وإنما الحوار هو الحل الأمثل خاصة وأن هذه الجماعة لم تكن تريد قطع العلاقة مع المستعمر، وإنما تبديل الإدارة الأجنبية بإدارة محلية وقطع الهيمنة الاستعمارية التي تمثلت بشخصية التاجر العجوز. إلا أن ظهور الماركسي “نجيب” وصاحب المقهى قاسم، التاجر الفاشل والعاشق الذي اختطف أحد الضباط الانجليز فتاته، كل هذا أوجد معادلة جديدة تدعو إلى الكفاح المسلح من أجل تحرير عدن. إضافة إلى ذلك ظهرت شخصية سعاد التي أُغرم بها سمير ولم يظفر بها، في إشارة إلى أنها جاءت بمعية نجيب وذهبت معه، نعم لقد ضاعت على سمير فرصة الاستفادة من الثروة الاستعمارية التي تكونت في أرض الأجداد، ذات الموقع الجغرافي الفريد.
وإجمالاً بدا لي أن الإسقاط السياسي لشخصيتيّ سمير ونجيب يتمثل في انتماء سمير لجبهة التحرير، بينما الانتماء السياسي لنجيب جسد طموح الجبهة القومية التي اضطلعت بمهام التوقيع على وثيقة الاستقلال. ولعل ما أريد التأكيد عليه هنا أن الرواية لا تتحدث عن الإسقاط بسذاجة وإنما هناك حديث مكثف عن السرد بتقنياته الحاذقة وفذلكاته المنطقية المهتمة بالخيال واللغة والروي المسبوك، القائم على تقنيات متجاوزة ممهورة بمقترح سردي وعبقري من نوع خاص.
***
ليست فكرة الرواية ذات بعد واحد ولكنها متعددة الأفكار والأبعاد، فما قد نعده صورة نهائية للفكرة نجدها بعد تكرار القراءة صورة متحولة لا تتوقف على شيء، وبالقدر الذي ركّز فيه السارد على شخصية التاجر – مثلاً- نجده أكد – أيضاً- على شخصية سمير ونجيب وقاسم وعدن المدينة الفردوس، التي أرى بأنها نافست الجميع على البطولة ما يشير إلى أن الروائي قصداً لم يحفل بالبطل وإنما سعى إلى تهشيمه. وفي رأيي أن حركية الصورة الكلية للمكان عدن- مَثّل الصيرورة المشتهاة للمعنى. عدن معطى تعلق بالذات اليمنية. أراد السارد أن نلتفت إليها كما لو انه خطاب نفسي عميق وذو دلالة، يدعونا فيه إلى الاهتمام بتخصيب الذاكرة وبالتالي استلهام النموذج ونقله إلى التاريخ. لأن كل رواية هي في الحقيقة تاريخ أو توثيق غزير للحظة، وهو ما نلمسه في التكنيك الفني المكثف داخل اللوحة الروائية “ستيمرت بوينت”.
لماذا عدن؟ للرواية بداية أخرى تفترق في ظاهرها عن محطة الانطلاق، التي استعرضت إرهاصات قلق التاجر من هجوم الفدائيين على قصره، في اللحظات الأخيرة قبل رحيله. البداية الثانية هي البداية الزمنية للرواية. فإذا كان الكاتب قد استخدم تقنية التكثيف لرصد اللحظات الأخيرة للتاجر، بحيث بدت الرواية بالمجمل وكأنها وصف حالة لا تتجاوز عددا من الساعات، فإنه أيضا أي الروائي استخدم تقنية الاسترجاع، أو الفلاش باك، فمكّن الرواية من الحركة لتتخذ بداية ثانية وصف فيها حالة عدن إبّان الحرب العالمية الثانية، حين كانت عدن مسرحاً للمتحاربين الكبار من أمريكيين وإيطاليين وبريطانيين ونازيين، وقد دفعت عدن الكثير، وامتدت المجاعة إلى كل بيت في اليمن. وكذلك الرمزية – التي رصدناها – في نكبة قاسم – أحد شخوص الرواية- النكبة الكبيرة التي ظلت تلاحقه إلى آخر الرواية وآخر العمر، فالفتاة التي أحبها اختطفها الضابط الانجليزي وذهب بها إلى انجلترا، مع أن الرواية لم تصرح بهذا الاختطاف وتركت التكهنات مفتوحة حول اختفائها، عقب رحيل الضابط بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فبقي يبحث عنها في كل مكان، إلا أنه لم يجدها مطلقاً. وهي رمزية تضاف إلى شفرات أخرى داخل العمل النصي.
بدت الرواية وكأنها وصف أمين للأمكنة، والتواريخ والشخوص في عدن، فليست محلية عدن هي التي خلقت عالميتها، وإنما لأن عدن مدينة عالمية بامتياز، وهذه العالمية كامنة في ذاتها. ثمة موقعها الجغرافي، وقدرتها العالية على صهر الغريب، والمختلف، ليصبح مألوفاً. تنبت المدينة في الرواية كما تنبت على ظهر الواقع وعبر الدهور والأزمان، إنها صنيعة التاريخ اليمني القديم. كان التاجر الفرنسي مغرم بأغنية لجاك بريل تقول:” لا تتركيني. أنا سأهديك، لآلئ من مطر. قادمة من بلد لا تسقط فيه الأمطار .”ص10, البلد الذي لا تسقط فيها الأمطار خلق إمبراطوريتين، الأولى إمبراطورية التاجر، والأخرى إمبراطورية الاستعمار ولعب دوراً هاما في تجميل العالم وأنسنته، وهو ما نلمسه في استعراض الروائي للعديد من الشخصيات النضالية التي مرت من عدن وأثرت على العالم.
ليست عدن في الرواية مدينة منفصلة عن اليمن وإنما هي رمز لليمن، والالتصاق بها لا يعني إلا أنها النموذج التاريخي للوطن المنشود. فالسارد إنما أراد أن يضع إحدى الحلول العملية لتجاوز ما يحدث، وبالتالي الذهاب إلى ما نسميه التعايش لأن معظم شخوص الرواية يمنيين، أو صاروا يمنيين مع مرور الوقت، فسمير – مثلا- الذي يمثل منتصف البؤرة الروائية ينحدر والده من مدينة الحديدة(شمال اليمن) وجدته التي يعيش معها تنحدر من عدن.
وأنا اكتب هذه الورقة حضرني السؤال التالي: هل تمثل عدن في الرواية مساراً من البحث عن اليوتوبيا ؟ أم إنها ذلك الفردوس المفقود والوطن المرتجى؟ إذا كان هذا الزمن الذي نعيش هو زمن الرواية على حد تعبير الناقد جابر عصفور، بحيث أنها حلّت محل المقولة الشهيرة عن الشعر بوصفه ديوان العرب، فإن رواية أحمد زين فعّلت العمل الروائي واستخدمت العديد من التقنيات في الرواية، ومن ذلك المرآة التي ساهمت في كشف الملامح الداخلية للتاجر العجوز الفرنسي ونقيضه الشاب اليمني. فالمرآة ساهمت في كشف المستور ليس في ظاهر الوجهين المختلفين فقط، وإنما امتد ذلك الكشف إلى مجاهل النفس. كان لابد أن تكون المرآة هناك، لكي يرى كل شخص نفسه كما يجب، وبالتالي رؤية الآخر وكأن الآخر كان يحتاج لتك المرآة لكي يراك، وهو ما أفصح عنه السارد بقوله :”تحولت شخصاً ثالث”ص103 .
***
تستند رواية ستيمر بوينت إلى صياغات وتقنيات تتوالد داخل العمل الإبداعي بسلاسة، ومن ذلك مداهمة القارئ بالعديد من الصدمات عبر نقل تفاصيل من الحياة والواقع. هناك من ينظر إلى الاستعمار بعين الرضا وهو ما يستفز القارئ ويثير غضبه، خاصة إذا قارنّا ذلك بالزمن السردي الذي تتحرك داخله الشخوص في تلك الحقبة، حيث كان الرأي يمضي باتجاه الانعتاق من ربقة الاستعمار. تتمثل الصدمة بما لحق عدن اليوم من إهمال مقارنة بتلك المرحلة الممتدة مابين 67-48 -على الأقل روائياً- ففي تلك الفترة الوجيزة ارتفع منسوب التحول داخل المدينة لتشهد ثورة عمرانية وتجارية واجتماعية غير مسبوقة. ولكن كما تشير شخوص الرواية لم يصنع الأجنبي ذلك من أجل اليمن بل من أجل تثبيت نفوذه على ظهر هذا المكان المدهش، حيث حُرم اليمنيون القابعون في الجبال والصحاري من التواجد في الشوارع النظيفة والبنايات الأنيقة، وقد شجع الاستعمار قيام المشيخات والسلطنات بعيداً عن عدن. يقول سمير موجهاً الحديث إلى سعاد:” انظري حولك أيضا، واحد وعشرون إمارة ومشيخة وسلطنة ” ص56. ما يشير إلى أن اليمن الموزع جنوباً على رقع الشطرنج مشغول بذاته، والاستعمار منشغل بالمال والثروة والنفوذ. وهو ما تحدثت عنه سابقاً، متجسداً في اختطاف الضابط الانجليزي للفتاة المعادل الموضوعي للثروة.
رسم السارد حيّ “ستيمر بوينت” بريشة فنان وبنفس الحرفية رسم حيّ كريتر، الذي يمتاز بأفق عالمي كوزموبوليتي، فهناك شارع لليهود وشارع للبوذيين وشارع للمسلمين وآخر للمسيحيين. والشارع في عدن أو الحي يسمى “حافة” وهذه الأخيرة مفردة شهيرة في عدن، كل تلك الهويات المتناقضة خلقت المجتمع العدني الفريد في الجزيرة العربية، الذي من أهم سماته التعايش والتسامح والسلم الاجتماعي. استطاع السارد أن يغوص في هذا الفضاء الطوبوغرافي مقدماً للقارئ لوحة فنية غير مسبوقة لعدن الأرض والإنسان والتاريخ. ولعل من الأحداث التي غيرت العالم وكانت عدن شاهدة عليها، ما وثقته الرواية هنا عن صفقة الإمام يحيى بن حميد الدين مع مهربي يهود اليمن إلى إسرائيل…حقاً لعدن ذاكرة مختلفة مع العالم خاصة في تلك الحقبة المبكرة. فهذا الزعيم المصري المعروف سعد زغلول يغادر عدن عام 1922 في مساء بارد على ظهر المدمرة الأمريكية “كلماتس” إلى جزيرة سيشل، “على قرع الطبول وأهازيج العدنيين يردد صداها جبل حديد” ص.39 . في الرواية نقاط التقاء كثيرة مع التاريخ ولكن بصيغته السردية، بمعنى الاحتفاء بالتاريخ عبر السرد، وذكر الوقائع ذات الصلة بعدن في سياقها العالمي. المنحدر من أصول هندية “أشرف” يحكي عن زيارة المهاتما غاندي لعدن 1930 عندما رست الباخرة “راجبوتانا” التي تقله. في ستيمر بوينت رفض النزول من على الباخرة محتجاً على عدم رفع علم المؤتمر الهندي بجانب العلم البريطاني. في تلك الزيارة هتف العدنيين “فليحيا غاندي ولتحيا الحرية والاستقلال. في حديقة الفرس خطب في الحشود. كان يلبس نظارة كبيرة، وساعة تتدلى بسلسلة يربطها في وسطه” ص139. “ليبان” إحدى شخصيات الرواية التي اضطلعت بتنامي السرد، ينحدر من أصول صومالية يتذكر زيارة الملكة اليزابيث الثانية عام 1954 “قال لهم أنها كانت نحيلة قليلاً، وتغطي شعرها بقبعة بيضاء. إنها تجولت في عدن، ووضعت حجر الأساس للمستشفى الذي سيحمل اسمها”ص.125 في الرواية حكايات كثيرة عن عدن، حكايات تنتمي إلى العصر الحديث، فحين كانت عدن ممتلئة بالأضواء كان العالم من حولها يتابع تحولاتها الكبيرة بإمعان، وقد كانت آيريس الانجليزية شاهدة على ذلك، وفي حديثها الأخير مع سمير قالت وهي تراقب المغادرين في المطار الذي ستنطلق منه:” إن المطار الذي هبطت فيه أول طائرة مدنية في الجزيرة العربية عام 1919، وشهد أول معرض للطيران الحربي في الشرق الأوسط وكان يضم أول قاعدة جوية في تاريخ مستعمرات الإمبراطورية البريطانية، ومنها تنطلق المقاتلات الحربية لسلاح الطيران الملكي البريطاني.. أضحى بلا نظام” ص161.
***
نقبت الرواية بصبر وأناة في عالم الأبهة الكولونيالية داخل المستعمرة عدن – كما نرى- وخرجت بعمل بحثي دقيق، استطاع الكاتب أن ينفخ في شرايينه الميتة لتحويله إلى عمل جدير بالقراءة المتأنية المحفوفة بالمخاطر. والواقع أن المتن الروائي لم ينزلق إلى التقريرية، على الرغم من كمية المعلومات التي توالت داخل الانثيال الحكائي.
لن نستطيع الإلمام بالكثير مما جاء في الرواية إلا أننا نحاول الاقتراب من ذلك، فهذا الراديو وتلفزيون عدن “معجزة العام 1964” حيث كانت المقاهي تفتح أبوابها للمرتادين من أجل مشاهدة “رتشارد كامبل ” الذي تطارده الشرطة دائماً عبر مسلسل يومي. وهذه دور السينما تعرض احدث الأفلام العربية والعالمية، ودائماً في شوارع عدن رجل يتنقل حاملاً لوحة تُعرّف بالأفلام التي ستعرض غداً أو بعد غد. وفي الصورة “القطار الذي ينطلق من المعلا قبل أن يتوقف العمل به قبل سنوات كثيرة واقتلعوا قضبانه، في طريق المملاح” ص166. زيارة المطرب المصري الشهير فريد الأطرش لعدن مثلت إحدى الأحداث الهامة عام 1956.
ثمة وصف أمين ودقيق للملامح العالمية الحديثة لعدن، وفي المقابل فقد امتد إشعاع هذه المدينة إلى الخارج، بل وكانت نقطة انطلاق إلى المشيخات والمدن الشمالية، فهذه رسولة ستالين إلى الإمام تريد تسليمه هدية شخصية عبارة عن عقار جنسي” 108. ولكي تصل صنعاء كان عليها الانطلاق من عدن. “مطهر” يعود من صنعاء إلى عدن بعد أن غادرها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويكون شاهدا على تحولاتها المدهشة. لم تكن عدن قبلة للداخل والخارج، ولكنها كانت قبلة للحلم، فقد تصارعت من أجلها النخب السياسية وكذلك النخب التجارية، ذلك الصراع الذي عبر عنه التاجر الفرنسي مع منافسيه “إن الورشة الكبيرة التي تحولت إليها عدن بعد الحرب، لا تزال مفتوحة. نشاط محموم لاشيء يستطيع الوقوف في طريقه”ص 94.وقد تشعب ذلك النشاط المحموم إلى خارج عدن البعيد. يقول احد أبطال الرواية “إلى أين تتجه عدن؟ ألا يكفي أنها أصبحت ثالث مدينة في العالم بعد نيويورك وليفربول” ص73.
في الأخير يمكنني أن أشير إلى أن فضاء الرواية نص مفتوح للقراءات المتعددة؛ وثمة تقنيات يستطيع القراء الوصول إليها وتفنيدها، والإفادة منها.
منقولة من مجلة نزوى..

لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر