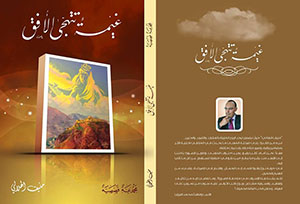- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

لا تصح مُعالجة علاقة الرواية بوصفها جنسا أدبيا بالتاريخ دون طرح بعض الأسئلة الإشكالية، التي تمس إحدى الخاصيات الأساس للأدب كما دُشن في العصر الحديث في ارتباطه الوثيق بالكتابة.
ويتعلق الأمر بالمادة التي يعتمدها الأدب موضوعا له. كما هو معروف؛ ففي زمان الأقوال الجميلة لم تكن المادة مُختلقة في الأغلب؛ إذ كان من السائد أن يستخدم التخييل في صنوفه المُختلفة ما تُوفره له الأساطير وغيرها من المآثر من مادة، سواءٌ أكان التخييل يعتمد شكلا له الشعر أم الدراما أم الملحمة. لكن الأدب قام على استخدام مُختلف؛ فقد كان من مهامه اختلاق مادته (موضوعه)، وعدم الاكتفاء بما هو موجود، بل ليس بمستطاع الأدب أن يستحق هويته التخييلية إلا بالمقدار الذي يُبدع فيه مادته من عدم؛ وبهذا كانت إحدى خاصياته الخلق. وكل خلق هو ضد التكرار، ولا بد أن تتوافر في بنيته المُغايرة. ولقد كانت هذه الخاصية الأخيرة حجة لدى إيزابيل دوني في رفض أن تكُون للرواية (لا الرواية التاريخية) ذاكرة تقوم على التكرار كما هو في الفنون الأخرى. فوجه الإشكالية ماثل- إذن- في التعارض بين الخاصية الأدبية هذه (ابتكار الموضوع) واعتماد الرواية التاريخية الأدبية على مادة مُتوافرة على نحو مُسبق، وغير مُختلقة. فهل يشفع لهذه الرواية فعلُ التخييل الذي يتمثل في عملية إعادة بناء الحدث التاريخي كي تنتمي إلى الأدب الذي لا يكُون أدبا إلا بوساطة خاصيتي الخلق والمُغايرة؟ لا يُمكن الحسم في هذه الإشكالية بنعم أو لا، بل بمحاولة إعادة وضعها في إطارها التاريخي؛ فليست الأنواع الأدبية في اتصالها بالجنس الأعلى (الأدب هنا) الذي يشملها قائمة دوما على مُراعاة شروطه على نحو تام، وإنما على نوع من الاقتراب والابتعاد، وفق رتبة مُعينة في سلم التماهي مع هذا الجنس الأعلى. ولا يُمْكِن فهم الإشكالية التي طرحناها في مُستهل هذا المقال إلا في هذا الإطار.
إن الرواية التاريخية كتابة كانت تقع في الوسط بين التخييل الأدبي والكتابة التي تتوخى قول الحقيقي، وكانت مُوزعة بين الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك، بما يعنيه هذا من تجديل يأخذ على عاتقه خلق نوع من التعاون بينهما. كما كانت تقوم في بدايتها بوظيفة تعليمية، وكان ألكسندر ديما واضحا في هذا الأمر حين توصيفه الرواية التاريخية. وتقتضي هذه الوظيفة من الروائي أن يخلص- في تناول المادة التاريخية- لما هو داخل منها في مجال الحقيقي أكثر من أن يخلص لما هو داخل في مجال التخييلي. والغاية كانت مُراعاة الذاكرة التاريخية الجماعية كما هي مصوغة في علاقتها بالهوية الوطنية أو القومية. ولا يكفي- هنا- التأشير على الوظيفة، فلا بد من الإشارة إلى الزمان الذي تأسست فيه الرواية التاريخية؛ أي القرن التاسع عشر، وهو قرن موسوعي بامتياز، إذ كان الأديب معنيا في عمله بأجناس أدبية مُختلفة، بل بحقول مُتنوعة من الكتابة، فلذلك ينبغي فهم التاريخ بوصفه معرفة مُفكرا فيها أدبيا في هذا الإطار. لقد أدى في ما بعد انتفاء سياق النشوء الموسوعي هذا بفعل ظهور عصر التخصص الدقيق إلى نزوع الرواية التاريخية إلى الانفصال عن وظيفتها الأصلية: التعليم المُمتع، ولحم الفرد بالذاكرة الجماعية، ومن ثمة بالهوية الوطنية أو القومية. وربما كان لهذا التحليل صلة قوية بما ذهب إليه جيرار جين جومبر من أن الرواية التاريخية لم تنعطف بقوة نحو التخييل السردي إلا في إطار اللحظة المُعاصرة بفعل انعطاف الكتابة التاريخية إلى مزيد من الصرامة العلمية.
ولكي يُتاح إمكان القبض على الفرق الدقيق بين الراوية التاريخية والكتابة التاريخية لا بأس من اللجوء إلى ما يستطيع اللسان توفيره من أداة في هذا الصدد، وأقصد بهذا استخدام الأداة «لو» التي تُفيد التمني مع وجود امتناع. فما الداعي- إذن- إلى التفكير في هذا الإجراء الذي يتصف بنزعة اختبارية؟ يمثل تبرير هذا الاستعمال في كون المُؤرخ لا يأمل، إذ ليس من مهامه إدخال الأمنيات في قلب المادة التي يُعالجها؛ فما تم في التاريخ قد تم، ولا سبيل إلى تغييره، والمهمة الأساس الملقاة على عاتق المُؤرخ ماثلةٌ في تفسير ما حدث، ولهذا ليس من شأنه أن يتساءل عما كان سيقع لو حدث عكس ما حدث في التاريخ، لو لم تسقط الأندلس مثلا، لو لم ينهزم بونابارت في معركة واترلو، لو لم تقع الحرب العالم الثانية. هذا هو الإمكان الذي يُتاح أمام الأدب، ويجعل من الرواية التاريخية تعنى بالتخييل، وتختلف عن الكتابة التاريخية؛ فبإمكان الروائي أن يفعل هذا، وأن يكُون بفعله هذا أكثر احتراما للشرط الروائي الذي يتأسس على الاحتمال. ويُوجد في رواية «حصار لشبونة» للروائي البرتغالي خوسيه ساراماغو مثالٌ جيد دال على هذا الإجراء؛ فالمُصحح ما أن يُدخل لا على المخطوطة يقلب الحدث التاريخي ويُغيره وفق لاوعي غير مُتحكم فيه؛ فالروائي شبيه- في علاقته بمادة التاريخ- بزائر قصر قديم لا يستطيع أن يتملى مُحتوياته إلا من خلال عين مُعاصرة من دون تملك المعيش المُعاصر له (القصر)، ومن خلال الحضور الحالي الخاص به في زمانه. وهذه العين المُعاصرة هي مُركبة، يتداخل فيها اللاوعي مع سؤال الهوية، بما يعنيه هذا من مُحاولة إضفاء التماسك على ذات يضنيها الخوف من الزوال.
كما أن عينه لا تتصل بالماضي إلا عبر توسط مرويات مكتوبة أو شفهية. فتصور الماضي في الأدب المُعاصر مُختلف عما سبق من التصورات التي شملته فيما قبل بالاعتناء؛ فهو قابل اليوم لأن يُمرر من خلال الوثائق، والأرشيف، والشهادات، ومن ثمة فالزمان الماضي لم يعد كما كان من قبل مُتسما بقدر من البساطة والوضوح، بل صار مُركبا ينبغي وضعه على مسافة.
يحتاج التفكير في الرواية التاريخية أيضا إلى مُساءلة مُمكنها التخييلي في ضوء إشكالية أخرى لها أهميتها في تبصر تشكلها الجمالي. وتتعلق هذه الإشكالية بالعلاقة بينها والذاكرة الجماعية. فكيف يُمْكِن تفكرها في ضوء الهوية، وفي ضوء تخييل علاقات القوة في بناء هذه الهوية. هذا ما سنسعى إلى مُعالجته في المقال المُقبل انطلاقا من مُناقشة تصور جان بسيير الذي بلوره في صدد هذه الإشكالية.
٭ أديب وأكاديمي مغربي
منقول من القدس العربي ...
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر