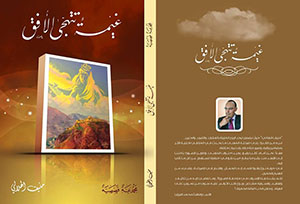- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- «المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال» ينطلق في دبي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية
- من الكاميرات إلى اللاسلكي.. كيف تتبعت إسرائيل القادة الحوثيين؟
- «الشاباك»: إحباط شبكة تهريب أسلحة وأموال من تركيا إلى الضفة لصالح «حماس»
- التحويلات المالية تتجاوز النفط كمصدر أول للعملة الصعبة في اليمن
- أحمد السقا يدافع عن مها الصغير: وقعت في خطأ غير مقصود بتأثير المحيطين
- راغب علامة: نصحت فضل شاكر بتسليم نفسه وليس لدي كراهية له
- الثالثة خلال شهر.. ضبط شحنة مخدرات بـ130 مليون دولار في بحر العرب
- 6 أطعمة تتفوق على التمر في محتوى الألياف الغذائية
- واشنطن: «حزب الله» يعيد التسلّح والجيش لا يقوم بعمل كافٍ
- حبس اللاعب رمضان صبحي على ذمة محاكمته في قضية تزوير

لقد طال التجاوزُ التفكيرَ في الجنس الأدبي من منظور وجوده أو عدمه؛ فإشكاليته أعمق بكثير من الدفاع عن مشروعيته الأَنطولوجية. والقول بهذا نابعٌ من سببيْن:
أ- انتهاء السياق التاريخي الذي أنتج ظهوره بوصفه إشكالا تاريخيا، لا بوصفه اصطلاحا.
ب- لا يُمْكِن التفكير في هذا الإشكال- حتى لو تحيزنا داخل هذا المنظور أو ذاك- إلا من زاوية تاريخيته، والأنساقِ المعرفية التي كانت تعمل خلفه.
أما في ما يخص الأفق فلا ينبغي التفكير في هذا الإشكال إلا من خلال الإضافة التي تفتح التنظير على زوايا لم يتنبه إليها. لكن مهمتنا في هذا المقال غير مُحددة في صياغة هذا الأفق، بقدر ما هي نزوعٌ نحو توضيح ما يتخفى من أساس معرفي وراء التعارض بين المُناداة بضرورة التنظير للجنس الروائي (وبالطبع الأنواع المُنضوية تحته) انطلاقا من المعيارية، ورفض تقويضها (بما يعنيه هذا من توتر بين النص الفرداني وشبكة المعايير، لا بين النوع والجنس) والمُناداة بكون الرواية جنسا أدبيا مفتوحا لم يكتمل؛ أي أنها لم تكتمل بعد، بحكم كونها تنتمي إلى الخطابات الأدبية- لا الأقوال الجميلة- التي شكلت السياق الذي نشأ فيه كل من مفهوم الأدب بعد القرن السادس عشر (بيير ما شيري: فيم يُفكر الأدب؟)، وإشكالُ الجنس الأدبي في اتصال بتحول اللغات القومية الشفهية إلى لغات رسمية (سنُخصص مقالا لتوضيح هذه المسألة وحل التباسات كثيرة واردة حتى في الفكر الأدبي الغربي).
نحن- إذن- أمام منظوريْن مُختلفيْن في فهم الرواية وإشكال المعيارية، لا أمام منظور واحد، ولا يُمْكِن لمُنظر الرواية (حتى المُبتدئ) أن يقفز عليهما، حتى لو كان يُريد التعبير عن رأيه الخاص، فلا بد له من تأطير هذا الرأي في سياقه الإشكالي، وإلا عُد عمله غيرَ مُكتمل، أو من باب العمل بفضيلة الحكمة المُهيمِنة على الذهنية العربية حتى في مجال العلم «كم حاجة قضيناها بتركها».
ما المنظوران المعرفيان اللذان يكمنان خلف هذا التعارض في النظر إلى الرواية على مُستوى المعيارية: ضرورتها أو نفيها؟ أظن أن بعض الإشارات المُفيدة- في هذا النطاق- موجودة عند روبرت مارتس في كتابه «أصول الرواية ورواية الأصول»، وعند جوليا كرستيفا في كتابها الشهير «نص الرواية». ومن الأكيد أن الأمر يتعلق بالمبدأ التكويني الذي يُؤسس توجهات الفكر الغربي في النظر إلى الكون وفهمه، والماثل في التراوح بين طرفي الثنائية (الثبات/ التغير). ويُمْكِن- في هذا الإطار- ربطُ التوجه الفلسفي والنقدي الذي يُنظر للإجناس الأدبي (وضمنه الرواية) انطلاقا من الحرص على مبدأ المعيارية برؤية إلى الكون تتصف بكونها مُتجانسة وتضع في صلب تفكيرها وحدته، بما يعنيه هذا الأمر من تماهٍ وتكرار وتسوير هوياتي كلي وكوني. وإذا ما عانى هذا المنظور من التغير الذي يُلاحظه من حوله أرجعه إلى وحدة مُتعالية خفية تُلجم حركة التاريخ.
كما يُمْكِن ربط التوجه الفلسفي والنقدي الذي يُجهز على معيارية الجنس الأدبي أو على الأقل يجعلها قابلة للتقويض، وربط التوجه القائل بعدم معيارية الرواية (ميخائيل باختين: «جمالية الرواية ونظريتها»)، برؤية إلى الكون قائمة على تغليب نزعة التغير والتعدد، وما يرتبط بهما من هجانة، وانفتاح غير محدود على كل الخطابات الأدبية ونصف الأدبية. ويتضح من هذا التوصيف النظري أن التوجه الأول يتصل بفلسفة الثبات، بينما يتصل التوجه الثاني بفلسفة التغير. لكن ينبغي التنبه إلى ما أسسه باختين في كتابه الرائع «أعمال فرنسوا رابلي والثقافة الشعبية» من جدلية بين الموت والحياة في الكرنفال الذي يُعَد الإنتاجَ الرمزي المُعبر عن الثقافة الشعبية. لماذا؟ لأن هذا الأخير يُعَد- حسب ميخائيل باختين- أحدَ الأصول الرئيسة التي تُكون الشكل الروائي، وتُوجه حياته في الزمن؛ ومن ثمة فهو شكلٌ يحمل في بنيته تلك الجدلية بين الموت والحياة، لا بوصفهما حديْن يتعاقبان أو يتراتبان، الواحد بعد الآخر، لكن بِعَدهما يعملان في الآن نفسه ويتداخلان في عملهما. وإذا كان باختين يربط هذه الجدلية بين الموت والحياة بتجدد عناصر الكون فالشكل الروائي يعمل بمُوجب المنطق نفسه؛ إذ هو صيرورة مُنفتِحة على التجدد، وعلى التجديل بين ما استنفد مهامه (الموت) وما يلوح في الأفق في هيئة إمكان جدة (الولادة).
يمكن افتراض صيرورة من التجديل أخرى بين الثبات والتغير إلى جانب الجدلية الباختينية المذكورة أعلاه، لا بغاية إقامة نوع من التسوية بينهما، وإنما بقصد الرؤية إلى مُمْكِن كل طرف منهما من مُمْكِن الطرف الآخر. ولا بد لنا في هذا النطاق- وكما أشرنا في إحدى مقالاتنا السابقة – وجود بنية من التمثيل خاصة بكل جنس على حدة، وتتصل هذه البنية من جهة بصيغ إمكانية مُهيكِلة للتعبير الإنساني (لايبنتز)، ومن جهة ثانية بالتمثيل في بعديه: أ- الميتافيزيقي (استهداف غير المتناهي في الشعر). ب- الملموس- الحسي (استهداف المتناهي كما هو الحال في الحكي، لا السرد الذي لا يُعَد مقولة إجناسية). ويُضاف إلى هذيْن البُعْدَيْن بُعْدٌ ثالث يتمثل في التجديل بينهما (كما هو الحال في الدراما). ويُمْكِن عَد النوع الروائي (استنادا لمفهوم النوع عند أرسطو في علاقته بالهوية؛ حيث يُعَد وسطا بين المادة والجنس، أو وظيفةَ شكل) بمثابة تنويع تاريخي على بنية التمثيل، بينما يعد النص مجال تراكم التغير أو التحول حيث البعد المادي واردٌ بكل تأكيد.
تظل المُشكلة قائمة مع ذلك، خاصة حين نُفكر في كيف تُتعرف الهوية الإجناسية للإنتاج الأدبي ونوعيته. ما الذي يجعل الكاتب الذي لا يتوافر له الاطلاع على مُشكلات الأدب الإجناسية، والقارئ أيضا، يتعرفان هوية هذا النص أو ذاك بوصفه ينتمي إلى هذا الجنس، أو إلى هذا النوع؟ وتزداد المُشكلة حدة حين يتعلق الأمر بالرواية؛ فلا شك أن سؤال الذاكرة الأدبية واردٌ هنا بكل تأكيد، ولا ينبغي أن ننسى أن عددا ممن نظر إلى الجنس الأدبي عده ذاكرة، أو مُماثِلا لها. والنقاش مطروح في هذا الاتجاه، سواء اتفقنا أم اختلفنا. ويُتخذ من تكرار الخاصيات الجمالية معيارا أساسا في صياغة الأسئلة المُتعلقة بهذا الجانب كما هو واردٌ عند إيزابيل دوني. وسنُخصص المقال المُقبل لمُناقشة هذا الطرح.
أديب وأكاديمي مغربي
منقول من القدس العربي ...
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر