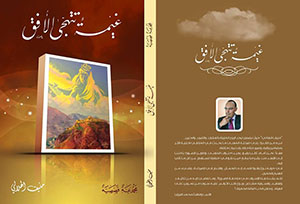- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو
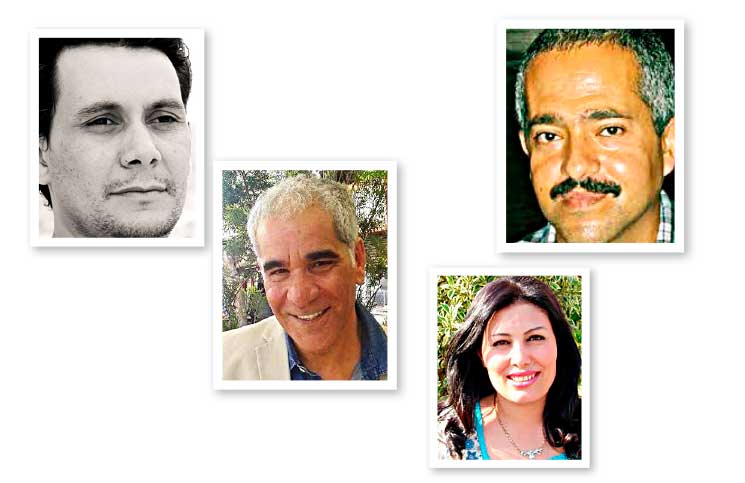
كتب الأمريكي هنري ميلر (1891 ـ 1980)، في مفتتح روايته «ربيع أسود»: «أنا إنسان وطني، من الحي الرابع عشر في بروكلن، وهناك نشأت. باقي الولايات المتحدة لا وجود لها بالنسبة إليّ إلا كفكرة، أو كتاريخ، أو كأدب».
ميلر الذي وُلِد في نيويورك، وقضى طفولته في بروكلن، وثّق للحي الذي نشأ فيه، في الكثير من أعماله الروائية، وجعل المكان من ضمن أبطال رواياته.
يقول الشاعر العربي أبو تمام: «كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتي / وحنينه أبداً لأول منزلِ».
وكما في حالة هنري ميلر، تحضر البيوت الأولى، وأحياء الطفولة، في أعمال الكثير من الكتّاب العرب، تحضر بوصفها كما كانت، أو تحضر مموّهةً وخاضعة لعدسة المنظور الجمالي والتخييل، ومناورات الذاكرة، لا يهم كيف تحضر، والمهم فعلياً هو ذلك الحضور.
على عكس الشعر، للفضـــاء المكاني أهمية في السرد بشقيه الروائي والقصصي، ســواء كان ذلك المكــــان معــرّفاً أو مجهّلاً.
وتنشر هنا شهادات لمجموعة من الروائيين العرب، حول بيوتهم الأولى، وبيئات الطفولة وتفتح الوعي، وكيفية حضورها في أعمالهم الروائية، عبر جسور عدّة: الذاكرة، والحنين، والهروب من النسيان او حتى تصفية الحساب مع المكان الأوّل.
محاولة لإنقاذ «بيت طفولتي» من النسيان
وجدي الأهدل ـ روائي يمني
«بيتنا القديم نعم، بيت طفولتي حضر بصورة خاطفة في روايتي الثالثة «فيلسوف الكرنتينة». بطل الرواية يفقد وعيه في شارع عام ثم يجد نفسه في بيت أناس لا يعرفهم. في سنوات الطفولة كنا نتردد على شقة يسكنها أقارب لنا، تلك الشقة انطبعت تفاصليها في ذهني، ولاحقاً عادت للحياة في رواية «بلاد بلا سماء». في البداية لم أنتبه إلى أنني كنت أستعيد ذكرى تلك الشقة، لكن بعد صدور الكتاب، ومن خلال النقاش مع الأصدقاء رأيت تلك الشقة بعيونهم ففهمت ما يحدث.
اشتغل حالياً على رواية تدور أحداثها في البيت الذي عشت فيه منذ ولادتي وحتى سن الثانية عشرة. ليست سيرة ذاتية، ولكنها محاولة لإنقاذ «بيت طفولتي» من النسيان. بطل الرواية سوف يحل محلي في ذلك البيت، لقد أعرته إياه، ولقد غمرتني السعادة حين حل ضيفاً في بيتي القديم. لا أعرف لماذا اختار بطل روايتي المقبلة أن يفعل هذا الأمر، ولكنني شعرت بأن ثمة شيئاً ناقصاً في طفولته، وأنني إذا لم أُقدم له «بيتي» فإنه سيعاني من التشرد، وسوف يضطر إلى حجب طفولته عن أعين القراء. يحتاج الروائي إلى قدر هائل من المواد لتشكيل عوالمه الروائية، وبالنسبة لي فقد ادخرت «بيت طفولتي» للرواية التي أشعر بأنها قريبة من عوالمي النفسية والفكرية. ثمة ترابط بين المكان والحكايات التي جرت أحداثها فيه.. وعندما أفكر في «بيتنا القديم» فإن الذكريات تتداعى الواحدة تلو الأخرى كثمار ناضجة تتدلى من شجرة وما عليّ سوى مدّ اليد لقطافها. لذا أجد صعوبة في انتزاع ذكريات الطفولة من مكانها الأصلي وسردها في سياق يجردها من جغرافيتها. وعندي وجهة نظر ـ وقد لا يتفق معي كثيرون حولها- أن المكان جزء لا يتجزأ من الحدث الذي يجري فيه، وأنه يفرض شرطه على صانعي الحدث سواءً انتبهوا لذلك أم لم ينتبهوا. وإذن لا يمكن أن يحدث ذلك «الحدث» لولا أنه حدث في ذلك المكان بالتحديد».
عن جنّيات النهر..
منصورة عز الدين ـ روائية مصرية
«النيل أو أي مكان قريب منه هو بيتي الأول، ليس في الأمر رومانتيكية ما، تلك كانت الجغرافيا التي تفتحت عليها عيناي. بيت جدي لأمي كان قريبًا من النيل. من شرفته كنت أرى النهر وأشعر به في قبضة يدي أراقب أشجار الصفصاف المائلة على مائه وطيور الإوز العراقي وهي تحلق فوقه. كان المحفز الأول لمخيّلتي بحكايات الجدّات عن طوفانه المغرق لكل شيء قبل عقود، وبسكونه المخادع وجنيّاته اللاتي كنّ جزءاً من تفاصيل واقع خرافي يتعامل معه الناس بمنتهى الجدية كأنه حقيقة لا تقبل الجدل. بيتي الأول لم أعش فيه، بل لم أبصره كونه هُدِم قبل مولدي. عرفت به من حواديت الكبار مختلطاً بالسحر والأساطير. بيت يطل أيضاً على النيل، تصدر منه أضواء غامضة ليلاً، وفيه غرفة مغلقة ينبعث منها إنشاد ديني وأصوات حلقات ذِكر، أو هذا على الأقل ما كان متداولاً عن البيت القديم لجدي لأبي وأنا صغيرة. في سنواتي الأولى كنت أعيد هذه الحكايات كأنني عشتها، ومعها وصف دقيق للبيت القديم سمعته من عمي، فملأ ذاكرتي الطفلة بالوهم. كنت مصرة على أنني عشت في البيت وأحمل ذكريات عنه، وغضبت حين أكدت لي أمي أنني ولدت بعد هدمه بسنوات. المسألة هكذا دائماً، بشكل ما تؤثر الحكايات والكلمات في مخيلتي وذاكرتي بتأثير الواقع المعاش نفسه. وأحياناً تكون أكثر تأثيراً. السرايا في «متاهة مريم» متخيلة بالكاملة، وليدة الكلمات وحدها، ومع هذا أشعر كأنها بين بيوتي الحقيقية، كأنني عشت فيها وسرت في ممراتها ودهاليزها، وأكاد أرسم خريطة حديقتها في ذهني. وعلى المنوال نفسه البيت الأبيض في «وراء الفردوس» ليس بيتاً حقيقياً عشت فيه، وقرية «وراء الفردوس» ليست قريتي حتى إن تشابهت كثيراً معها في عزلتها وصغرها واحتضان النيل لها وتحولها العشوائي من الزراعة إلى التصنيع. هذه الرواية، أكثر ما كتبت ارتباطًا بالواقع الاجتماعي المصري، ويلعب المكان فيها دورا رئيسيا، لأنني أثناء الكتابة حاولت إحياء مكان زائل بخرافاته ونباتاته وتحولاته العنيفة. القرية في الرواية بلا اسم، ربما لأنها تمثل قرى أخرى عديدة منسية على امتداد مسار النيل. الاختراع لا غنى عنه حتى لو كان جزئيا لأنه يتيح حرية حركة وحرية لعب أكبر. وفي النهاية أشعر بأن البطل الأول في «وراء الفردوس» هما الذاكرة والزمن لا المكان رغم مركزية الأخير. في «متاهة مريم» انقسم المكان بين شوارع القاهرة التي ظهرت كمدينة متاهية وبين سرايا التاجي، وفي «جبل الزمرد» تعددت الأماكن بين المتخيل بالكامل والواقعي الأجنبي الذي سبق لي زيارته، أو الذي لم أزره قط، وجمعت مادة عنه أكملتها بالتخييل. أظن أنه مثلما يقترح المكان ثيمات وأفكارا على الكاتب ويؤثر أحيانًا على طريقة الكتابة، فإن فكرة العمل وطموحه الفني يحددان بدرجة كبيرة طريقة تناول المكان الروائي وزاوية النظر إليه».
تصفية حساب مع المكان
خليل صويلح ـ روائي سوري
«خلافاً لروائيين آخرين، كتبت أربع روايات تدور وقائعها في دمشق، قبل أن أعود القهقرى إلى مسقط الرأس. كان نصّاً مؤجلاً، أو أنه كان يتسرّب بجرعات متفاوتة في متن النصوص الأخرى على هيئة شذرات تلقي بظلالها على الراوي، الذي ما انفك يعيش حيرته بين بيئة بدوية أتى منها باكراً وانخراطه بصخب مدينة مثل دمشق. في روايتي الأولى «ورّاق الحب»(2002) استعادة جزئية للمكان الأول، ومحاولة الاستفادة من هندسة البيوت الطينية في بناء معمار روائي. أقول هندسة مجازاً، ذلك أن تلك البيوت كانت تنهض في الخلاء بمشيئة الحاجة إليها، وإذا بها تتوالد بفوضى: المطبخ إلى جانب حظيرة البهائم، وغرفة الضيوف إلى جانب مستودع القمح. هذا التشظي انعكس على استدعاء سرديات متجاورة في النص نفسه، وكأن المكان هو زمن سائل يستدعي وجع الذاكرة على هواه. بالنسبة لشخص مثلي ولد في الصحراء، يصعب عليّ استذكار مكان راسخ، فمن بيت مصنوع من شَعر الماعز، إلى بيت طيني، إلى بيت بغرف واسعة يحيطه بستان (بيت جدّي لأمي الذي قضيت بين جنباته طفولتي في المدرسة الابتدائية)، إلى غرفة مستأجرة في مدينة الحسكة لدراسة الإعدادية، سوف يتفتت المكان كما لو كنت في عاصفة رمليّة. هكذا تأجّلَ حضور نص المكان الأول كثيراً، وحين هطل فجأة مثل مزنة مباغتة، كان بمثابة تصفية حساب مع حقبة لطالما نأيت عن تدوينها خشية تسرّبها بما لا أشتهي. روايتي «سيأتيك الغزال» (2011) أتت بما يشبه سيرة ذاتية لذلك الفتى الذي غادر صحراءه باكراً، وها هو يعود إليها بكامل عطشه مستعيناً بسلفه الأخطل كعتبة أولى للكتاب «حيّ المنازل بين السّفح والرّحب/ لم يبق غير وشوم النار والحطب». هكذا كان الطين والإسمنت يتناوبان في تأثيث نصّي، قبل أن يطيح الجفاف ثم التصحّر المكان الأول الذي لم يبق منه سوى صبي يقود دراجة هوائية قبل أن يضيع في عاصفة رملية. عموماً، ليس هناك مكان أول فقط، إنما أمكنة أولى، نستعيدها بسرديات مختلفة بقصد ترميم ما غاب عنها في النسخة الأولى، وفقاً لتوقّد الذاكرة واشتعالاتها. لاحقاً ستحضر صورة طفل يجلس أمام عتبة بيت طيني، يحيط به الموتى الذين خرجوا من المقبرة وهم يطالبونه باستعادة صورهم الفوتوغرافية التي ضمّها في أول ألبوم صور اقتناه في حياته، وهو يحلق ذقنه أمام المرآة، على بعد أمتار من صوت القذائف!»
الحنين إلى المكان الذي أعرفه
إسماعيل يبرير ـ روائي جزائري
لم أراهن على الإنسان الذي أكتبهُ (وهو العربيّ، الجزائريّ غالباً) رهانا كاملا، لم أفعل بسبب نقصانه، وليس لقلّة حيلتي، بقدر ما هو قلة حيلة هذا الإنسان الذي يعنيني مأزقهُ الوجوديّ.
الإنسان العربيّ ـ في رأيي القاصر- لم يكتمل وجوديا عبر عقود متتالية، منذ مطلع القرن التاسع عشر وهو يواجه صدمات متتالية تأتي على وجوده، تشكّكهُ في الأرض التي يقف عليها، وتسلّمهُ إلى مسلّمات ويقينيات تغتصب الحقّ أو الرّغبة في التفكير وبالتالي في التغيير، ربّما لهذا فإنّ المختلف في العالم العربي كان يناقشُ على الدوام في القرن التالي؟ وربّما بسبب توقنا إلى التاريخ الذي نتخيّله أكثر ممّا نعرفه.
لأجل هذا جاءت حيلة الكتابة عن المكان كممكن وشاهد مع هذا الإنسان، إذ سيكون شكل وروح ووجهة الروايات كلّها متشابهة لو راهنت على إنسان متأزّم، وربّما ستكون روايات تراهن على الحكي لا على فعل الكتابة، روايات ملتبسة تملك التقنية المكتملة أحيانا، والإنسان المنقوص الذي يختفي خلف النموذج السّردي الغربيّ الأمثل. كتبت عن المكان بضيقه، وفسّرت عبره الإنسان الذي يشغلهُ، ومنذ روايتي «باردة كأنثى» وأنا أستجدي المفاصل والزّوايا التي تنتبه إليها عين «الرّائي» قبل «الرّوائي»، هذا الرّائي هو ذاته مقوّم السّرد لديّ، وحارس تجربتي المتواضعة، ففي رواية «وصيّة المعتوه، كتاب الموتى ضدّ الأحياء» كنت مسكونا بحيّ منسيّ بين ثلاث مقابر وسجن ووادٍ، وكان الفضاء هو البطل، وفي روايتي الأخيرة «مولى الحيرة» رحت أفسّرُ بكثير من الشّغف تغيّرات التاريخ والسياسة والمجتمع في بلادي، كلّ ذلك عبر التجوّل في حيّ «القرابة» بمسقط رأسي مدينة الجلفة.
ستون سنة تخيلية من التجوّل في أزقة الحيّ العتيق منحتني رواية «مولى الحيرة» بحمولاتها التي تدور حول التجارب السياسية المختلفة التي مرّت على الجزائر، حالات الإنسان الذي يؤثّث الجزائر في العقود الستة الأخيرة، وكذا أفق وأحلام هذا الإنسان المتوتّر مثله مثل فضائه العربيّ. وحتّى روايتي «ملائكة لافران» كانت بحثا عن المكان بشكلٍ مقلوب، إذ راهنت عن الإنسان التائه.
لا أزعم أنّي أكتب مجرّدا من النوستالجيا، فكلّ نصوصي تتكّئ بوقاحة فجّة على الحنين إلى المكان الذي أعرفه، وتخدمني عين الطّفل الذي يسكنني، كــــم كان ملاحظا مقتدرا على رصد كلّ ما يعبرهُ؟ بينما العالم الكبير يكرّر ذاته الفشل في إغفـــال الحصـــى، هكذا جمّعـــت عشرات، بل مئات، بل آلاف الصُّور عن المكان بينما كنتُ أغيّرُ وجه، وجود ونوع الإنسان، أليس هذا بحدّ ذاته حلّا نمــــوذجيّا لحفظ المكان، لاقتراح نمطنا السرديّ وأيضا لدراسة التطــــوّر والتغيّر الذي يطرأ على الإنسان؟ لست أدعــــو إلى تقديـــس المكان دون الإنســـان، لكنّ الرّواية التي يمكن أن تحذف منها الأسماء العربية وتغيّرها بأســــماء هندية أو صينية وتقرأ دون خلل، هي بالتأكيد ليست رواية عالمية، إنها رواية بلا هويّة.
منقولة من القدس العربي ..
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر