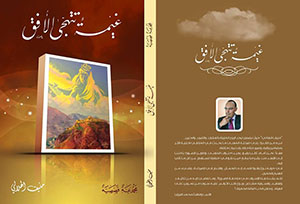- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟
- خبير نفطي: تأثير التطورات في فنزويلا على أسعار النفط محدود على المدى القصير
- الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا
- صمت لقاء الخميسي يشعل الجدل بعد إعلان طلاق زوجها من فنانة شابة
- أسعار النفط تهبط وسط وفرة الإمدادات عقب التصعيد في فنزويلا
- فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
- أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد بمشاركة الفنانة أصالة
- سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام
- تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا تصاعدت الاضطرابات في إيران
- رئيس كولومبيا: ما أقدمت عليه واشنطن لم يقدم عليه هتلر ونتنياهو

تحتل «قلعة القاهرة» موقعاً مناسباً على قمة منحدرات «جبل صبر» المشرفة على مدينة تعز من الجهة الشمالية. وكان لهذا الموقع المتميز أهمية بالغة، إذ مكن القلعة من أداء واجبها التحصيني والدفاعي عن المدينة، وجعل منها الإمام أحمد منذ كان أميراً للواء تعز وولياً للعهد ـ وحتى أصبح إماماً ـ سجناً رهيباً للرهائن!
في بداية كل شهر كان والدي رحمه الله يرسل ـ من مقر عمله في «المنفى» ـ مصاريف شهرية لي ولابن عمي، الأستاذ «أحمد قاسم دماج» (الرهينة)، أتسلمها من حامل البريد الذي يصل في بداية كل شهر إلى «قبة المُعَصوٍر» التي تبعد عن «باب موسى» حوالي 60 متراً. كانت «قبة المعصور» و»طولقتها» العملاقة و»سبل» مائها «المقضضة «القديمة تستقبل المسافرين المغادرين أو القادمين كنقطة تفتيش حدودية لعاصمة الإمام أحمد (تعز). أتسلم المصاريف من الريالات الفضية (ماري تريزا) الثقيلة جداً على جسمي النحيف.
خمسة ريالات مصروف شهري لي، وثلاثون ريالاً لابن عمي الرهينة في «قلعة القاهرة».
كانت بداية معرفتي ومشاهدتي لهذه القلعة عندما صعدت إليها من المدينة في طريق مدرج مرصوف بالحجارة إلى مزار «الشبزي» الذي يزوره اليمنيون، رجالاً ونساء وأطفالاً. والمزار عبارة عن كهف صغير بابه «مقضض» بـ»النورة»، وحوله كراسي من الحجارة المنحوتة ليجلس عليها الزائرون. في تلك المرحلة من الطفولة والصبا لم أكن أعرف شيئاً عن هذا «الشبزي»، ولم يتسنَّ لي معرفة كونه أديباً وشاعراً وشخصية يهودية مشهورة، إلا أخيراً!
ينتهي الطريق المدرج المرصوف بالحجارة عند هذا المزار، وبعد ذلك كان عليَّ الصعود في طريق وعرة شقتها عبر الزمن أرجل الصاعدين والنازلين. كانت قد فُتحت فجوة من السور مستحدثة للدخول والخروج تدعى «عين الدمة» منها يؤدي الطريق إلى البوابة الرئيسية للقلعة بـ»مرحل» معبد بالحجارة المصقولة يصعد منه الناس والإمدادات وعربات المدافع التي تجرها البغال. كان «المرحل» ملتوياً ويستدعي المرء للاستراحة في كل منعطف فيه.
أذكر أنني وصلت إلى البوابة المنيعة المرصع خشبها بصفائح من الحديد والنحاس التي يعجز العدو عن إشعال النار فيه. كان باباً كبيراً يسمح بدخول القوافل التي تحمل المؤن أو التي تجر المدافع وعربات الذخيرة. أما الناس، من رجال ونساء، الذين كانوا يزورون أبناءهم (الرهائن) لتقديم بعض العون لهم أو لإعطائهم بعض الكعك أو الزاد ومدهم ببعض الحاجات الضرورية، فإنهم يتمكنون من الدخول من باب صغير مقوس من أعلاه يفتح في إحدى دفتي الباب الكبير، وفي وسطه نافذة صغيرة جداً تفتح للتأكد من هوية الطارق وممن يريد زيارته.
فتحت هذه النافذة الصغيرة المحصنة بأسياخ من الحديد غليظة بالرغم من أنها لا تسمح بدخول رأس كلب أو قط فما بالك برأس إنسان!
ـ من تريد؟
ـ أريد أن أقابل بن عمي، الرهينة.
وأطبق النافذة الصغيرة في وجهي بعد أن بصق»الشمة» (التبغ المطحون) من فمه فاتسخ ثوبي فوق ما هو متسخ.
بعد فترة انتظار طويلة فتح الباب الصغير المقوس من أعلاه محدثاً صوتاً مزعجاً.
كنت أول الداخلين، وخلفي مجموعة من الرجال الزائرين لأبنائهم يكادون يدفعونني إلى الأرض. لكن الحارس الجلف استطاع برجله الغليظة أن ينظم دخولنا بانضباط دقيق، وبدا الباب وكأنه دُبُر جمل يقص بعره بدقة!
فتشني بدقة وبسرعة، وأخذ من مصروف ابن عمي ريالين، وعندما حاولت التلكؤ والاحتجاج لكزني الذي كان ورائي وهمس في أذني بألاَّ أعترض، وأن أمشي سريعاً.
وجدت نفسي بعد خمسة أمتار أمام باب آخر، وتلاحق بعدي الآخرون، وفتحت نافذة صغيرة كسابقتها. وبعد فترة طويلة فتح الباب الصغير المقوس من أعلاه وتلقفنا حارس آخر غليظ الجسم والطباع أيضاً وأخذ مني ريالين، ولم أعترض، وهرول من ورائي الآخرون فرحين، لكننا صُدمنا ببوابة ثالثة. فتحت النافذة الصغيرة، ثم انتظرنا فترة طويلة إلى أن فتح الباب الصغير المقوس من أعلاه وتلقفنا حارس غليظ ثالث وأخذ مني ريالين ولم أعترض.
وأسرعت ومن ورائي الآخرون. كنت متألماً وخائفاً أن يظن بن عمي، الرهينة، أنني أخذتها لي، لكنني حمدت الله على أنني دخلت من البوابة الرهيبة لكي أرى بن عمي الرهينة فرحاً معانقاً لي!
كان الرهائن واقفين على بعد، كلاَّ يتطلع ليرى أقاربه. وكان قد لفت نظري رجل مهيب بثياب بيضاء نظيفة يقف في وسطهم.
أمرنا حرس القلعة بأن نتوقف في صفوف حتى يخرج الشيخ «المحجاني» قائد القلعة ليأذن لنا بالالتقاء بالرهائن. كنت أصغر الزوار. وعندما خرج الشيخ «المحجاني» مر علينا وسأل كل شخص عمن يريد زيارته من الرهائن وما هي الصلة أو القرابة التي تجمعه بالرهينة.
عندما رآني توقف ونظر إليَّ ملياً وهو يتلفت إلى الحراس، ثم صاح مستفسراً:
ـ أهذا الصبي زائر أم رهينة؟
وتلقى الرد بأنه زائر لابن عمه الرهينة «دماج». أصبت برعب وهلع وارتجفت وجلا كعصفور أو كأرنب خائف.
عندما سمح لنا الشيخ «المحجاني» بالالتقاء بالرهائن انزعجت لصوت جلجلة القيود الحديدية على أرجلهم. لم أعد أتذكر أي ملمح لصورة ابن عمي، ولا هو؛ لكن صلة الدم كانت رائحتها تقودني وتقوده لنعرف بعضنا بعضاً.
هرولت إليه، وحاول أن يهرول إليَّ رغم قيده الغـــلـــيظ. وعندما اقـــتربنا بعضنا من بعض تعانقنا، وتمسكت به وأنا أتشنج باكياً حتى علا صوتي.
حاول أن يبعدني عن الالتصاق به رويداً،
وبدأ يهمس في أذني بكلمات مطمئنة ومشجعة، وبأن الأمور عادية، وأخذ بيدي مع زملائه لكي يريني معالم القلعة، جاهداً أن يخلق جواً مرحاً باسماً يزيل عني الكآبة والبكاء.
أقبل نحونا ذلك الرجل المهاب بثيابه البيضاء النظيفة وبِعِمَّته البيضاء فوق رأسه كلباس علماء «الأزهر»، وربت على كتفينا بحنان وقال لابن عمي متسائلاً:
ـ أهذا ابن عمك ابن «أول الثائرين»، ابن «نقيب الأدباء وأديب النقباء»؟! بارك الله فيكم!
تركنا، وسألت ابن عمي عنه فقال:
ـ إنه السجين الوحيد بين الرهائن، وهو أستاذ فاضل، قاسم غالب، يخصص كل وقته لتعليمنا اللغة والتاريخ والجغرافيا والمنطق والأخلاق والحساب. إنه أكثر علماً من معلمي «المدرسة الأحمدية».
قال لي ذلك بافتخار، ثم عرفني بزملائه.
وظل يطوف بي كل معالم القلعة ومدافعها، وسورها المحيط بها من كـل جانب، وأشرفت معه من كل شاهق لنشاهد المدينة بل اليمن كله الذي كنت أعتقده! وأشار إلى «جبل التعكر» حيث ترقد قريتنا الخامدة في حضنه. عجبت لمناعة هذه القلعة وكيف استطاع العمارون و»الأساطية» أن يبنوا سورها على تلك الشواهق دون أن يصابوا بالدوار والخوف أو السقوط إلى الهاوية.
من «الانبهار والدهشة» ـ كتاب تعز، 2000
سارد اليمن
في تقديمه لأعمال الروائي والقاص اليمني (1943ـ2000)، كتب مواطنه، وضمير اليمن المعاصر،عبد العزيز المقالح: «لم يكن زيد يكتب ليصبح مشهوراً، وإنما كان يكتب لأن الكتابة دعوة إلى الفعل وأداة لإيصال رسالته إلى الناس الذين يحبهم، ويسعى إلى تغيير أوضاعهم إلى الأفضل. كل قصة كتبها زيد كانت تشكل موقفاً، وكل مقال نشره كان تعبيراً عن رؤية وطنية أو إنسانية، وكل رسم كاريكاتوري ما هو إلاَّ دعوة مباشرة إلى التحرر من عيوبنا الأخلاقية والفكرية التي أضافت إلى الواقع المشوه تشوهات لا تقل سوءاً وبشاعة، ولعل تلك العيوب، عيوب القادرين على التجاوز هي التي تشوه الواقع وتصنع فيه من دوائر اللامسؤولية أكثر مما صنعه التخلف ومرادفاته. وكان زيد يرى الكتابة الصادقة تجربة للحوار بين المبدعين، وعن طريقهم ومن خلال سلوكهم ستنتقل إلى الآخرين، إلى هذه الجموع الغفيرة التي لا تقرأ أو تلك التي إن قرأت لا تدرك ما بين السطور، ولا حتى ما في السطور نفسها».
والحال أنّ دماج ليس الروائي اليمني الأبرز، والأمهر في الواقع، فحسب؛ بل هو، كذلك، الأشهر عالمياً أيضاً، ولا مبالغة في القول إن ترجمة روايته «الرهينة» إلى عشر لغات عالمية حتى الساعة، بما في ذلك ترجمتين مختلفتين إلى الفرنسية؛ هي قصة نجاح كبرى للأدب اليمني على الصعيد العالمي.
صدرت «الرهينة» سنة 1984، ثمّ توالت طبعاتها حتى تردد أنها باعت أكثر من 100 ألف نسخة، فأثارت فضول المترجمين في الغرب، فنُقلت إلى الفرنسية والإنكليزية والألمانية والروسية، وكذلك الهندية، واستُقبلت بترحيب حارّ من النقاد حيثما نُشرت. ولعلّ الدرس البليغ الأوّل، وراء قصة النجاح البهيجة هذه، أنّ ما يُسمّى بـ»العالمية» لا يعتمد، أوّلاً، على شبكات الترويج والتسويق، بل ينبثق من أصالة الخصائص المحلية في العمل ذاته؛ بدليل أنّ «الرهينة» كانت رواية دماج الأولى، والوحيدة، لروائي شابّ لم يكن البتة مشهوراً في بلده.
ولد دماج في عزلة النقيلين، لواء إب، وسرعان ما غادرها إلى عدن مع والده، المناضل ضدّ حكم الإمام يحيى، والذي أفلح في الفرار من السجن في تعز. وشاءت أقدار الفتى أن يرسله والده إلى مصر، فحصل على الشهادة الإعدادية من بني سويف، والثانوية من طنطا، ثمّ الحقوق والصحافة من جامعة القاهرة، قبل أن يعود إلى اليمن سنة 1968. انتُخب في مجلس الشورى، أول برلمان يمني، لسنة 1970؛ ومحافظاً في المحويت، وسفيراً لليمن في الكويت.
أصدر دماج أربع مجموعات قصصية: «طاهش الحوبان»، «العقرب»، «الجسر»، «أحزان البنت مياسة»، و»المدفع الأصفر»، فضلاً عن مخطوط رواية؛ وأما مقالاته في الأدب والسياسة فقد جُمعت تحت عنوان «الانبهار والدهشة».
منقولة من القدس ...
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر