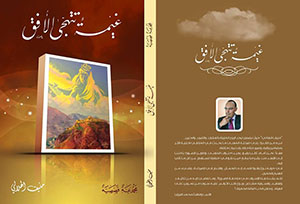اتصلتُ بخالد: قبل دقيقتين كان في يدي، مشيتُ إلى السيارة، مسافة مائة متر، ركبتُ، تحسستُ الجيب، لم أجده. ضاع تلفوني.
التلفون ضاع.
بدأتْ كلُ التهاويل تدب في رأسي: الأرقام، الصور، المعلومات، الرسائل النصية، الفويسميل، وموعد الثلاثاء مع ذلك القادم من هناك يحدثني أحاديث الكواليس! كيف يمكن أن أبقى على تواصل مع العالم الخارجي، البيت، العمل، الأصدقاء، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي؟ تصوروا أن تمر ساعة بدون أن نضغط على «أيقونة الواتس» لنقرأ بعض النكد، أو على «تطبيق الفيس» لندخل في معارك لا تنتهي!
«التلفون ضاع». أخبر كلَّ من لقيت. أما كريم فنظر ضاحكا إلى السماء، وقال: الحمد لله، ما زالت مكانها، لم تقع على الأرض. أتعس ما يمكن أن يحدث لك هو أن يضحك صديقك في اللحظة التي ضاع فيها تلفونك. اتصل للعمل، أخبر السكرتيرة: تلفوني ضاع، لن أتمكن من الحضور اليوم إلى الصحيفة، لا بد من متابعة شركة الاتصالات، ومتابعة البنك، لأن التلفون ضاع وفي غلافه بطاقة البنك. وهذه صدمة أخرى.
تتوارد الخواطر السيئة «ممسكاً بعضها برقاب بعض»: يمكن لمن وقعت في يده البطاقة أن يستعملها. مرة سُرقت بطاقة البنك، وخلال ساعتين كان اللص، أو اللصة بالأحرى قد دفعت بها بعض الفواتير، ومرت على بعض المحلات واشترت ما تريد على حسابي. الآن لابد أن شخصاً ما في محل تجاري يُمرر بطاقتي على آلة الدفع، بعد أن عبأ أكياسه من راتبي الشهري.
«الأمر مهم» أقول للسكرتيرة عبر الهاتف، عليَّ أن أتواصل مع البنك حالاً، وأطبق سماعة تلفون صديقي الذي دعا الله مخلصاً بأن أجد تلفوني عاجلاً غير آجل، ليس لسواد عينيّ، ولكن ليتخلص من سيطرتي على تلفونه. بعض الأصدقاء لديهم تلفونان. أنا لا أطيق أن أحمل أكثر من تلفون، يقول القرآن «وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه»، فلا يجوز، إذن، أن يحمل رجل «تلفونين في جيبه». المهم. في المساء، دُعيتُ إلى عشاء مع بعض الأصدقاء، ولم تكن لديَّ الرغبة في الذهاب لولا إصرارهم.
ماذا يظنني هؤلاء الذين يدعونني للعشاء، وأنا بلا تلفون؟ كيف يمكن أن أذهب لتناول العشاء، وأنا في مكان، وتلفوني في مكان آخر. أي جنون هذا؟ أي حماقة يمكن أن يرتكبها شخص فقد جواله صباحاً ليذهب مساء إلى دعوة عشاء؟ المهم ارتكبت الحماقة، وذهبت للعشاء، كانوا جلوساً على الطاولة، وكنت أسرح بذهني بعيداً حين قطعت الشارع – صباحاً – في «كامدن تاون» شمال لندن، حيث ضاع التلفون. وفجأة، قال لي صديق: لو علمتَ لأدركتَ أنك الشخص الأسعد بضياع تلفونك. التفتُّ إليه مستغرباً. قال: نعم، بإمكانك أن تكون أسعد الناس بضياع التلفون. ستذهب بعد العشاء لتنام مباشرة، لن تتابع المزيد من الأخبار على المواقع الإخبارية، وعلى وسائل التواصل.
لن تفتح الواتس، ولن تطالع الفيس، ولن تكون مجبراً على الرد على الرسائل الطويلة الكثيرة. استغِل الوقت في التأمل، ستصحو غداً باكراً، إذهب إلى «ريجنتس بارك» تمتع بنسيم الصباح الصيفي قبيل الخريف، املأ عينيك بمنظر الأوراق المتأهبة للسقوط، راقب حَمَامات المنتزة حول البحيرات. كان صاحبي يتكلم بلغة شاعر فيلسوف، وكنت أصغي إليه بدهشة مريض ينظر إلى وصفة طبيب ماهر، يتكلم بثقة مطلقة في قدرة علاجه على إحداث التغيير المطلوب.
انتهينا من العشاء، وبدأتُ أفكر بشكل مختلف، وذهبت إلى البيت، وبالفعل نمت مبكراً، لم أدخل ليلتها في نقاشات الواتس التي غالباً ما تكون عقيمة، لم أتجشم عناء متابعة آخر تطورات الساحة العربية، وماذا قال نصر الله والحوثي، ولم أتابع السيدة أسماء الأسد وهي تشرح بعقلية خارقة الفرق بين المتميز والمتفوق. نمت تلك الليلة بدون أن أتابع تطورات الساحات اليمنية والسورية والليبية والعراقية والفلسطينية، ولم أتعب دماغي بمتابعة آخر تهديدات قادة الحرس الثوري الإيراني، ولم أستمع للمرجع الإيراني الأعلى علي خامنئي، وهو يقول إن السعوديين لا دين لهم. ارتحتُ تلك الليلة من صورة دونالد ترامب، وهو يسخر من صحة هيلاري كلينتون، التي لا تستطيع أن تتحمل – مثله – الجو الحار.
نمت تماماً تلك الليلة، وعندما أفقتُ مددتُ يدي إلى حيث أضع التلفون على جانب السرير كالعادة، وارتدَّتْ يدي حسيرة، تذكرني أن التلفون ضاع. عاد شيء من الشعور بالعزلة يراودني. مرت وصايا صديقي البارحة سريعاً كادت تُهزم، وأنا أحدث نفسي: أي صباح هذا الذي نفيق فيه منقطعين عن العالم، لا ندري ماذا حدث بعدنا الليلة الماضية.
أذكر أنني مرة كنت مسافراً بالقطار، وكنت أتصفح الواتس، وفجأة شعرت بالنعاس، ونمت. وبعد ساعة صحوت لأفتح الواتس، وكانت الرسائل الخاصة والعامة على الـ»جروبات» تتوالى على الشاشة بشكل سريع لمدة دقائق، قبل أن تكتمل في تموضعها بعد فتح الشاشة. حدثت نفسي أن أمراً عظيماً حدث في العالم خلال هذه الساعة التي نمت فيها. قلت لنفسي: اللهم سلم. وبعد أن تمكنت من فتح الواتس وجدته مشتعلاً بأخبار انقلاب تركيا. المهم، طردتُ صورة بوتين وأوباما وتريزا ماي سريعاً من ذهني، وصممت يومها على أن أنهض وأطبق وصية صديقي، وخرجت للمنتزه القريب. انطلقتُ إلى «ريجنتس بارك»، وطفت بالبحيرات، وملأت صدري بأريج الصباح المنبعث من زهرات المنتزه مع أواخر الصيف المتهيئ للتواري خلف غيوم لندن الخريفية التي بدأت بوادرها تتداعى تداعيَ الطيور المهاجرة استعدادا للرحيل. مَرَّ يوم الجمعة بعيداً عن ضجيج المكالمات والواتس والفيس، مَرَّ بهدوء تام، بدون ذلك التلاسن اليومي الصامت.
وجاءت عطلة نهاية الأسبوع، وكانت متعة لا تحد عندما كانت يدي التي تمسك بالجوال للتصفح ممسكة بيد «سيما»، ونحن نمشي في الشارع إلى «آزدا» للتسوق.
كانت سيما تحدثني عن عرائسها الجديدة، وقطع الحلوى التي تريدني أن أشتريها لها، وكانت تتقافز كفراشة صيف، بفرح غمرني بسعادة قصوى، وهي تجمع الـ»كندراج»، و «سكيتولز» و «شوبكينز»، و»باربي»، وتضعها في السلة، بعد أن ضمنت أنني سأشتريها. في الطريق كانت يدي التي اندَسَّتْ فيها يدُ سيما كعصفورة محبورة، كانت يدي قد نسيت الجوال، وبدأت تدرك أي حماقة يرتكبها من يضع تلفونه في يده بدلاً من أن يمسك بيد صغيرته، في طريقهما إلى السوق.
مرت عطلة نهاية الأسبوع خفيفة، حلوة، منعشة، تسوقنا معاً، لعبنا معاً، جلسنا معاً، قرأنا معاً. سارة كانت تؤدي واجب الرياضيات، وتعود لي بين الحين والآخر لمراجعة بعض المسائل، وأنا أحاول أن أعصر ذهني، واستدعي سنوات دراستي الأولى، بمتعة غامرة لم أجدها في تلفوني الذي ضاع.
على العموم: لا تأتي السعادة الكبيرة إلا من ممارسة الأعمال الصغيرة، كل الذين يتوقون لتحقيق سعادتهم باجتراح الأعمال العظيمة ينتهون بلا سعادة، ولا أعمال عظيمة. ضع يدك في يد طفلك، ولا تقلق إذا ضاع تلفونك. عندما يضيع تلفونك، فلا تحزن لفقدان فرصة أن تتواصل معك جلالة الملكة اليزابيث الثانية، ولكن افرح لأنك وجدت فرصة أن تضع يدك في يد سيما وتذهب معها إلى السوق.