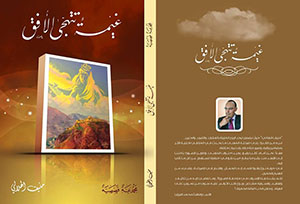ــــــــــ
ملحوظة:
هناك من سيجد في هذه القصة مادة تستحق القراءة. بشكل خاص: أقدم هذه السردية القصيرة للمثقفين الشباب من طلبة الكليات العلمية
ــــــــــ
كنتُ في السنة الابتدائية السادسة، وفي يوم ما من ذلك العام كنت أجلس في السوق القريب من المدرسة. إلى القرب مني وقف كهلٌ طيب الملامح، كان يتحدث إلى شبان وكهول ويتحداهم على طريقته. سمعته يقول “قصتي أعظم قصة” ويرفع يده متحدياً: من يكمل؟ اقتربت من الرجال وقلتُ بوجل: صارت الضبية لصة. التفت الكهل إلي وهو يلوح بيده: هاه، أكمل. قلتُ: سرقت كأسي مدامي وامتصاصي منه مصة. اقترب الرجل مني، ووضع يده على رأسي وهو يقول: إيش اسمك يا بني؟ قلتُ: مروان، مروان الغفوري. أدنى رأسه مني وهو يقول: أنا جدك، جدك محمد سعيد. نصحني، قبل أن أترك المكان، بالانتباه. قال: انتبه على دروسك، انتبه يا ابني.
عندما انتهيتُ من مرحلة البكالوريوس، جامعة عين شمس، عُدت إلى اليمن، التقيت الجد محمد سعيد في صنعاء وحدثني عن الطاحونة التي كان يملكها الحاج الغفوري في وادي الضباب “كان جدك ذكياً، كان يملك طاحونة، وعن طريقها يحصل على أموال أهل الوادي، وفي أيام القحط يشتري أراضيهم، لذلك يملك جدك الكثير من الأرض والقليل من الأصدقاء”. عدتُ إلى مصر للبدء في برنامج الماجستير في جامعة القاهرة، وتوفي الجد محمد سعيد قبل سفري بأسبوع. دهسته سيارة في نهار صنعاء.
وصلت إلى منتصف السنة الإعدادية الثالثة، وكنتُ مدمناً للقراءة. زار قريتنا ضابط عسكري بصحبة زوجته وأولاده. في نهار القرية، على الجبل، زرتُه بصبحة آخرين. في منتصف الأحاديث التفت إلي، وكان ذا ميول إسلامية، وسألني: هل لك من علاقة بالقراءة؟ أجبته: طبعاً، أحب الشعر. قال: اسمعنا. قلتُ: ولما شربناها ودبّ دبيبها/ إلى موطن الأسرار قلتُ لها قفي. مخافة أن يسطو عليّ شعاعها/ فيظهر ندمائي على سري الخفي. امتعض الرجل وقال: والحديث؟ أجبته: قرأت السير. قال: والحديث؟ أجبته: هل هي شيء آخر غير السير؟ أجاب والشك في كلماته: طبعاً، الحديث شيء مختلف، فهززت رأسي. عندما أعطيتهم ظهري وغادرت سمعت الضابط المحترم يقول: انتبه على دروسك بس، وخليك من الكلام الفارغ.
بعد عام من ذلك المكان تسلقتُ الجبل إلى مدرسة ثانوية حديثة التأسيس في حدنان ـ صبر. كان الوقت شتاءً، والفجر والضباب يغطيان الجبل والنساء والشجر )تتذكرون: مشقّر بالغمامة، للفتيح؟). في الطريق كنتُ أقول لرفيقي، متباهياً بما أحفظه: والوارثات من النساء عشرة/ أسماؤهم معروفة مشتهرة. وإذ بامرأة تخرج من بين أشجار القات وتقول: والوارثات من النساء سبعُ، لم يعط أنثى غيرهنّ الشرعُ. سبع يا ابني سبع، مش عشر، أنت شكلك من اللي يحفظوا المتون وهم واقفين يبولوا. اوبه على دروسك بس. أكملت طريقي خجلاً ومنكسراً، إلى أن نبهني صديقي في الفصل قائلاً: هذيك، هذيك اللي عند الطاقة، أبوها مدير وخطيبها في رومانيا يدرس.
لم يمض يوم، أو عام دون أن أسمع رجلاً أو ثلاثة يقولون: انتبه على دروسك.
وفي سنوات كلية الطب كانت هذه الجملة هي المنشار الذي ملأني صوته بالرعب، وكانت الحصار الذي أطبِق عليّ.
قبل امتحان الثانوية العامة زرت المعلم عبد الخبير، وهو من أفضل رجال الرياضيات في تعز. كان يعلمني الرياضيات في الشوارع، معتقداً انه اكتشف بداخلي سرّاً. في مرة، ونحن في بيته، زاره جميل الجويري، وكان من أفضل معلمي الانجليزية في تعز. في الجلسة التي امتدت لساعات سألني الجويري إن كنتُ أحفظ كتب الدراسة كما أحفظ كتب الثقافة، فابتسمتُ، وقلتُ: ربما. لا أدري لماذا امتحنني حينها قائلاً: ماذا قرأت للسيوطي، فقلتُ: تاريخ الخلفاء. نظر إلى معلم الرياضيات متسائلاً بعينيه، فابتسم الأخير قائلا: في الرياضيات كمان كذه. لكن الرجل لم ينس أن ينصحني بصرامة: انتبه على دروسك، انتبه.
في كل مرة كنتُ أسمع هذه الكلمة كنت أصاب بالهلع، وبوخز في عمودي الفقري، فأخاف من الثقافة ومن دروسي وأخشى الناس. كنتُ أذهب إلى معرض القاهرة للكتاب وأشتري عشرات الكتب، وأعود بالكتب الرخيصة ومتوسطة السعر. ومع الكتب أسمع النصيحة: انتبه على دروسك. بعد صلاة المغرب، في جامع عبير الإسلام في مدينة نصر، نصحني طبيب يمني سيصبح فيما بعد مديراً لمستشفى. قال باحترام مبالغ فيه: لو انتبهت لدروسك كما تفعل مع الثقافة ستصنع شيئاً عظيماً.شغلني السؤال الكبير: هل سأستمر في الطب وأنا نصف المثقف ونصف طبيب. هل يمكن أن أحتفظ بكتب الطب وكتب الثقافة تحت ذات الإبط، أو في الحقيبة الواحدة. هل يمكنني أن أتصدى لمسألة طبيّة معقدة ومسألة ثقافية شائكة بنفس الدرجة من الموسوعية والوعي والانتباه؟ هل أصبح لقيطاً بين الحقلين؟
حافظت على مكاني في الطب، وأحطت نفسي بكتب طبية بلا حصر، ثم اتجهت إلى شراء الكتب الطبية كما أفعل مع الثقافة. عندما أطلع البروف. محمد عبد الغني، أحد أعضاء لجنة المناقشة، على رسالة الماجستير التي قدمتها هاتف طبيباً يمنياً وسأله: تعرف مروان عبد الغفور؟ أجاب الزميل: نعم. قال البروفيسور: هل هو أديب؟ فقال الزميل: نعم، ولكن لماذا تسأل؟ فكان رد عبد الغني: كتب رسالة علمية كأنها رواية. كنتُ في الاسكندرية عندما هاتفني زميلي لينقل لي الخبر، وكان سعيداً. شعرتُ بسعادة غامرة، وقلتُ لنفسي: ها أنا ذا أنتبه على دروسي. تذكرت ذلك النهار في مستشفى الدمرداش، في عين شمس، عندما وقفت أمام لجنة امتحان مادة النساء والتوليد. كانت اللجنة مكونة من عدد ٢ بروفيسور يجلسان متباعدين بضعة أمتار، وأمام كل واحد منهما كرسي يجلس عليه الممتحن. جلست أمام الأول وبدأت أجيب عن الأسئلة الطبية بطريقة يبدو أنها قدمتني كمثقف أكثر من طبيب. ترك الممتحن الآخر كرسيه وجاء إلينا يطلب “كبريت”. كان يدخن في قاعة الامتحان، ذو سحنة ثورية، مسدلاً شعره إلى الكتفين. بعد أن فرغ من إشعال سيجارته قاطعني قائلاً: الراجل ده بيقول كلام حلو أوي، أنت من أنهو بلد؟ أجبته: من اليمن. سألني بجمود: الحرامي بتاعكم اسمه إيه؟ قلتُ بلا تردد: علي عبد الله صالح. قال الرجل: برافو، برافو. هجيب لك ستين من ستين، تخلص من هنا وتمشي على طول، متجيش عندي، أنا امتحنتك خلاص. قال البروفيسور الآخر: يعني إيه؟ عشان قالك إن علي عبد الله صالح حرامي هتديه الدرجة النهائية؟. قال: لأ طبعاً، مش عشان كده. هياخد العلامة كاملة عشان هو عارف المشكلة، ومش متردد، عشان الحس الإكلينيكي ده. أمام لجنة الامتحان قال صديقي محمود سعد، هو الآن عضو هيئة التدريس في طب عين شمس: يعني أخش وأقول علي عبد الله صالح حرامي وأحصل على العلامة كاملة؟ قلت له: لا طبعاً، كل واحد عارف الحرامي بتاعه، وكل حرامي ليه علامة.
أعرف إحساس الشاب المثقف في كلية الطب أو كلية الهندسة. الطريق المتقاطع بين العلم والثقافة، المسافات الضيقة والأوقات الصعبة. بين أن تقضي أسبوعاً تقلب في صفحات “عوليس” أو “تاجر البندقية” أو تدخر وقتك، غير الكافي، للتشريح أو الباثولوجي، أو الديناميكا الحرارية! بكيت عشرات المرات أمام بوابة معرض القاهرة للكتاب. لطالما أحسست بالجهل يتدفق في روحي، بالمتاهة، بالضياع المُر بين الطب والثقافة. وفي مرة، في مدينة روكسي، وقفت أمام عمارة وقرأت: فلان، استشاري أمراض كذا، فخنقتني الدمعة. سألت نفسي إن كان بمقدوري أن أحتمل ضغط الطب والمعرفة حتى النهاية، كتب الطب الثقيلة والمخيفة، وكتب المعرفة. أعترف أني كنتُ مخلصاً للاثنين معاً.
انتبه على دروسك، حاصروني بها. على الفيس بوك كتبت بلا حصر. وعندما وصلت إلى ألمانيا عشت وضعاً إضافياً: الثورة، والسياسة والحرب، وبالتوازي كان علي أن أكون طبيباً، وأن أسافر عشرات المدن الألمانية جرياً وراء التدريب والتأهيل والمؤتمرات العلمية “يعرف الأصدقاء القريبون أني مغرم حد الهوس بالمؤتمر والندوات العلمية”. كان عليّ أن أحافظ على توازني وسط كل هذا البحر الهائج، وأن أقف كل يوم منذ السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء في المستشفى، بين المرضى والطب والبيروقراطية والضغط والجدل. وفي المساء، ما تبقى من المساء، علي أن أنجز شيئاً في الطب، وفي المعرفة وفي الكتابة والسياسة..
أكتب هذا الكلام لفئة واحدة من الناس: للشبان المثقفين في الكليات العلمية، الذين يعتقدون أن عليهم أن يختاروا بين العلم والمعرفة.
هذا النهار حصلت على شهادة الاستشارية في طب القلب من غرب ألمانيا، وفي المساء فتحت كتاب “بيت حافل بالمجانين”، مقابلات مع كتاب كبار من كل العالم أجرتها صحيفة باريس ريفيو.
كان الطب طريقي، الطريق الذي أحببته حتى الفناء. وفي ذلك الطريق كانت الثقافة هي ما يبقيني حيّاً.
بمقدورك، عزيزي الطالب في الكليات العلمية، أن تحتفظ برباطة جأشك وتأخذ الكتابين معاً تحت إبطك، وأن تقرأ بنهم وجنون وعنف، بكل العنف الموجود في روحك اقرأ، وبكل الصلف المكدس في لاوعيك انفعل مع المادة العلمية والثقافية، وقف دائماً في العلانية وتحدّ. وعندما تسمع، للمرة الألف، آخراً يقول لك: انتبه على دروسك، خف. عليك أن تخاف، بالطبع. لا بد من الخوف والهلع، ومع كل ذلك فلتواصل الرحلة، واصل الرحلة حتى المنتهى..