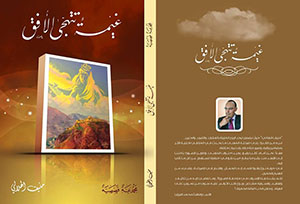الاهداء: الى اخي ورفيقي القائد والمعلم الشهيد جار الله عمر في ذكرى حضوره الدائم والمتجدد ابداً في حياة حزبه، وشعبه، ووطنه، له كل العرفان والمجد والخلود.
في البدء كانت المقاومة، والكلمة المقاومة، لان المقاومة فعل، والكلمة حين تتحول الى قوة مادية قادرة على التغيير، تكون رديف الثورة، وتعز هي مدينة الفعل المقادم، والكلمة المقاومة، وصلتها بالثقافة ليس من فراغ، وهو ما يفسر دورها الفكري والثقافي والسياسي المحوري، ضمن الحالة السياسية الوطنية اليمنية، فاسمها ارتبط بالتاريخ الاصلاحي، والمقاوم، والثوري، منذ التاريخ الاسلامي، والوسيط، والحديث، وخصوصاً منذ مطلع النصف الاول من ثلاثينيات القرن الماضي، في صورة بلورة فكر، وخطاب الاحرار اليمنيين الدستوريين في بشائره الاولى الى جانب صنعاء، واب، وذمار، وقبلها جميعاً مدينة التحرر والمدنية والثورة عدن، واسطة العقد بين اليمنيين في توحيد صلاتهم ببعضهم البعض، على طريق الوحدة، والتوحيد للمعاني الوطنية اليمنية الكلية، وجسر علاقتهم بالعالم الخارجي، وفي كل ذلك ترى تعز السياسة، والثقافة، والمقاومة، والثورة، والتاريخ، "حلقة الوصل" حاضرة وفاعلة في كل ما يحصل، من فعل اصلاحي، ومقاوم، ومن تحرير وانتاج للكلمة المقاومة، والفعل السياسي المغيّر.
لقد حول الانقلاب العسكري والسياسي، والايديولوجي، الحوثي/ صالح،البلاد كلها الى فعل مقاوم، بفعل هيمنة الوهم الايديولوجي بالحق المقدس بالحكم، متزامناً مع جوع تاريخي لاستعادة سلطة غابرة "مغتصبة" كما هو في عقل البعض، الى جانب حلم الطرف الثاني بإمكانية توريث الحكم في ابنه، وعائلته، ولو لم يتبق في اليمن حجراً، على حجر، وترديده القول من ان الحرب ستكون ، من طاقة الى طاقة، وتهديداته المتكررة بصوملة اليمن.
لقد استفز واستنفر نظام علي صالح، في صورة ما تبقى من دولة المركز المقدس، الجميع، واستنهض فيهم روح التغيير والمقاومة، لاستكمال ما بدأ مكتملاً (ومن الماضي)، مع وبعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، وثورة 14 اكتوبر 1963م، لنجد انفسنا نعود مجدداً وثانية لمناقشة اسئلة الثورة، والجمهورية، والامامة، والملكية، والاخطر بحث "مظلومية الامامة" في صورة الحوثيين، واعادة لوك خطاب مذهبي/ طائفي، عن الزيدية، الهادوية، والاثناعشرية، ومحاولة توريث الجمهورية في الابناء، والاحفاد، كرة أخرى، والتي انبثقت وانتعشت مع اوائل النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، في طرح، واعادة انتاج خطاب "ولاية العهد" في العصر الجمهوري، في صورة ابن الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ترشيح نفسه "خلفاً لوالده" وفقاً للدستور، لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي كان يجري الاعداد له في هوجة وزحمة اعادة ترديد النظام خطاب دعوة البعض بالحق الالهي (السلالي) بالإمامة، والملكية، في خضم كل ذلك كان يتحقق في الواقع اعداد وتهيئة ابن الرئيس احمد علي عبدالله صالح، لولاية العهد، ولذلك جرى تأهيله لدخوله الى البرلمان، وتحقيق فوزه الساحق، ثم ابرازه سياسياً، وعسكرياً، وإعلامياً، ودبلوماسياً، مع العالم الخارجي في رحلات مكوكية في هذا الاتجاه، وإلى محاولة تأهيله عسكرياً في دورة كلية عسكرية في الاردن لم ينجح فيها، حتى صناعة وتأسيس جيش موازي خاص به، جيش حديث، كان فعلياً بديلاً للجيش الوطني اليمني التاريخي، الذي جرى تفكيكه، وتفتيته، حتى اضعافه، بعد تسريح معظم قياداته العليا، والوسطى، وحتى الدنيا، تحول معها ما يسمى الحرس الجمهوري، (جيش النخبة) – الذي يقتل الناس اليوم في جميع مناطق المقاومة – إلى جيش بديل لما تبقى من الجيش الوطني، الذي استبدلت رموزه العسكرية التاريخية بقيادات مرتبط ومرتهن ولائها بشخص علي عبدالله صالح مباشرة، منحو من الامتيازات المالية ما يفوق التصور، وبقي بعض من الجيش القديم في صورة ما تبقى من الجيش الذي استهلك في حروب داخلية عديدة آخرها حرب صعده بين اللواء علي محسن الاحمر "الفرقة"، وما تبقى من الوحدات والالوية، توزعت بين بقية الابناء، والإخوة، لدرجة ان مذيع الجزيرة حين سأل علي عبدالله صالح، من أنه "يقال ان أولادك، واخوتك (اسرتك) هم من يسيطرون على قيادات الجيش، فأجاب ببساطة، بما معناه "نعم، خوفاً من أن يأتي مجنون ويقوم بانقلاب على النظام".
لقد كان علي عبدالله صالح يتصرف مع الجيش، والنظام، والدولة، ومؤسساتها، ومع المال العام، باعتبارها مشروع خاص/ عائلي، ولم يتوقع يوماً مسألة الثورة على حكمه، ومن هنا كانت فكرة، وقضية التأسيس للتوريث، وولاية العهد، في محاولة لاعادة انتاج الملكية، والامامة، في لباس جمهوري، وهو ما استفز جميع اليمنيين، بمن فيهم "الاماميين" عموماً، والحوثيين خصوصاً، الذين انتعش لديهم حلم الامامة، مع قيام دولة الوحدة، والتعددية، والديمقراطية، الذين رأوا، مادام والقضية توريث، وولاية عهد، فمن باب اولى نحن الاحق بذلك، ومن أنهم اصحاب شرعية تاريخية في حكم اليمن، بعد ان "اغتصب" الحكم منهم عنوة في ثورة 26 سبتمبر 1962م، ومن هنا بداية كبر حلمهم في استرداد حكم الاباء، والاجداد، لتأهيل انفسهم شرعياً (ايديولوجياً)، وسياسياً، وعسكرياً موظفين فساد واستبداد نظام علي صالح لصالحهم، ومستخدمين خطاب المظلومية التاريخية لصعده، باسمهم كإمامه، وكأن صعده "إمامية" ديموغرافياً، ومن هنا كانت بداية توثيق صلاتهم بايران، مذهبياً، وسياسياً، وامنياً، وعسكرياً، ولم تأت حرب صعده الاولى الا وهم جاهزون للمواجهة التي خاضوا بروفاتها الاولى مع العام2004م، ولعبت تعارضات النظام الداخلية، صراع الاجنحة (علي محسن، محمد اسماعيل، احمد فرج) لمعارضتهم للتوريث، باعتبارهم كذلك الاحق، كونهم من اركان الحكم الاساسيين منذ التأسيس.
الى ان جاءت وقامت ثورة الشباب والشعب كفعل مقاومة ثورية شعبية عامة في فبراير 2011م، ووجهت ضربه قاصمة، لفكرة وقضية عملية "التوريث"، ولفكرة نقض الجمهورية "بالإمامة" أو بالجمهورية الاسلامية، مثال النموذج "ايران"، الثورة التي ادت بفعل زخمها الثوري المقاوم الواسع الى احداث انقسام عميق في البنية الداخلية لنظام المركز المقدس، بعد انقسام خطير في الجيش، وفي العديد من مؤسسات الامن، وهو الانقسام الذي طال حزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام)، قيادة وقواعد، ووصلت الى انشقاقات بين اعضاء البرلمان المحسوبين على حزب علي صالح، ووصل الى استقالات من الحكومة، وكانت تعز، وصنعاء وعدن نقاط انطلاق الثورة التي تخطت وعمّت ثمانية عشرة ساحة تغيير، وحرية، وطغى زخمها الثوري الى جميع اركان النظام (المجتمع والدولة) كفعل ثوري مقاوم مطالب بالإصلاح، وحتى تغيير النظام.
وفي تقديري الشخصي ان المكونات السياسية، وجناح اساسي في اطراف الحكم المطلوب إزاحته، أو تقليص حجم شراكته في الحكم، قد أدركا، واستشعرا - كل من موقعه، وموقفه، وحساباته – خطورة، خطوات سير النظام باتجاه التوريث للجمهورية، في شكل قريب مما يمكننا تسميته - كما سبقت الاشارة - "ولاية العهد" لابن الرئيس، في صورة التحولات السياسية، والعسكرية، والاعلامية، التدريجية، لتحويل قبضة الحكم "النظام" من جمهوري، الى وراثي/ عائلي، في غطاء، جمهوري/ انتخابي، خاصة بعد تخلص النظام من حلفائه الاساسيين في حرب 1994م، التي لم يكن هدفها الوحدة، لأن الوحدة كانت قائمة، وانما إقصاء شراكة الجنوب في السلطة، والثروة، أولاً، ثم إقصاء ومحاولة استئصال الاشتراكي (الحزب) باعتباره الحامل السياسي والاجتماعي، لمشروع الوحدة، والدولة الوطنية الحديثة، بعد وصمه بالخيانة، والانفصال، ومن هنا كانت قضية التوريث بمثابة عزف منفرد على عود احتكار السلطة في صالح، وعائلته، والجماعة المقربة جداً منه، وهو ما وسع قاعدة المعارضة الداخلية له وضده في قلب اجنحة الحكم، وفي قلب المجتمع، وفي الفضاء السياسي، والوطني العام، ضاقت معه القاعدة الاجتماعية، والسياسية، والوطنية للحكم، وللحاكم، حتى غدى أقرب حلفائه وانصاره التاريخيين في المقلب الآخر.
#الاعمال السياسية المشتركة#
لقد تميز، واصطبغ تاريخ السياسة، والاجتماع، في علاقتها بالسلطة، والحكم في كل المنطقة العربية، والاسلامية بالحروب، والدم، والقتل، والاغتيال، وكان الاقصاء، والالغاء، والاستئصال، للآخر والمختلف والمغاير، هو العنوان البارز في سيرة تاريخ السياسة، والسلطة، والاجتماع، في جميع اقطار بلادنا، قديماً، وحديثاً، - طال الصراع من اجل السلطة، الاب، والابن، والاخ واخيه بصورة وحشية - ذلك ان لا شرعية للحق في الاختلاف، فالاختلاف، والمغايرة، والتعدد، والتنوع، والتباين، وحتى الخصوصية، قضايا ومسائل مستنكرة، ومحظورة، لأنها قضايا ومسائل، ضدية للوحدة، والاتفاق، فالاختلاف فتنة لعن الله من ايقظها، ويبدو ان لذلك جذر وأصل عميق غائر يعود لفكرة "التوحيد" والواحدية، والوحدانية، ومن هنا ليس فحسب تواري وتراجع وضعف حضور خطاب التعددية في تاريخنا السياسي، وفي فكرنا وفي احزابنا، وضمور الوعي لدينا ليس فقط بالحق بالاختلاف، بل وبالحق في الخطأ. وهي أمور وقضايا تقع وتقف ضداً على الطبيعة البشرية والانسانية، ولذلك يرى ويعتبر العديد منا أن الاختلاف يناقض مفهوم الوحدة، وأن التعددية جريمة، وخيانة، بل وقد ذهب وما يزال يذهب البعض للقول من ان الاختلاف مع شعار الوحدة أمر يناقض الشريعة، والدين، ومن هنا رؤية ربط رجال الدين والفقهاء للوحدة، بالشريعة وبالدين، ومن أن الوحدة قضية شرعية دينية، ولذلك جذر له أصول عميقة، بتاريخ الخلط، والجمع بيم الديني/ والسياسي، وبين السلطة، والدين، وعدم الفصل بين الدين، والسياسة، والسلطة (الملك، والامامة، والخلافة).
ومن هنا توحد طرفي "السنة والجماعة" بمختلف تسمياتهم، وعناوينهم، وطرف الشيعة (الزيدية، والزيدية الهادوية، والاثنا عشرية، والامامية) على تأصيل خطاب الوحدة، ورفض الاختلاف، والتعدد، لأن الاصل العميق الموحد بينهم، والجامع لهم، هو دمجهم وخلطهم بين الايديولوجي، والديني، وبين السياسي، والديني المقدس، وبالنتيجة توحيدهما بين الدين، والدولة، حيث الدين مقدس ومطلق، والدولة شأن حياتي، سياسي، خلافي،وهي الخطوه العملية لتوحيد الحاكم وحكمه، بالمذهب، وبالدين المقدس، فلدي السنه والجماعة، ان طاعة ولي الأمر واجبة، وهي من طاعة الله، ومخالفة الحاكم معصية، وفتنة، وعند البعض خروج من الملّه/ الدين، "سلطان غشوم خير من فتنه تدوم" أو قولهم "من اشتدت سلطته وجبت طاعته" حتى قول بعضهم ان الاستبداد والظلم أفضل من الفتنة، والفوضى، وفي المقابل كرست وواصلت الشيعة الاثنا عشرية والامامية والزيدية الهادوية للحاكم/ الامام، بأن جعلت من مبدأ الإمامة أصل من اصول الدين، وركن من أركانه، وليست من المصالح العامة، التي يمكن تفويض أمر النظر فيها الى الامة/ الشعب، بل وحصرت ذلك في "البطنين" من أولاد على من فاطمة الزهراء، وعند هذه اللحظة من التنظير والتفكير في السياسة، والسلطة، والحاكم، وفي الموقف من الحق في الاختلاف، والتعدد، والتنوع، في السياسة، وفي الاجتماع، ناهيك عن السلطة، ومن هنا لا فرق جوهري في "الاصول"، والتمايز فقط فيما بينهما في بعض "الفروع" الفقهية التشريعية الخاصة بكل منها في النظر لبعض التفاصيل، التي تؤكد الاصل.
ومن هنا كذلك لا اختلاف معرفي، او فكري، وسياسي، بين مفهومي "الخلافة والامامة" في الموقف من الآخر، والمختلف، سوى ما سبق الاشارة اليه، فالآخر لديهما معاً هو الجحيم كما يقول جان بول سارتر. ومن هنا لا أفهم افتعال المعارك المذهبية/ الدينية، ورفعها الى مستوى الحروب الطائفية، إلا بانها غطاء لصراع سياسي على توسيع مناطق النفوذ، وعلى السلطة، صراع توسع افقه ومداه ليصبح صراع اقليمي، تحمل رايته دول محورية لتمرير مشاريعها القومية الاستراتيجية. كان لا بد من عرض هذه الجملة الاعتراضية للقول ان طرفي السنة والشيعة، يتفقان في الاصول، وقد يختلفان في بعض تفاصيل الفروع المذهبية، أما موقفهم من الحرية ومن التعددية، والمغاير، والمختلف، والقبول بالآخر، والاعتراف به، فانهما معاً ينطلقان من أرضية أيديولوجية/ سياسية واحدة مشتركة، (الكل في واحد)، الخليفة، والامام، هما سدرة منتهى القول والفعل، وهذا ما كان، وما يريدان استمراره، ولا معنىللشعب، والحرية، والديمقراطية، ومن هنا قهر حق التعدد والاختلاف.
ومن هنا كذلك تقديس البعض للوحدة - من مختلف التيارات والمدارس والاتجاهات - والذي يأتي من خلفية وجذر التفكير المشار اليه، وبالمقابل تدنيسهم وتجريمهم للاختلاف أو الانفصال، مع انهما (الوحدة، والانفصال)، خياران سياسيان، لا صله لهما سوى بالمصالح الواقعية للناس، لان الوحدة ليست مقدسة، بحد ذاتها، كما انها ليست دينا، وكذلك الانفصال ليس كفراً ولا يناقض الشريعة، والدين، ولكنه تاريخ السياسة، والملك (الخلافة والامامة) وتاريخ الاستبداد الواحدي والاحادي (الشمولي) الذي جمع الكل في واحد هو من جعل من المختلف، والمغاير، ومن التعددية كل تلك النقائص والمثالب، والرذائل.
مع ان الوحدة، والتعددية، الوحدة والانشقاق ، والانفصال، والاختلاف، والاتفاق، امور سياسية، وقضايا كائنة وأصيلة في الفطرة البشرية الانسانية (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" والنص الديني المقدس، والسياسي، والاجتماعي، والتاريخي، جميعها تؤكد على حقيقة وواقعية شرعية الاختلاف بل والحق في الخطأ، وهنا يمكنني القول انني حين اتملى في المشهد السياسي، والثقافي، وأتمعن أكثر في تفاصيل اليومي (تفكيراً، وسياسة، وممارسة)، وخصوصا في تفاصيل علاقة السياسة، بالسلطة، وبالمجتمع، وبالمدرسة، والتعليم، في حياتنا العامة، وبالخصوص في تجليات كل ذلك، في تفكير بعض السياسين الانتهازيين (الحالمين بالسلطة)، سواء سلطة الحكم، او سلطة الحزب، فانه ينتابني القلق، والخوف، والخشية على كل شيء، في الوطن، وفي الحياة عامة، فمثل هذه النماذج من البشر لا يتورعون في سبيل مصالحهم الصغيرة، وصعودهم للأعلى، - وهم في كل الاحزاب، والتيارات، والاتجاهات - لا يتورعون، تحت اغطية واردية السلام، او الفضيلة، أو الدفاع عن الحق، والوطن، والدفاع عن الحزب، من رفع بعض الاختلافات، والتباينات الصراعية، (السياسية والحزبية) الى حد القطيعة، والخصومة، والقطع مع كل التراكم الذي كان، أقصد التراكم السياسي، والفكري والتحالفي، في صورة الاعمال السياسية الكفاحية المشتركة "اللقاء المشترك". وتدمير جسور التواصل، والاتصال بين الناس، افرادا، واحزاباً، ومجتمعات، نماذج يغدو معها الاختلافات، والتعارضات السياسية، مدخلا ومقدمة لاشعال حرائق لا تتوقف، حرائق تبدأ بالعنف اللفظي، والرمزي، ولا تنتهي بالقطع، والقطيعة، والعداوة، والخصومة، مع الاخر، التي قد تصل الى حدود القتل المعنوي، والسياسي، والاخلاقي، في صورة تخوين، وتجريم، وتكفير الآخر المختلف، والذي قد يصل في حد وموقف معين، الى حد الدعوة للقتل المادي، وهذه النماذج موزعة على كل الاحزاب، وكما قال الشاعر العربي الاموي نصر بن يسار، "الحرب اولها كلام".
وفي تقديري ان ما يضاعف من ضمور وعي الاختلاف، وضعف حضور خطاب التعددية، والقبول بالاخر، والاعتراف بالمتعدد والمغاير في حياتنا الفكرية، والسياسية، والاجتماعية، وفي حياة احزابنا الداخلية، وفي علاقة احزابنا مع بعضها البعض، سواء كانت (دينيه، او وطنية، او قومية، او يسارية اشتراكية)، هو ان فكرنا السياسي الديني، والسياسي العام، قد طبع منطق تفكيرنا بالكلية والشمولية، الاحادية، منطق تفكير ارتكز واستند تاريخيا على جملة من الثنائيات القاتلة "ثنائية السلطة والدولة" و ثنائية "السلطة والثروة"، وكذا على ثنائية خطيرة لعبت دورا مركزيا، ومحورياً وكان لها عظيم الأثر في تغييب ومصادره ثقافة الحرية، والاختلاف، والتعددية، والديمقراطية، والقبول بالاخر، وهي ثنائية "السلطة والعدل"، حيث طلب العدل هو جماع تفكيرنا السياسي، والديني، فكانا، العدل، والملك، هما اساس الحكم، وستجد خلف كرسي الحاكم، وعلى صفحة جداره الخلفي لوحة معلق عليها شعار "العدل اساس الملك" او "العدل اساس الحكم" سواء كان ذلك الحاكم، خليفة، أو امام، أو سلطان، أو رئيس جمهورية، أو حتى امين عام حزب تقدمي، وهو ما يعني في واقع الممارسة غياب البعد الثالث من مثلث هو من يصنع، ويهندس معنى المواطنة، والفردية، والقبول بالمتعدد (الآخر)، وهو بعد الحرية، الغائبة عنا جميعا، وهو البعد الثالث من المثلث الذي ما نزال نبحث عنه في المجتمع، والسلطة، وفي قلب الاحزاب، وفي المدرسة، والجامعة، وفي مناهج التعليم، وهو ما يفسر اليوم تعثرنا، وانكسارات تجاربنا السياسية، والوطنية، على صعيد المجتمع، والسلطة، وبناء الدولة، وحتى بناء معمار الاحزاب على اسس وقواعد ديمقراطية، وتنظيمية صحيحة.
ان من يتابع تاريخ نشأة وقيام الدولة الوطنية/ القومية، الاستقلالية العربية، الحديثة، والمعاصرة، منذ مطلع القرن الماضي "كفكرة ورؤية" ومع النصف الثاني في الاربعينات، وحتى الخمسينات، وبداية الستينات، (كتاريخ وجود) سيجد وسيرى أن شرعية الاختلاف، والحق في الاختلاف والتباين، والتعددية، والديمقراطية، والحوار، والقبول بالآخر، هو الغائب الاعظم، عن جميع تجارب قراءاتنا في الفكر، وفي السياسة، وفي تجاربنا في نشأة، وعمل الاحزاب، وفي بناء الدولة، وفي صياغة بنية المجتمع، وحتى اليوم ما يزال سؤال التعددية، والديمقراطية، والحوار، والاعتراف بالآخر، ملحا، وحيويا، وهي احد اهم التحديات التي تواجهنا على كافة الاصعدة، بدءا من مناهج وطرائق التفكير، والتعليم النقدي، الى دور الجامعات، وحتى دور الاحزاب، والى مضمون معنى الانتخابات، وطرائق بناء دولة المؤسسات، وسلطة القانون، ولذلك لم ننجح في جميع تجاربنا السياسية، والتعليمية، والوطنية، في انتاج وصياغة مفهوم متكامل "للعقد الاجتماعي" وبالنتيجة فشلنا الذريع من مصر، الى العراق، وسوريا، والسودان، وليبيا، واليمن الخ في صياغة مفهوم ومعنى واقعي مادي ملموس لمعنى المواطنة، ومفهوم المواطن.
لقد رحلت جميع الانظمة العربية الاستقلالية، والتحررية شعار الحرية، والديمقراطية حتى طرد الاستعمار والحرب على الامبريالية، وعلقت بعضها خيار الحرية، والديمقراطية، على مشجب حل المسألة القومية، أو حل المسألة الاجتماعية، وتحت شعارات قومية المعركة، "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" وهي المعركة التي لم ندخلها (هزيمة يونيو 1967م) وحين دخلنا المعركة في (اكتوبر 1973م) حولنا النصر العسكري المصري والقومي العربي، الى هزيمة سياسية، ونكبة قومية شاملة في صورة اتفاقية "كامب ديفيد"، وبعدها "اوسلو" وكل ما يحصل اليوم، هو احد ثمار تغييب ومصادرة إرادة الناس في الحرية، والديمقراطية، والتعددية، والحوار، والاهم حقهم في الشراكة في السلطة، وفي صناعة القرار.
ان فشل تجاربنا السياسية، والوطنية، والحزبية، والوحدوية، في بناء الدولة، والمجتمع، في اليمن، يعود جزء اساسي منها إلى ما سبقت الاشارة اليه، إلى جانب عوامل سياسية، وتاريخية، عديدة، لها صلة بعلاقة السياسة، بالسلطة، بالمجتمع، بالأيديولوجية الشمولية، وبالتاريخ السلطوي الاستبدادي في بلادنا، ولا نستطيع ان نقرأ ونفهم تاريخ الانشقاقات، والانقسامات الحزبية، والمذهبية، والطائفية، وكذا الحروب الشطرية الداخلية على صعيد كل شطر، والحروب بين الشطرين، سوى بإحالتها "جزئيا" وليس بالمطلق، الى غياب وتغييب الديمقراطية، والحوار، والتعددية، والقبول بالاخر، والى ضعف دور وفعل ومكانة الدولة الوطنية، وسلطة المؤسسات والقانون، وهنا تتجلى وتتمظهر اشكال مختلفة من الانتهازية، والوصولية، ومن صور التسلق على ظهر المثل، والقيم، والمبادئ الاخلاقية، والثورية، والمفاهيم الانسانية الكبرى، كمدخل عند البعض للارتزاق، والترقي السياسي، والصعود الاجتماعي الى مراكز ومواقع المال، والسلطة، والقرار، أو القفز الى ذلك على ظهر صهوة الحزب الذي من المحتمل ان يكون غداً او بعد غداً في سلطة قرار مقبلة، كما هو عند البعض من جميع الاحزاب، والتنظيمات، والتيارات، الذين يشتغلون على بناء امجاد شخصية، ولو عبر افتعال معارك ذاتية لا معنى لها، فالمناخ السياسي الفاسد، والمستبد، والحرب، وحالة الفوضى والانحطاط القائمة، تنتج ذاتياً، وموضوعياً كل تلك الرداءات، الانحطاطات، في السلوك الشخصي والعام، والتي مع الاسف قد تلقى قبولاً، ورواجاً، بفعل مناخ وواقع الانحطاط، والتراجعات في دور، ومكانة القيم، والمبادئ، والمشاريع السياسية، والوطنية، والقومية، والتقدمية الكبرى، وفي مثل هذه المناخات تزدهر وتنتعش وتتعملق القامات الصغيرة وتتوارى الاسماء النبيلة، ودورها في السياسة، وفي الفكر، وفي المجتمع، وفي الاحزاب.
وفي هذا المقام، ومن قلب هذه التحديات التراجيدية، كم اشعر بالحاجة، وبالحنين، الى معانقة اسماء نبيلة، فقدناها، وغادرتنا قبل الاوان، وما نزال نحس وندرك اليوم بمدى خسارتنا لها في فقدانها الصعب، اسماء وقامات كانت رغم المصاعب والتحديات تقول لنا ان الاتي أجمل، وقريب، وتبصّرنا بالطريق، معززة فينا روح مقاومة العفن السائد، والاهم كانت بسلوكها اليومي، ونزاهتها، وعفتها، وطهارة قلبها، وفيما تكتب وتقول، انما كانت تؤسس وتؤكد على ثقافة العيش المشترك، وعلى الحوار، والتسامح، والقبول بالآخر، ومن هذه الاسماء التي شخصياً أشعر بفداحة خسارة الوطن لها، الشهيد جار الله عمر، مهندس وصانع اللقاء المشترك، والشاعر الكبير عبدالله البردوني، والمفكر السياسي عمر الجاوي، والقائد السياسي رجل الدولة صالح بن حسينون، والمفكر محمد علي الشهاري، ورجل الدولة والسياسة صالح منصر السيلي، والربادي، ويوسف الشحاري، وغيرهم...، وجميعهم كانوا قادة، ومؤسسين لثقافة الحوار، والمواطنة والتسامح، وتكريس قيم العيش المشترك، كانوا بأسمائهم قامات مقاومة دفاعاً عن الحرية، قامات اكبر من اي سلطة، فالسلطات وعناوينها غابت، وبقيت اسماؤهم وذكراهم عطره، تذّكرنا بما راكموه واشتغلوا عليه، من مبادئ، وقيم مقاومة اسست وأصّلت لمعنى فكرة وقضية التغيير، والديمقراطية، والمواطنة، وثقافة العيش المشترك، وهندسة الاعمال المشتركة - وليس تدميرها والقطع معها – في صورة الدور السياسي المحوري للشهيد جار الله عمر في صناعة، وهندسة اطار "اللقاء المشترك" في مرحلة من اصعب واعقد المراحل السياسية، والوطنية، والتاريخية، في حياة اليمنيين المعاصرة، مرحلة ليس فحسب اسست على ما كان من تراكم صفري في الخبرة السياسية الحوارية المشتركة، ومن ثقافة عيش مشترك قطعت معها ضدياً حرب 1994م، ولأن كل ذلك (الحوار والعيش المشترك) لم يكن واقعاً، يمكن البناء عليه، لأن كل المعطيات المتوافرة حينه، كانت تقول ان الحرب الخصومة، والعداوة السياسية، وانتاج ثقافة الكراهية، وعدم التسامح السياسي، ستدوم طويلا، ومن هنا قيمة "مجلس التنسيق الاعلى لأحزاب المعارضة" واللقاء المشترك لاحقاً، الذي هندس خطوات لحظاته الصعبة الاولى الرفيق الشهيد جار الله عمر، ومعه كل قيادة الحزب، في لحظة استثنائية صعبه، لا تؤهل سوى لمراكمة ثقافة الفتنة، والخصومة، والعنف والكراهية، وهذه النقلة من واقع عنفي، فتنوى، حربوي الى واقع نقيض سلمي، حواري، هو ما يعطي اللقاء المشترك قيمته السياسية، والوطنية، والتاريخية، الذي من المهم، ومن الضروري استمرار البناء والتأسيس على ما كان، وليس القطع العدمي بتدمير ما كان، من خلال افتعال معارك ذاتية صغيرة، وتضخيم اختلافات سياسية عادية، وطبيعية، ترافق وتصاحب مسيرة اي عمل سياسي يمر بمرحلة انتقالية صعبة، مليئة بتعقيدات تحديات الراهن، وبإرث التاريخ الماضوي الجاثم على صدر اللحظة الراهنة، في ابشع صوره السلبية، ومن هنا دور القامات الكبيرة في التقاط خيط النور، لإضاءة صورة المستقبل، وليس العكس، ومن هنا - مرة ثانية وعاشرة - قيمة الشهيد جار الله عمر ودوره السياسي والوطني التاريخي، وقيمة اللقاء المشترك.